لماذا الاشتراكية؟
هل مستحسن أن يعبّر غير الخبير في الاقتصاد والقضايا الاجتماعية عن آراء بشأن الاشتراكية؟ أعتقد ذلك، لعدد من الأسباب.
دعونا أولاً نفكّر بالسؤال من وجهة نظر المعرفة العلمية. قد يبدو أنّ لا اختلافات منهجية أساسية بين علم الفلك والاقتصاد: يحاول العلماء في كلا المجالين اكتشاف قوانين عامّة لمجموعة محدودة من الظواهر تجعل الترابط بينها مفهوماً بأكبر قدر من الوضوح. لكن الاختلافات المنهجية موجودة في الواقع. من الصعب اكتشاف القوانين العامّة في مجال الاقتصاد لأن الظواهر الاقتصادية الملحوظة تتأثّر غالباً بعوامل عدّة يصعب تقييمها بشكل مُنفصل. بالإضافة إلى ذلك، تأثّرت التجربة المُتراكمة منذ بداية الفترة الحضرية من التاريخ البشري، وقُيِّدت، كما هو معروف، بأسباب ليست حصراً ذات طبيعة اقتصادية. على سبيل المثال، معظم الدول الكبرى في التاريخ تدين بوجودها للغزو. أثبتت الشعوب الغازية وجودها، قانونياً واقتصادياً، كطبقة تتمتّع بامتيازات في البلد المُحتلّ. صادروا الأراضي لصالحهم، واحتكروا ملكيّتها، وعيّنوا كهنوتاً من طبقتهم. مأسس هؤلاء الكهنة، الذين تحكّموا بالتعليم، التقسيم الطبقي للمجتمع وجعلوه مُستداماً، وأنشأوا منظومة قيم لتوجيه الناس من دون وعي بسلوكهم الاجتماعي إلى حدّ كبير.
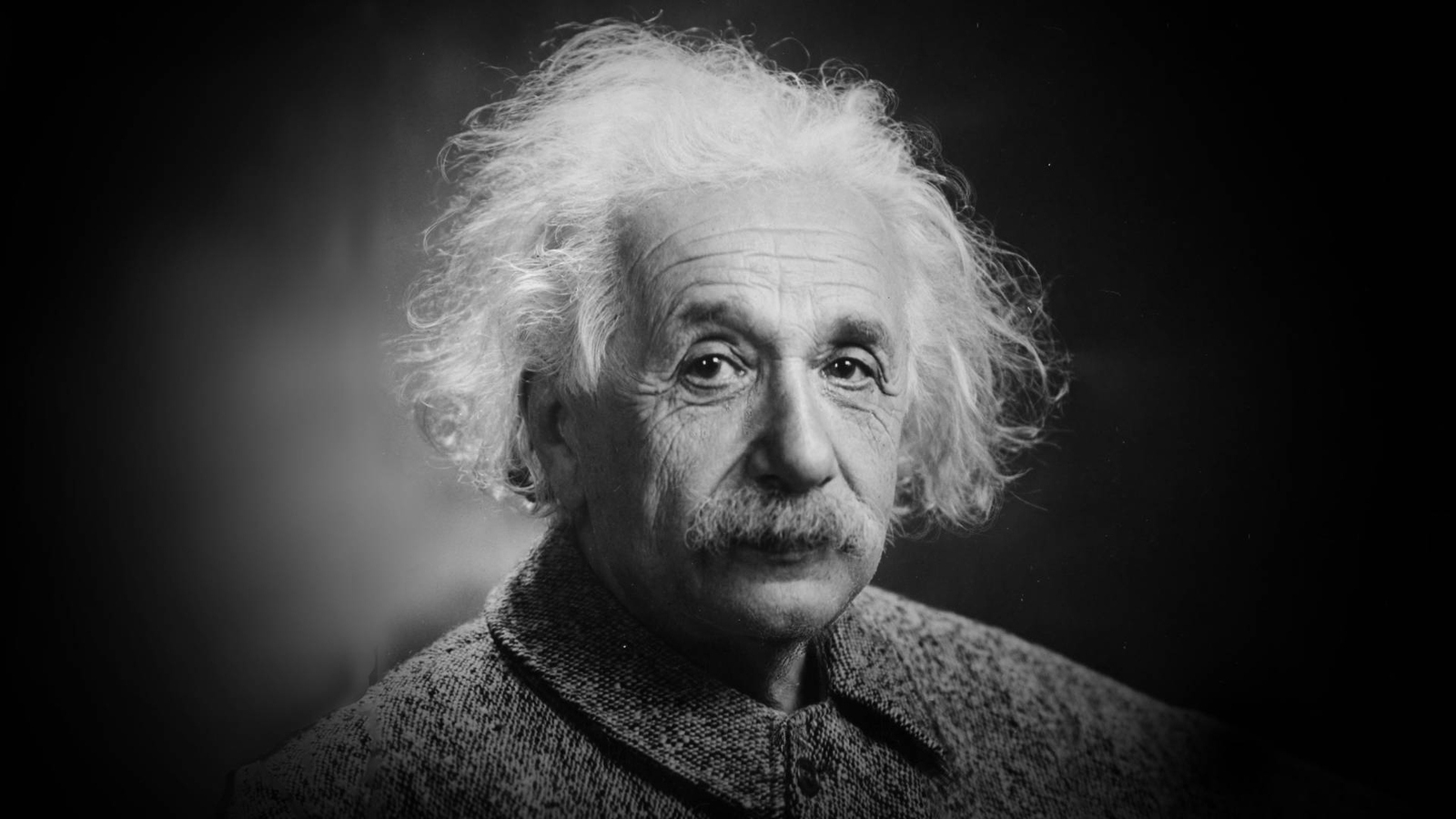
لكن التقاليد التاريخية أصبحت من الماضي إذا جاز التعبير: لم نتغلّب، حتى الآن، على ما أسماه ثورستين فيبلن بـ"المرحلة الافتراسية" من التطوّر البشري. تعود الوقائع الاقتصادية الملحوظة إلى تلك المرحلة، وحتّى القوانين المشتقّة منها لا تنطبق على المراحل الأخرى. وبما أن الهدف الحقيقي للاشتراكية هو التغلّب على المرحلة الافتراسية من التطوّر البشري، والتقدّم أبعد منها، فلا يمكن لعلم الاقتصاد في وضعه الحالي أنّ يلقي الضوء على المجتمع الاشتراكي المستقبلي.
ثانياً، الاشتراكية موجّهة نحو غاية اجتماعية - أخلاقية. مع ذلك، لا يمكن للعلم أن يخلق غايات ولا حتّى أن يغرسها في البشر. أكثر ما يمكنه فعله هو توفير الوسائل التي تسمح بتحقيق غايات معيّنة. لكن هذه الغايات - في حال لم تولد ميّتة - تُبتدع من شخصيّات ذات مُثُل أخلاقية رفعية، ويتبنّاها كثير من الناس ويحملونها بشكل لاواعي جزئياً، فيحدّدون التطوّر البطيء للمجتمع. لهذه الأسباب، يجب أن نكون حريصين على عدم المبالغة في تقدير العلم والأساليب العلمية عندما تتعلّق المسألة بمشكلات بشرية؛ ولا ينبغي افتراض أن الخبراء هم الوحيدون الذين لهم حقّ التعبير في المسائل التي تؤثّر على تنظيم المجتمع.
علت أصوات كثيرة مؤخّراً تؤكّد على أن المجتمع البشري يمرّ بأزمة واستقراره مُهدّد. في حالات مماثلة (حالة الأزمة) يشعر الأفراد بعدم اكتراث أو حتّى عدائية تجاه المجموعة، الصغيرة أو الكبيرة، التي ينتمون إليها. لتوضيح مقصدي، اسمحوا لي بالحديث عن تجربة شخصية. لقد ناقشت مؤخراً مع رجل ذكي وودود خطر وقوع حرب أخرى، والتي في رأيي سوف تهدّد الوجود البشري جديّاً، وأشرت إلى أنّ الحماية من هذا الخطر لن توفرها سوى منظّمة فوق-وطنية. عندها قال لي ببرودة شديدة: "لماذا تعارض بشدّة اختفاء الجنس البشري؟".
أنا متأكّد أنّ قبل قرن من الآن ما كان أحد ليدلي بتصريح مماثل باستخفاف. إنّه تصريح رجل سعى عبثاً لتحقيق توازن داخلي، ثمّ فقد الأمل. إنّه تعبير عن الوحدة المؤلمة والعزلة التي يعاني منها الكثير من الناس في هذه الأيام. ما هو السبب؟ وهل من مخرج؟
من السهل طرح أسئلة مماثلة لكن من الصعب الإجابة عليها بثقة. مع ذلك، عليّ المحاولة قدر المستطاع على الرغم من إدراكي بأنّ مشاعرنا وجهودنا متناقضة وغامضة في الغالب، ويصعب التعبير عنها بمعادلات سهلة وبسيطة.
الإنسان هو في آنٍ معاً كائن وحداني وكائن اجتماعي. بصفته كائناً وحدانياً، يحاول حماية وجوده، ووجود أقرب الأشخاص إليه، لإشباع رغباته الشخصية وتنمية قدراته الفطرية. وبصفته كائناً اجتماعياً، يسعى إلى اكتساب تقدير أقرانه من البشر ومحبّتهم، وإلى مشاركتهم أفراحهم، ومواساتهم في أحزانهم، وتحسين ظروف حياتهم. وجود هذه الجهود المتنوّعة، والمتضاربة في كثير من الأحيان، هو ما يفسّر الطابع الخاص للإنسان، فيما تُحدّد تركيبتها الخاصة بقدرة الفرد على تحقيق التوازن الداخلي والمساهمة في تحقيق صالح المجتمع. قد تكون القوّة النسبية لهذين المحرّكين ثابتة وراثياً في الأساس. لكن الشخصية التي تظهر أخيراً، تتشكّل إلى حدّ كبير من البيئة التي يجد فيها الإنسان نفسه أثناء نموّه، ومن خلال بنية المجتمع الذي ينشأ فيه ومن تقاليده الخاصة، وعبر تثمين المجتمع لأنواع معيّنة من السلوك. بالنسبة للإنسان الفرد، مفهوم "المجتمع" المجرّد هو مجموع علاقاته المباشرة وغير المباشرة مع معاصريه وجميع الناس من الأجيال السابقة. الفرد قادر على التفكير والشعور والكفاح والعمل بمفرده، لكنه يعتمد كثيراً على المجتمع - في وجوده الجسدي والفكري والعاطفي - بحيث يستحيل التفكير فيه أو فهمه خارج إطار المجتمع الذي يمدّه بالطعام والملبس والمسكن وأدوات العمل واللغة والأشكال الفكرية ومعظم المحتوى الفكري. أصبحت حياته ممكنة نتيجة عمل وإنجازات ملايين عديدة، ماضية وحاضرة، من المختبئين وراء كلمة "مجتمع".
من الواضح، إذن، أن اعتماد الفرد على المجتمع هو من حقائق الطبيعة التي لا يمكن إلغاؤها - تماماً كما في حالة النمل والنحل. مع ذلك، في حين أن مسار حياة النمل والنحل محكومة بكاملها، وبأدقّ تفاصيلها، بغرائزَ صلبة موروثة، فإن النمط الاجتماعي والعلاقات المتبادلة بين البشر متغيّرة للغاية وقابلة للتغيير. أوجدت كلٌّ من الذاكرة والقدرة على تكوين تركيبات جديدة وموهبة التواصل الشفوي إمكانيات لحدوث تطوّرات بين البشر من دون أنّ تمليها الضرورات البيولوجية. تتجلّى هذه التطوّرات في التقاليد والمؤسّسات والمنظّمات، وفي الأدب والإنجازات العلمية والهندسية، وكذلك في الأعمال الفنية. وهذا ما يفسّر، بمعنى ما، كيف يمكن للإنسان أن يؤثّر على حياته من خلال سلوكه الخاص، وأنه يمكن للتفكير الواعي والرغبة أن يلعبا دوراً في هذه العملية.
يكتسب الإنسان عند الولادة بنية بيولوجية من خلال الوراثة، يجب أن نعتبرها ثابتة وغير قابلة للتغيير، وهي تضمّ الدوافع الطبيعية التي تميّز الجنس البشري. بالإضافة إلى ذلك، يكتسب خلال حياته بنية ثقافية يتبنّاها من المجتمع عبر التواصل والعديد من أنواع التأثيرات الأخرى. هذه البنية الثقافية هي التي تخضع للتغيير بمرور الوقت، والتي تحدّد إلى حدّ كبير العلاقة بين الفرد والمجتمع. علّمتنا الأنثروبولوجيا الحديثة، من خلال التحقيق المُقارن لما يُسمّى بالثقافات البدائية، أنّ السلوك الاجتماعي للبشر قد يختلف كثيراً تبعاً للأنماط الثقافية السائدة وأنواع التنظيم المُهيمنة في المجتمع. على هذا الأساس، يمكن للذين يسعون إلى تحسين مصير الإنسان أن يؤسّسوا آمالهم: ليس محكوماً على البشر، بسبب تكوينهم البيولوجي، إبادة بعضهم أو أن يكونوا تحت رحمة مصيرٍ قاسٍ صنعوه بأنفسهم.
إذا سألنا أنفسنا عن كيفية تغيير بنية المجتمع والموقف الثقافي للإنسان لجعل الحياة البشرية مُرضية قدر الإمكان، يجب أن نعي دائماً حقيقة أن هناك ظروفاً معيّنة لا يمكننا تغييرها. كما ذُكِر سابقاً، فإن الطبيعة البيولوجية للإنسان، نتيجة كلّ الغايات العملية، ليست عرضة للتغيير. فضلاً عن أنّ التطوّرات التكنولوجية والديموغرافية للقرون القليلة الماضية خلقت ظروفاً وجدت لتستمرّ. في المناطق ذات الكثافة السكّانية العالية نسبياً وحيث البضائع ضرورية للاستمرار، إنّ التقسيم الشديد للعمل والجهاز الإنتاجي المركزي ضروريان للغاية. لقد ولّى زمن الاكتفاء الذاتي الكامل للأفراد أو المجموعات الصغيرة نسبياً (والذي قد يبدو مثالياً إذا نظرنا إلى الوراء). لا نبالغ كثيراً إذ قلنا إن الجنس البشري ما زال يشكّل لليوم مجتمعاً عالمياً واحداً للإنتاج والاستهلاك.
لقد وصلت الآن إلى النقطة حيث يمكنني أن أوضح بإيجاز ما الذي يشكّل بالنسبة لي جوهر أزمتنا الراهنة. يتعلّق الأمر بعلاقة الفرد بالمجتمع. أصبح الفرد أكثر وعياً لاعتماده على المجتمع من أي وقت مضى. لكنّه لا يواجه هذا الاعتماد كقيمة إيجابية أو رابطة عضوية أو قوة حمائية، بل كتهديد لحقوقه الطبيعية أو حتّى لوجوده الاقتصادي. فضلاً عن أنّ موقعه في المجتمع يتمثّل بتزايد الدوافع الأنانية لتكوينه باستمرار، فيما دوافعه الاجتماعية، وهي بطبيعتها أضعف، تتدهور تدريجياً. كلّ البشر، مهما كان موقعهم في المجتمع، يعانون من عملية التدهور هذه. إنهم سجناء أنانيتهم من دون أنّ يدركوا ذلك، يشعرون بانعدام الأمان والوحدة، ويحرمون من متعة الحياة البسيطة والعادية وغير المُعقّدة. لا يمكن للإنسان أن يجد معنى في الحياة القصيرة والمحفوفة بالمخاطر إلّا من خلال تكريس نفسه للمجتمع.
المصدر الحقيقي للشرّ، برأيي، هو الفوضوية الاقتصادية للمجتمع الرأسمالي كما هو اليوم. نرى أمامنا جماعة كبيرة من المنتجين، يسعون باستمرار إلى تجريد بعضهم من ثمار عملهم الجماعي - ليس بالقوّة، بل بالامتثال التام للقواعد القانونية بشكل عام. في هذا الصدد، من المهمّ أن ندرك أن وسائل الإنتاج - أي القدرة الإنتاجية الكاملة الضرورية لإنتاج السلع الاستهلاكية، وكذلك السلع الرأسمالية الإضافية - يمكن أن تكون من الناحية القانونية، وهي كذلك في معظم الحالات، ملكيّة خاصّة للأفراد.
يميل رأس المال الخاص إلى التركز في يد قلّة فيُنتِج أوليغارشيّة لا يمكن لجم قوتها حتى من قبل مجتمع سياسي منظّم ديمقراطياًللتبسيط، سوف أسمّي من لا يملكون وسائل إنتاج "عمّالاً" – ولو أنّ ذلك لا يتوافق تماماً مع الاستخدام المألوف للمصطلح. يكون مالك وسائل الإنتاج في وضع يسمح له بشراء قوّة عمل العامل. وباستخدام وسائل الإنتاج، ينتج العامل سلعاً جديدة تصبح ملكاً للرأسمالي. تكمن النقطة الأساسية في هذه العملية بالعلاقة بين ما ينتجه العامل وما يُدفَع له، وكلاهما يُقاس بالقيمة الحقيقية. بقدر ما يكون عقد العمل "حرّاً" فإنّ ما يحصل عليه العامل لا يتحدّد بالقيمة الحقيقية للبضائع التي ينتجها بل بالحدّ الأدنى لاحتياجاته ومتطلّبات الرأسماليين لقوّة العمل ربطاً بعدد العمّال المتنافسين على وظائف. من المهم أن نفهم أن أجر العامل لا يتحدّد بقيمة إنتاجه حتّى من الناحية النظرية.
يميل رأس المال الخاص إلى التركّز في يد قلّة، ويعود ذلك بجزء إلى المنافسة بين الرأسماليين، وبجزء آخر إلى التطوّر التكنولوجي والتقسيم المُتزايد للعمل اللذين يشجّعان على تكوين وحدات إنتاج أكبر على حساب الوحدات الأصغر. يَنتُج عن هذه التطوّرات أوليغارشية رأس المال الخاص، التي لا يمكن لجم قوّتها الهائلة حتّى من قبل مجتمع سياسي منظّم ديمقراطياً، لأنّ اختيار أعضاء الهيئات التشريعيّة يتمّ من قبل الأحزاب السياسية التي تُمَوّل إلى حدّ كبير أو تتأثّر بطريقة ما بالرأسماليين، الذين لأغراض عملية يفصلون الناخبين عن الهيئة التشريعية. أمّا النتيجة فهي عدم حماية ممثّلي الشعب لمصالح الفئات المحرومة من السكّان. فضلاً عن ذلك، في ظل الظروف الحالية، يتحكّم الرأسماليون لا محالة، بشكل مباشر أو غير مباشر، بالمصادر الرئيسية للمعلومات (الصحافة والإذاعة والتعليم). وبالتالي، من الصعب للغاية، بل من المستحيل في معظم الحالات، أن يتوصّل المواطن الفرد إلى استنتاجات موضوعية وأن يستخدم حقوقه السياسية بذكاء.
بالتالي، يتسم الوضع السائد في اقتصاد قائم على الملكيّة الخاصة لرأس المال بمبدأين أساسيين: أولاً، وسائل الإنتاج (رأس المال) هي ملكيّة خاصة ويتصرّف بها مالكوها بالشكل الذي يرونه مناسباً؛ ثانياً، عقد العمل حرّ. بالطبع، لا يوجد شيء اسمه مجتمع رأسمالي خالص بهذا المعنى. تجدر الإشارة إلى أن فئات معيّنة من العمّال نجحت في الحصول على شكل مُحسّن لـ "عقد العمل الحرّ" نتيجة نضالات سياسية طويلة ومريرة. لكن إذا أخذنا الصورة بكاملها، لا يختلف الاقتصاد الحالي كثيراً عن الرأسمالية "الخالصة".
يتمّ الإنتاج من أجل الربح لا الاستخدام. ليس شرطاً أن يكون جميع القادرين والراغبين في العمل دائماً في وضع يمكّنهم من العثور على عمل؛ هناك دائماً "جيش من العاطلين عن العمل". يخاف العامل باستمرار من فقدان وظيفته. وبما أنّ العاطلين عن العمل والعمّال ذوي الأجور المتدنية لا يوفرون سوقاً مربحة، يصبح إنتاج السلع الاستهلاكية مُقيّد، بما يسفر عن ضائقة كبيرة. يؤدّي التقدّم التكنولوجي غالباً إلى مزيد من البطالة بدلاً من تخفيف عبء العمل على الجميع. إنّ دافع الربح بالتوازي مع المنافسة بين الرأسماليين هما المسؤولان عن عدم الاستقرار في تراكم رأس المال واستخدامه مما يؤدّي إلى كساد شديد بشكل متزايد. تؤدّي المنافسة غير المحدودة إلى إهدار كبير للعمالة، وإلى ذلك الشلل في الوعي الاجتماعي للأفراد الذي ذكرته من قبل.
أعتقد أنّ هذا الشلل هو أسوأ شرور الرأسمالية. يعاني كلّ نظامنا التعليمي من هذا الشرّ. يُغرَس في الطالب موقف تنافسي مبالغ فيه، بحيث يُدرّب على عبادة النجاح استعداداً لمستقبله الوظيفي.
أنا مقتنع بأن الطريقة الوحيدة للقضاء على هذه الشرور الجسيمة هي بتأسيس اقتصاد اشتراكي مصحوب بنظام تعليمي موجّه نحو أهداف اجتماعية. في اقتصاد مماثل، يمتلك المجتمع وسائل الإنتاج ويستخدمها بطريقة مُخطّطة. يوزّع الاقتصاد المُخطّط - الذي يكيّف الإنتاج مع احتياجات المجتمع - العمل المُفترض القيام به على جميع القادرين على العمل ويضمن سبل العيش لكلّ رجل وامرأة وطفل. يهدف التعليم بالإضافة إلى تعزيز القدرات الفطرية للفرد إلى تطوير حسّ المسؤولية لديه تجاه زملائه بدلاً من تمجيد القوّة والنجاح في مجتمعنا الحالي.
مع ذلك، من الضروري أن نتذكّر أن الاقتصاد المُخطّط ليس الاشتراكية. قد يكون الاقتصاد المخطّط على هذا النحو مصحوباً بالاستعباد الكامل للفرد. يتطلّب تحقيق الاشتراكية حلّ بعض المشكلات الاجتماعية والسياسية الصعبة للغاية: في ضوء المركزية البعيدة المدى للسلطة السياسية والاقتصادية، كيف يمكن منع البيروقراطية من أن تصبح قويّة ومُفرطة؟ كيف يمكن حماية حقوق الفرد وبالتالي ضمان ثقل ديموقراطي موازن لسلطة البيروقراطية؟
إن وضوح أهداف الاشتراكية ومشكلاتها له أهمّية كبرى في عصرنا الانتقالي. وبما أنّ المناقشة الحرّة وغير المُقيّدة لهذه المشكلات أصبحت من المُحرّمات الصلبة في ظل الظروف الحالية، أعتقد أنّ تأسيس هذه المجلّة سوف يكون خدمة عامّة مهمّة.
نُشِر هذا المقال في العدد الأوّل من مجلة Monthly Review (أيار 1949).