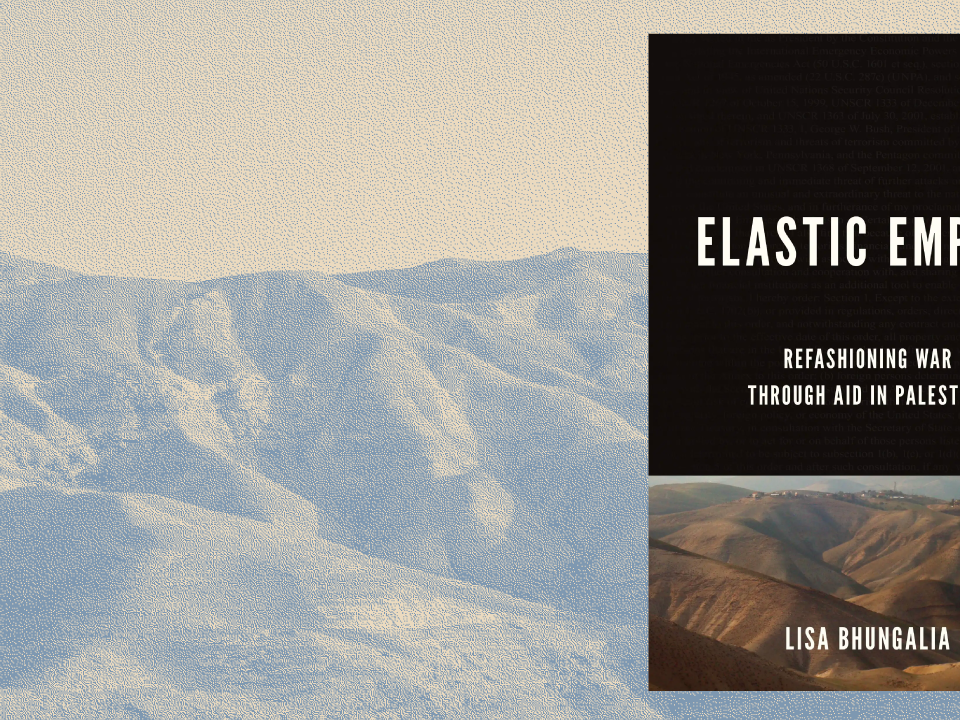لكل رابح خاسر: ما الغرض من التمويل؟
- مراجعة لكتابين: The Fund (الصندوق) من تأليف روب كوبلاند، وThe Trading Game: The Confession (لعبة التداول: اعتراف) لغاري ستيفنسون. يستند جون لانكستر إلى هذين الكتابين لقول إن التمويل الحديث هو مقامرة. يسترشد بالكتاب الأول للإشارة إلى أن الإقراض للشركات العاملة في إنتاج السلع والخدمات لا يمثل سوى 3% من النشاط المالي، في حين يستخدم باقي التمويل للمضاربة على حركة الأسعار، وهو ما يجعل الاقتصاد الحقيقي يتضاءل أمامه. بالنسبة إلى لانكستر، هذا التمويل لا طائل منه، لأنه لا ينتج شيئاً ولا يخلق أي فائدة للمجتمع ولأن كل مكسب يقابله خسارة مماثلة. أما لماذا يكافئ المجتمع هذا النوع من العمل بسخاء؟ فيعود لانكستر إلى الكتاب الثاني: «لعبة التداول: اعتراف» للتاجر السابق في سوق الصرف الأجنبي غاري ستيفنسون، الذي انتقل من وظيفة متواضعة في إلفورد ليصبح أكثر المتداولين ربحية في سيتي بنك. اكتشف ستيفنسون أن الطرق الثلاث الكلاسيكية لكسب الثروة لا تزال سارية: الوراثة، أو الزواج، أو السرقة. ولكن بالنسبة للمواطن العادي الذي يريد أن يصبح ثرياً فالتمويل أو المقامرة هو المسار الأكثر احتمالاً لا العمل بوظيفة وبراتب ثابت.
من السهل إساءة فهم ماهية التمويل المعاصر ووظيفته. يخبرنا الفهم الشائع والكتب المدرسية أنّ التمويل عملية نقل الأموال من أ إلى ب. ثمّة أوقات تكون فيها الأموال في أ، في حساب إدخار مثلاً، أفيد إذا استُخدِمَت في ب، في عمل تجاري يحتاج إلى تمويل للتوسع مثلاً، أو شخص يريد الحصول على قرض عقاري لشراء منزل. ومن السهل أن نستنتج من ذلك أنّ التمويل يركّز بالأساس على تزويد الشركات والأفراد بالأموال التي يحتاجون إليها متى احتاجوا إليها. والحق أنّ التمويل الحديث يفعل ذلك. لكن هذا ليس جوهره اليوم. يتحدث جون كاي في عمله المرجعي لحالة صناعة التمويل اليوم والموسوم «أموال الآخرين» (2015) عن حالة القطاع المصرفي في بريطانيا، بأصوله البالغة آنذاك زهاء 7 تريليونات جنيه إسترليني، أي أربعة أضعاف إجمالي دخل جميع السكان. لكنّ أصول البنوك البريطانية «في معظمها مطالبات على بنوك أخرى، في حين أنّ معظم التزاماتها التزامات تجاه مؤسسات مالية أخرى. أما الإقراض للشركات والأفراد من منتجي السلع ومزودي الخدمات – أي ما يعتقده معظم الناس النشاط الرئيس للبنك – فلا يشكّل سوى قرابة 3% من ذلك الإجمالي».
هكذا، لا يغلب على التمويل الحديث عمل إقراض الأموال لمن يحتاج إليها، بل يغلب عليه عمل المقامرة. إذ يراهن على تحركات الأسعار ويضارب على اتجاهاتها. ولتقريب هذا إلى ذهنك، هَبْ أنّك تعيش في مجتمع مكتفٍ ذاتياً ولكنّه ينتج محصولاً نقدياً واحداً في السنة، قوامه 100 صندوق من المانغا. قبل الحصاد، ولرغبتك في الحصول على المال الآن وليس لاحقاً، تبيع الملكية المستقبلية لمحصولك إلى وسيط مقابل دولار لكل صندوق. يسارع الوسيط إلى بيع حقوق جني المحصول إلى تاجر سمع شائعة مفادها أنّ الطقس السيئ سيجعل المانغا نادرة وبالتالي ترتفع قيمتها، لذلك يدفع 1.1 دولاراً لكل صندوق. يسمع مضارب في أسواق السلع الدولية عن الشائعة ويشتري المحصول المستقبلي مقابل 1.2 دولاراً. ثم يأتي تاجر متخصص في «العقود اللحظية»، وهو من يلتقط الاتجاهات في الأسواق ويراهن على استمرارها (نعم، لدينا من هؤلاء)، ليشتريه مقابل 1.3 دولاراً. بعد ذلك، يتدخل تاجر متخصص في الاستراتيجيات العكسية (نعم، لدينا من هؤلاء أيضاً)، ويستنتج أنّ الاتجاه في الأسعار غير مستدام ويبيع المانغا على المكشوف مقابل 1.2 دولاراً. تلتقط الأطراف الأخرى في السوق عمليات البيع على المكشوف وتخفض الأسعار مرة أخرى إلى 1.1 دولاراً ثم إلى دولار واحد. في هذه الأثناء، يسمع مضارب آخر أنّ التوقعات الموسمية الحالية تشير إلى ملائمة الطقس لمحصول المانغا، ما يعني محصولاً وفيراً، فينخفض سعر البيع إلى 90 سنتاً. عند هذه النقطة، يعود الوسيط الأصلي إلى السوق ويشتري المانغا، ليرتفع سعرها مجدداً إلى دولار واحد. وحين تُحصَد المانغا وتُشحَن إلى الخارج، وتُباع في سوق التجزئة، يشتريها زبون فعلي مقابل 1.1 دولار للصندوق مثلاً.
لا يغلب على التمويل الحديث عمل إقراض الأموال لمن يحتاج إليها، بل يغلب عليه عمل المقامرة. إذ يراهن على تحركات الأسعار ويضارب على اتجاهاتها
لاحظ أنّ التبادل الحقيقي لم يحدث إلّا في المعاملة الأخيرة. أنت زرعت المانغا، والعميل اشتراها. أما ما بين هذا وذاك فكان مجرد تمويل – مضاربة على حركة الأسعار. حدثت في تلك الفترة البينية تسع معاملات، جميعها كانت بمثابة نشاط صفري المجموع. طرف ربح المال يقابله طرف آخر خسر بالمقدار نفسه، وفي النهاية ألغى بعضه بعضاً. لم تُخلَق أي قيمة في هذه السيرورة.
هذا هو التمويل. تقدَّر القيمة الكلية لمجمل النشاط الاقتصادي في العالم بـ105 تريليون دولار. هذه تمثّل المانغا. أما قيمة المشتقات المالية القائمة على هذا النشاط فتُقدّر بـ667 تريليون دولار – وهذه تمثّل التداول اللاحق. هذا يجعل من التمويل التجارة الأكبر في العالم. وهذه التجارة من حيث ما تنتجه عديمة النفع. إذ لا تفعل أي شيء ولا تضيف أي قيمة. كل ما تفعله إنّما المضاربة بين طرفين، ولكل طرف رابح في كل معاملة طرف خاسر يساويه بالمقدار ويعاكسه في الاتجاه.
تستحق هذه النقطة مزيداً من التشديد. توجد طرق أخرى للوصول إلى الثروة، وفي مجتمعنا لا تزال الطرق الكلاسيكية الثلاث لتحقيق الثروة قائمة: الوراثة، الزواج من ثري/ة، أو السرقة. ولكن في حالة المواطن العادي الراغب في الثروة من خلال العمل في وظيفة براتب، يكون العمل في القطاع المالي طريقه الأرجح إليها. بيد أنّ نشاط موظفي القطاع المالي عديم النفع. أقصد هذا بالمعنى الحرفي للكلمة، فهذا النشاط لا ينتج شيئاً ولا يحقق أي فائدة للمجتمع، لأنّ كل مكسب يقابله خسارة مساوية بالمقدار. والمجموع الكلي يساوي الصفر. والفائدة الوحيدة للمجتمع من هذا تتمثّل في الضرائب المحصّلة من الرابحين؛ لكن لا ننسى أنّ الخاسرين يخصمون خسائرهم من الضرائب، لذلك صافي الفائدة الضريبية ليس واضحاً كما قد يبدو للوهلة الأولى.
إن هذه الحالة، من الناحية التاريخية، فريدة من نوعها. إذ كانت معظم الثروات إلى يومنا هذا تعتمد على أصول حقيقية من الأرض أو التجارة، تنتقل بالوراثة غالباً بدلاً من تكوينها من الصفر، لكنها على أي حال تظل حقيقية. أما الشكل الجديد من الثروات فقائم على المقامرة. وإذ نحن نكافئ هذا العمل قليل النفع فبِمَ يخبرنا عن أنفسنا؟ أيّ نوع من المجتمع نحن حقاً؟ وما معنى أن نفكر في هذا القليل؟ جاءت في خلال الوباء برهة صار فيها السؤال عن العمل القيّم والمفيد محور التركيز بعدما اتضح لنا أنّ أسوأ الوظائف أجراً هي تلك التي اعتمدنا عليها جميعاً: موظفو البيع بالمتاجر وعمال النقل وعمال التوصيل. وقد أحسنا في نسيان ذلك. على المستوى الاجتماعي، هذا غير مرضٍ. وبعبارة ملطَّفة، لا أحد سيصمِّم عن عمد مجتمعاً يعمل بهذه الطريقة. لكن يتضح أنّ مراكمة ثروات لا نهائية تقريباً بناءً على ألعاب مالية صفرية لها تبعات سلبية على الفائزين أيضاً.
لكل صفقة رابح وخاسر. شخص ما يحقق الربح وبالتالي مُصيب؛ وآخر يخسر المال، وبالتالي مخطئ. الطبيعة الثنائية للصواب والخطأ، المتكررة عبر آلاف المعاملات، تعزز في الكثير من المقامرين الرابحين شعوراً بالصواب في كل شيء. المسألة ليست في أن تُصيب أكثر مما تخطئ، بل في أن تبزّ الآخرين: تكون على صواب حيث يكون الآخرون على خطأ، ذكي حيث الآخرون سُذّج، عقلاني حيث يكون الآخرون عاطفيين، مُبصر حيث يكون الآخرون عميان، شجاع حيث يكون الآخرون جبناء، قوي حيث يكون الآخرون ضعفاء. لكن الوعي بالتفوق يأتي مع وخزة رهيبة، بأنّ الآخرين لا يرون الأمور بالطريقة نفسها. يرون الثروات، لكن يخالونها مسألة حظ، أو عدم مساواة، أو توزيع غير عادل للموارد الاجتماعية، أو مزيج من كل ما سبق. (وللتوضيح، أنا من أنصار هذا الرأي).
ما العمل؟ الإجابة في المشكلة نفسها. المشكلة أنّ التمويل عديم النفع. وعليه فالحل محاولة إنجاز شيء نافع من منتجه الوحيد: أي الأموال المحققة للرابحين. بما أنّ المقامرة لا تحمل أي معنى، يجب على المقامرين الرابحين إيجاد معنى خارج إطار المقامرة. ومن هنا تأتي أهمية «العمل الخيري» عند فئة مليارديرات القطاع المالي. عمل هؤلاء بلا معنى، لذا يجب إيجاد معنى من خلال ما سيفعلونه لاحقاً بما كسبوه من أموال. وأفضل ما يمكن فعله في رأي هؤلاء أن يؤسسوا سمعة وصيتاً خارج عالم التمويل تتطابق مع ما يحملونه من صورة في أذهانهم. ولهذا السبب يغدو الكثير من هؤلاء بعد الاغتناء مهووسين بتحقيق تصوراتهم عن أنفسهم، أي أن يصبح الواحد منهم فيلسوف ملك. ومن الأمثلة الصارخة على هذا نجد راي داليو، وقد سُطِّرَت قصته بأسلوب ممتاز في كتاب «الصندوق» من تأليف روب كوبلاند مراسل صحيفة نيويورك تايمز والمراسل السابق المتخصص في صناديق التحوط في وول ستريت جورنال.
داليو مؤسس بريدج ووتر صندوق التحوط الأكبر في العالم والمالك الرئيس له. نشأ في عائلة من الطبقة العاملة في مانهاست في لونغ آيلاند، وحصل على فرصته الأولى من خلال اتصالات أقامها في أثناء عمله حاملاً للحقائب في نادي غولف محلي لعائلة ليب، وهي عائلة تمتلك جذوراً عميقة في ثروات نيويورك. أُعجِبَ كبير عائلة ليب بداليو وقدم له فرصة عمل في بورصة نيويورك قادته عبر كلية هارفارد للأعمال إلى عالم التمويل. بعد بضع محاولات فاشلة، أسس داليو في العام 1975 صندوقه الخاص، بريدج ووتر أسوشيتس. وأول عميل مهم له كان صندوق معاشات موظفي البنك الدولي، ومديرته آنذاك هيلدا أوتشوا-بريلينبورغ التي كانت تحب الرهان على مديري الصناديق الشباب الواعدين. انتهى بها المطاف إلى إلغاء التعامل مع بريدج ووتر، لأنّ «الصفقات الموصى بها على الرغم من قدرات داليو الخطابية كانت في الأساس مجرد رهانات على ارتفاع أسعار الفائدة وانخفاضها». لكن ذلك لم يكن مهماً، فداليو وصندوقه قد انطلاقا.
تقدَّر القيمة الكلية لمجمل النشاط الاقتصادي في العالم بـ105 تريليون دولار. أما قيمة المشتقات المالية القائمة على هذا النشاط فتُقدّر بـ667 تريليون دولار
لم يكن المميز في داليو طريقته في الاستثمار. فقد حاول صندوقه، شأنه شأن غيره من الصناديق، ضمان تحقيق عوائد بصرف النظر عن حركة السوق، وكان له ذلك عن طريق مزيج من المراهنات كان من المفترض فيها الربح سواء صعدت السوق أو هبطت. لكن حساب الحقل – ادعاء داليو العثور على «كأس الاستثمار المقدسة» – لم يوافق حساب البيدر. فقد مرّ صندوقه بسنوات جيدة وأخرى سيئة. لكن ساعدته نجاحات بارزة في لحظات كانت فيها السوق في حالة هبوط. في العام 1987، سنة الاثنين الأسود، حين هبط مؤشر داو جونز بمقدار 22.6% في يوم واحد، ارتفع صندوقه بنسبة 27% في ذلك العام. (قلة تعلم أنّ المؤشر ارتفع مع نهاية السنة بـ2.3% مقارنة ببدايتها على الرغم من الانهيار). في 2008، سنة الانهيار المالي، ارتفع صندوقه (بيور ألفا) بمقدار 9%، في حين شهد المؤشر أسوأ سنواته على الإطلاق بانخفاض 34%. ساهمت هذه اللحظات الرائعة في إخفاء حقيقة أنّ الصناديق كانت تفرض، في معظم الأوقات، رسوم عالية لقاء أداء أقل من عادي. في عديد السنوات العادية، حقق صندوق أو أكثر من الصناديق الخالية من الرسوم أداءً أفضل من أداء صناديق بريدج ووتر. وفي خلال 11 سنة بين بداية 2012 ونهاية 2022 ارتفع صندوق بيور ألفا التابع لبريدج ووتر بمقدار 17.8%. قد تظن هذا جيداً، لكن في خلال الفترة نفسها ارتفع مؤشر ستاندر آند بورز 500 (المؤشر الأشيع بين المستثمرين) بمقدار 273%. وجد تقرير لوول ستريت جورنال في 2020 أنّ الصندوق الرائد لبريدج ووتر قد تفوقت عليه (أرخص) محفظة استثمارية عادية جاهزة يمكنك العثور عليها، تنقسم إلى 60/40 بين أسهم وسندات.
لم يكن المميز في داليو أداءه الاستثماري، بل مقدار ما يحدثه من ضجة. فقد نشر منذ أيامه الأولى في مسيرته المهنية نشرة بريدية يومية – ليس أسبوعية ولا شهرية، بل يومية – عرضَ فيها آراءه عن اتجاهات السوق وتطوراتها وأنماطها التاريخية. وقد تخصص في التنبؤ بهبوط حاد في السوق، ودأب على هذا بانتظام لا يتزحزح بالرغم من أنّ الانهيارات لم تحدث على الإطلاق. قال أمام لجنة من الكونغرس في العام 1982: «كانت متابعة الاقتصاد في السنوات القليلة الماضية أشبه بمشاهدة فيلم إثارة غامض، يمكنك أن ترى فيه المخاطر تلوح وتقترب وتريد أن تصرخ محذّراً ولكنك تعلم أنّ أحداً لن يسمعك. والخطر في هذه الحالة هو الكساد». في تلك اللحظة كانت السوق قد دخلت مرحلة الازدهار الطويل في سنوات ريغان. قال أحد الزملاء مازحاً: «لقد تنبأ بخمسة عشر ركوداً من آخر فترات ركود لم تحدث» – على الرغم من أنّ النكتة كما اتضح كانت على الجميع، لأنّ داليو حين انقلبت السوق كان صاخباً ومتسقاً للغاية في التنبؤ بالانهيارات لدرجةٍ بات يُرى نبياً بدلاً من رؤيته ساعة معطلةً تشير إلى التوقيت الصحيح مرتين في اليوم. هكذا، فإنّ الجمع بين الحضور العام وبعض الرهانات الكبيرة الناجحة (في سياق الأداء العام الروتيني إلى حد كبير) جعل من بريدج ووتر بحلول آذار/مارس 2009 أكبر صندوق تحوط في العالم، من حيث الأصول الواقعة تحت إدارته.
زاد انهماك داليو ببناء سمعة لنفسه كمرشد روحي. وكان كثير الحديث عن «مبادئ» بريدج ووتر، وهي مجموعة من الأقوال المأثورة وضعها على مر السنين، وشكّلت القواعد لما أسماه جون كاسيدي من مجلة نيويوركر «أغنى وأغرب صندوق تحوط في العالم». وكان قصده وراء ذلك خلق ثقافة المصارحة الجذرية. وكان من المفترض أن يتبادل جميع موظفي بريدج ووتر ملاحظات مستمرة. لا سيما الملاحظات السلبية. ومن تلك المبادئ «لا أحد لديه الحق في تبني رأي نقدي من دون الإعراب عنه». وكان من المحظور انتقاد أي شخص في غيابه: عليك قول كل شيء مباشرةً في وجه الشخص المعني. وكان يُمنَح كل شخص في بريدج ووتر جهاز كمبيوتر لوحي من المفترض أن يملأه بـ «نقاط»، إيجابية أو سلبية، مع إعطاء تقييمات مستمرة لكل جانب من جوانب الشركة وزملائه. وكانت المكاتب مليئة بالكاميرات ومعدات الصوت تسجِّل التفاعلات بين الموظفين، وتنتهي هذه كلها إلى مكتبة الشفافية، حيث يمكن لموظفين آخرين الاطلاع عليها وتقديم الملاحظات. يسلِّم الموظفون هواتفهم الشخصية عند وصولهم إلى العمل، ولا يُسمح لهم باستخدام سوى هواتف الشركة الخاضعة للمراقبة؛ ويجري تتبع الضغطات على مفاتيح الكمبيوتر.
وضِعَت المراقبة والتقييمات موضع التنفيذ لهدف. كانت الإخفاقات تستدعي «تحقيقات» أو استجوابات علنية، غالباً بقيادة داليو نفسه، ويضغط على الموظف لمعرفة ما أخطأ فيه، في محاولة للوصول إلى «الحقيقة الأسمى» أو الضعف الداخلي الذي تسبب بحدوث ذلك. بعد زيارته للصين وإعجابه بما رآه، أدخل داليو لشركته نظاماً يتضمن تنافس قادة المبادئ والمراجعين والمشرفين على تطبيق المبادئ ورفع التقارير إلى هيئة تُسمى البوليتبورو (المكتب السياسي). جرى تجميع مقاطع فيديو لموظفين ضُبِطوا ينتهكون مبدأً معيناً، ثم خضعوا لتحقيقات، ثم تعهدوا بتصحيح سلوكهم، واستخدام هذه الفيديوهات لغرس المبادئ. إحدى هذه السلاسل من الفيديوهات حملت عنوان «إيلين تكذب»، يوثِّق ضبط زميلة كبيرة في الشركة تكذب. في فيديو آخر، تعرضت زميلة كبيرة جديدة وحامل لإذلال علني وصل حد البكاء، وكان عنوان الفيديو «الألم + التأمل = التقدم». سُرَّ داليو بهذا الفيديو لدرجة أرسله إلى جميع موظفي الشركة الألف، وأمر بعرضه على المتقدمين للعمل في الشركة. كان التعبير عن التعاطف مع الضحية طريقة مؤكدة لعدم الحصول على الوظيفة. أحد المبادئ كان «التغليف بالسكر يسبب إدمان السكر». إحدى رؤى داليو كانت برمجة المبادئ في برنامج يكون مرجعاً لاتخاذ القرارات في بريدج ووتر. استغرقت هذه الرؤية أكثر من عقد، وكلفت 100 مليون دولار، ولم تنتج شيئاً مفيداً، والسبب الأساسي أنّ المبادئ، الـ 375، مليئة بالعبارات الفارغة والمتناقضة.
بما أنّ المقامرة لا تحمل أي معنى، يجب على المقامرين الرابحين إيجاد معنى خارج إطار المقامرة. ومن هنا تأتي أهمية «العمل الخيري» عند فئة مليارديرات القطاع المالي.
في ظاهر الأمر، لا بد أن يكون هذا كوميديا سوداء عن الغرور والأوهام وفئة لا تتورع عن أي شيء في سبيل الثروة بما أنّ العمل في بريدج ووتر ليس إلزامياً. ولا شك أنّ موليير كان ليقضي مع راي داليو وقتاً مرحاً، لا سيما مع مشهد لحفيد جورج ليب تعيس الحظ، وهو مَن منح داليو فرصته الأولى، يكتب طلباً للحصول على وظيفة. فكيف جاء رد داليو؟
إذا كنت أهلاً لهذه الوظيفة، فسيرتك الذاتية وسيلتك الوحيدة للحصول عليها. لن أتدخل في عمل قسم الموارد البشرية لدي كرمى لأحد.
لن أحابي أيّ متقدمٍ ولو كان كلبي.
إنّ تبجحه ونكرانه للجميل يستدعيان الدهشة بذاتهما، لكنّهما يتحولان لعظمة بفعل صورة تقدّم كلبه لطلب وظيفة.
ولكن على الرغم من مئات الأمثلة على سلوكيات مماثلة، فكتاب كوبلاند ليس بالمرح. والسبب بسيط: فقد صُمِّمت أنظمة بريدج ووتر «لتنساب» من أعلى إلى أسفل. فحين وُضِعَت التصنيفات الداخلية للصندوق، كانت «المصداقية» أعلى قيمة فيها، وكانت تنحدر من داليو المتربع على القمة. فهو معيار الفضيلة ومدى الالتزام بالمبادئ، ومن ثم فإنّ ثقافة المصارحة والشفافية الجذرية والاستجواب/الإذلال العلني (والمراقبة في السعي لتحقيق هذه الأهداف) تتدفق من أعلى إلى الأسفل. فالنقد والمصارحة و«التحقيق» يوجهها هو على الدوام ولا تُوَجَّه إليه. لكنّ التقارير المتملقة ــ «على الرغم من تلقيبه بستيف جوبز الاستثمار، فإنَّ الموظفين لا يتواصلون معه وكأنَّه شخص مميز» ــ جسَّدَت نقيض الحقيقة: كانت هذه ثقافة مؤسسية من التنمر على نطاق مروّع، أُقيمَت صرحاً لغرور فرد واحد وأوهامه. وعلى غرار أيّ متغطرس، فأكبر أوهام داليو إيمانه بتواضعه. وكل ذلك في مسعى لا غاية له سوى كسب المزيد من المال.
حين قدَّمَ جورج سوروس شهادته أمام لجنة البنوك في مجلس النواب حول صناديق التحوط في العام 1994، طرح تعريفاً موجزاً لماهية تلك الصناديق، إلى جانب توصية بشأن كيفية التعامل معها. قال: «المشترك الوحيد بينها أنّ مديريها يحصلون على تعويضاتهم بناءً على الأداء وليس بناءً على نسبة ثابتة من الأصول المُدارة. وبصراحة، لا أرى في صناديق التحوط مصدر قلق لكم أو للجهات التنظيمية». قد نختلف بشأن كلا الجزئين – إذ تفرض الصناديق عادة رسوماً بنسبة 2% سنوياً على سبيل المثال –، لكنني أتفق معه بوجه عام. تفشل صناديق التحوط وتفلس وتغلق طوال الوقت، وعواقب ذلك لا تقع عادةً إلا على مستثمريها، وهؤلاء يستطيعون تحمل ذلك بطبيعتهم. أما البنوك فمختلفة. لديها ضمان ضمني من الدولة، وبالتالي من دافعي الضرائب، فما تفعله شأنٌ يخصنا قطعاً.
يعرض كتاب لعبة التداول رواية لما يحدث داخل البنوك حين تمارس نشاط «التمويل»، أي فعلياً المقامرة. الكتاب صادم، إنّما ليس مفاجئاً، لأنّ رواية غاري ستيفنسون تتطابق إلى حد كبير مع التحليلات النقدية لمراقبين خارجيين بصدد النظام المصرفي في أعقاب الأزمة المالية العالمية. أما الصدمة أنّ رواية ستيفنسون في معظمها لا تجري في فترة ما قبل الانهيار، بل بعده حين يُفترض أنّ الدروس قد استُخلِصت والسلوكيات قد تغيّرت. يتضح من كتابه أنّ مَن تحدث منا عن خصخصة الأرباح وتعميم الخسائر كان، بلا مواربة، على حق تماماً.
ينبع وضوح الكتاب وصراحته من منظور غاري ستيفنسون الخارجي. فقد نشأ في عائلة من الطبقة العاملة في إلفورد، على مرمى حجر من مركز كناري وارف المالي حيث سيعمل لاحقاً. كان ستيفنسون قد طُرِد من المدرسة الثانوية لبيعه الماريجوانا – وهي تجارة دخلها لأنّ حيه كان يعجّ بتجار المخدرات، فكان الأطفال من الأحياء الأرقى يسألونه التوسط في شراء المخدرات. لكن بفضل موهبته الاستثنائية في الرياضيات، حصل على مقعد في كلية لندن للاقتصاد. وفي أثناء وجوده هناك، فاز بتدريب في سيتي بنك من خلال مسابقة تداول، وحوّل التدريب إلى وظيفة لينتقل في وقت قصير إلى وظيفة متداوِل في قسم مبادلات العملات الأجنبية. والمبادلات أداة مالية تسمح لطرفيها بتبادل مؤقت لقرض بعملة معينة مقابل قرض بعملة أخرى، ويدفع أحدهما للآخر الفرق في أسعار الفائدة. مثلاً، أبادل يوروهاتي التي تدفع 2% فائدة بدولاراتك التي لا تدفع أي فائدة، وأدفع لك 2% لتعويض الفرق في أسعار الفائدة. لماذا أقوم بهذه المبادلة؟ لحاجتي إلى الدولارات. وللبنوك والشركات عديد الأسباب التي تجعلها بحاجة إلى الدولارات. وسيتي بنك، أكبر بنك في الولايات المتحدة آنذاك، كان يتمتع من خلال الاحتياطي الفيدرالي الأميركي بوصول إلى ما يعادل إمداداً غير محدود من الدولار الأميركي. وقد قيل لستيفنسون إنّ تداول الدولار مقابل العملات الأخرى «مال مجاني»: «بدأ المتداولون في جني مليون دولار يومياً، مرتين أو ثلاث في الأسبوع. ولم يكن الإفلاس الوشيك لصاحب العمل مصدر قلق لأحد. كنا جميعاً على علم بأنّنا سنحصل على إنقاذ مالي».
تحوّل قسم مبادلات العملات الأجنبية في سيتي بنك إلى أحد المصادر الرئيسة لأرباح هذا البنك الضخم، بعدما كان في السابق هامشي إلى حد ما. كان ستيفنسون في المكان والتوقيت المناسبَين، وامتلك المهارات المناسبة. كان والده يعمل في مكتب البريد ويكسب 20 ألف جنيه إسترليني سنوياً. (يحتوي كتاب ستيفنسون على لحظات مؤثرة، منها وصفه لاستيقاظه قبل الفجر لإلقاء التحية على والده عبر النافذة وهو يتوجه إلى عمله عبر قطار الصباح الباكر من محطة سيفين كينغز). في سنته الأولى في البنك، حصل ستيفنسون على راتب قدره 36 ألف جنيه إسترليني، بالإضافة إلى مكافأة بلغت 13 ألف جنيه إسترليني. في السنة الثانية، كان لا يزال يتقاضى 36 ألف جنيه إسترليني، لكن مكافأته قفزت إلى 395 ألف جنيه إسترليني. وبحلول سنته الرابعة، توقف عن الكشف عن المبلغ الدقيق لمكافأته، لكن من الواضح أنّ المبلغ قد تجاوز الملايين. كان يستثمر مبالغ ضخمة ومتزايدة من أموال البنك، بتشجيع من رؤسائه الذين قدَّموا للمتداولين قبعات بيسبول كتب عليها «Go Big or Go Home». يخبرنا ستيفنسون أنّه أصبح المتداول الأكثر ربحية في سيتي بنك. تتحدث البنوك بلغة «إدارة المخاطر»، لكن ما حدث هنا أنّ شاباً في عامه الرابع والعشرين كان يراهن بمليارات الدولارات يومياً.
تفشل صناديق التحوط وتفلس وتغلق طوال الوقت، وعواقب ذلك لا تقع عادةً إلا على مستثمريها، وهؤلاء يستطيعون تحمل ذلك بطبيعتهم. أما البنوك فمختلفة. لديها ضمان ضمني من الدولة، وبالتالي من دافعي الضرائب، فما تفعله شأنٌ يخصنا قطعاً
لتُحقِّق أموالاً في عالم التمويل، يوضح ستيفنسون، لا يكفي أن تكون على حق. بل لا بد أن تكون على حق لحظة يكون الجميع على خطأ. كانت رهانات ستيفنسون تستند إلى تجربته في الحياة خارج فقاعة التمويل. بعد الأزمة المالية، كانت البنوك المركزية تطبع الأموال في محاولة محمومة لإنعاش اقتصاداتها. وكانت الفكرة أنّ هذه الأموال ستجد طريقها من البنوك التي تلقت الأموال الإلكترونية الجديدة إلى الاقتصاد الحقيقي على شكل تحفيز اقتصادي عام. لكن ستيفنسون كان يرى جميع معارفه خارج العالم المالي يكافحون. وفي إحدى المحادثات بينه وبين زميله الإيطالي تيتزي قال:
«تيتزي. هل تظن أنّ الناس لا تنفِق لأنّ ليس لديها مال؟»
«ما هذا الهراء يا صاح؟ كيف لا يملك المرء أي مال؟»
لهجته إيطالية. «صاح» كلمة جديدة تعلمها مؤخراً ويجرب استخدامها.
«يعني، كما تعلم، كنت اسأل الناس والجميع يقول ليس معي القرش».
«ليس معي القرش». يحاول تيتزي تقليد لهجتي ولكن كلماته تخرج إيطالية قح. «بربك يا صاح. هذا نظام نقدي. يستحيل وجود أحد بلا مال. كل شيء لا بد متوازن».
كان هذا الفكر الاقتصادي التقليدي كما تعلّمه ستيفنسون في كلية لندن للاقتصاد. لكنّه أدرك بعد الأزمة خطأ هذا الفكر.
كنا نشخّص سرطاناً على أنّه سلسلة من نزلات البرد الموسمية. وظننّا أنّ النظام المصرفي معطل ولكن يمكن إصلاحه. وظننّا أنّ الثقة قد انهارت ولكنها ستعود. لكن ما كان يحدث فعلياً أنّ ثروة الطبقة الوسطى – أو العائلات العادية التي تعمل بجد... ومعظم حكومات العالم الكبرى – كانت تُسحب منها وتذهب إلى أيدي الأغنياء. كانت العائلات العادية تفقد أصولها وتغرق في الديون. وكذا الحكومات. وبينما كانت العائلات العادية والحكومات تزداد فقراً، كان الأغنياء يزدادون ثراءً، أي تزيد تدفقات الفائدة والريع والأرباح من الطبقة الوسطى إلى الأغنياء، الأمر الذي يزيد من تفاقم المشكلة. هذه المشكلة لن تحل نفسها. في الواقع، ستتسارع وتزداد سوءاً. السبب في عدم إدراك الاقتصاديين لذلك أنّ معظمهم لا ينظر في نماذجه إلى كيفية توزيع الثروة. يقضي هؤلاء عشر سنوات في حفظ نماذج «الفاعل الممثل» – وهي نماذج تنظر إلى الاقتصاد بأكمله على أنّه شخص واحد «متوسط» أو «ممثل». ونتيجة لذلك، يرون المتوسطات والتجميعات محور الاقتصاد. ويتجاهلون مسألة التوزيع. إذ لا تعدو عندهم كونها فكرة لاحقة. تزيين أخلاقي. وأخيراً، كانت شهادتي الجامعية مفيدة في شيء ما على الأقل. فقد أظهرت لي كيف كان الجميع على خطأ.
قصة عن شخص من خارج المجال يتفوق على أبناء المجال، عن فتى جاء من خلفية غير ميسورة وصعبة وتفوق على فتيان بدأوا برصيد أكبر من الامتيازات لكن بشغف ومهارة أقل – قد تبدو قصة الكتاب مبهجة. لكن لعبة التداول ليس كتاباً مبهجاً، بل رواية غاضبة ومريرة تؤكد النظرة النقدية للنظام المالي. كما أنّها قصة عن التروما. فبعدما حقق ستيفنسون نجاحه الكبير، ينفق مكافأته على شقة، ليس لحاجته إلى واحدة، بل لعلمه أنّ الأغنياء – المستفيدين من معدلات الفائدة الصفرية – يستثمرون أموالهم في الأصول، وبالتالي توشِك الأصول أن تشهد ارتفاعاً في الأسعار. «هذا أقلقني، فقد أعطوني كمية هائلة من المال، ولم يكن لدي منزل، لذلك ذهبت ورأيت شقة فاخرة على المارينا بالقرب من المكتب وقدمت عرضاً أعلى بنسبة 5% من السعر المطلوب، واشتريتها بهذه البساطة». أزال الجدران والأضواء والأحواض والمراحيض من شقته الجديدة، وتركها أشبه بصندوق فارغ، مع تلفزيون ومرتبة على الأرض. «وفي كل يوم كنت أستيقظ في الساعة 5:30 صباحاً، ثم أقرأ خمسمائة بريد إلكتروني، هناك، على الأرض».
توقف ستيفنسون عن الاكتراث. نُقِلَ إلى اليابان، ولا يزال غير مبالٍ؛ قضى فترة مؤلمة يتفاوض على مغادرته من سيتي بنك المتردد بشدة. كان مكتئباً ومستنزفاً؛ والطريقة الوحيدة للنجاة من تجاربه كانت أن يتحول إلى شخص آخر، لكنّه لم يرِد ذلك. تنهي قراءة كتابه وأنت غير متأكد مما إذا كان قصة انتصار أم هزيمة. إنّه الكتاب المثالي لتقديمه لشاب يفكر في مسيرة في عالم التمويل، فطريقة إجابته عن هذا السؤال ستحدد وجهة نظره حول معنى وجوده في ذلك العالم. ستيفنسون الآن ناشط ضد اللامساواة الاقتصادية، ويدير قناة على يوتيوب (اقتصاد غاري) تقدِّم معلومات مفيدة جداً (غاضبة ومريرة) بها قرابة 400 ألف مشترك. إذا كان معنى ما يفعله الناس في عالم التمويل يأتي مما يفعلونه بذلك المال، فقد اختار ستيفنسون أنّ يجد ذلك المعنى في النشاط ضد اللامساواة. لقد اختار أن يعض بقدر ما يستطيع اليدَ التي أطعمته.
أسس داليو أكبر صندوق تحوط في العالم، وكان ستيفنسون أفضل متداول في أحد أكبر البنوك العالمية؛ لكن بطل عالم المال الخالص على مر العصور كان جيم سيمونز، المتوفى في أيار/مايو. أسس سيمونز وأدار شركة (رينيسايس تكنولوجيز)، صندوق تحوط حقق متوسط عائد سنوي قدره 66% على مدى ثلاثين عاماً (قبل الرسوم). هذا رقم يصعب فهمه: إذا استثمرت 10 آلاف دولار وتركتها تتراكم بنسبة 66% لمدة ثلاثين عاماً، فستنتهي بامتلاك 2.35 تريليون دولار. ستبدأ بمبلغ يكفي لشراء سيارة مستعملة متوسطة، وتنتهي بمبلغ يكفي لشراء إيطاليا (الناتج المحلي الإجمالي الحالي 2.25 تريليون دولار). لكن المانع الوحيد من تحقيق ذلك مع صندوق (Medallion) أنّ الصندوق كان يدفع أرباحه كل عام لتحديد حجمه – بغير ذلك، كان سينمو لدرجة يصعب معها الحفاظ على سرية أساليبه وتقنياته. وأيضاً، لم يُسمَح بالمشاركة في الصندوق إلّا لموظفي الشركة أو موظفيها السابقين. جاءت هذه الخيارات من تفضيل سيمونز للبقاء بعيداً عن الأنظار، ولعل هذا ما يفسر أنّك لم تسمع به من قبل، إلّا إذا كنت من المهتمين بعالم المال. لكن لم يقترب أي مستثمر أو مضارب أو مقامر أو ساحر من أداء سيمونز وصندوقه المالي.
لتُحقِّق أموالاً في عالم التمويل، لا يكفي أن تكون على حق. بل لا بد أن تكون على حق لحظة يكون الجميع على خطأ
في الجزء الأخير من عمله الرائع «سيتي أوف لندن»، وهو عمل يتناول الفترة من 1945 إلى 2000، يلاحظ ديفيد كاينستون أنّ أناس الحي في هذا الجزء يبدون أكثر مللاً مقارنة بأناس الأجزاء السابقة، إذ كل ما يفعلونه في حياتهم يدور حول العمل في عالم المال. لكن سيمونز لم يكن كذلك، فقد كانت حياته على مستوى عمالقة المدرسة القديمة. وُلِد في كامبريدج، ماساتشوستس في العام 1938، عاش طفولة تقليدية وسعيدة مشغولة بالرياضيات قبل التحاقه بمعهد ماساتشوستس لدراسة موضوعه المفضل. بعد التخرج في سن العشرين، استأجر وبعض أصدقائه دراجات نارية وقادوها من بوسطن إلى بوغوتا، حيث صار لاحقاً شريكاً في شركة تبليط. ثم انتقل إلى بيركلي للحصول على درجة الدكتوراه، بتأثير وجود عالم الرياضيات الصيني الأميركي الشهير شينغ-شين تشيرن. أنهى أطروحته في غضون عامين وعنوانها «بصدد قابلية النقل لنظم الهولونومي». وبحسب كاتب سيرته الذاتية جوفري زوكرمان، يحب سيمونز تعريف الهولونومي بأنّه «نقل متوازي لمتجهات المماس حول منحنيات مغلقة في فضاءات منحنية متعددة الأبعاد». في العام 1962، انتقل سيمونز شرقاً ليُدرّس في معهد مساتشوستس ثم في هارفارد، لكنّه شعر بالإحباط من انخفاض الأجور الأكاديمية، لذا غادر بعد عامين ليعمل خبير تشفير في معهد تحليل الدفاع، أحد روافد وكالة الأمن القومي ولا يزال إلى الآن أكبر موظِّف لعلماء الرياضيات البحتة. امتلك سيمونز موهبة حقيقية في فك الشفرات. استمتع بالعمل والمال الإضافي، لكن حين اندلعت الحرب في فيتنام، عارض التدخل الأميركي، وجاهر بذلك ليُفصَل على إثر هذا من عمله.
كان لسيمونز ثلاثة أطفال صغار وكان بحاجة ماسة إلى وظيفة. (يستشهد زوكرمان بنكتة بين الرياضياتيين تقول: ما الفرق بين دكتوراه في الرياضيات وبيتزا كبيرة؟ البيتزا الكبيرة يمكن أن تُطعم عائلة من أربعة أفراد.) عرضت جامعة سوني ستوني برووك، المعروفة «بمشكلتها مع تعاطي المخدرات في الحرم الجامعي»، على سيمونز رئاسة قسم الرياضيات فيها. تولى المنصب في العام 1968، وكان في الثلاثين من عمره، وسرعان ما اتضح أنّ سيمونز، بالإضافة إلى مهاراته في موضوعه، كان خبيراً في اكتشاف المواهب ومديراً ممتازاً أيضاً (خلطة ثلاثية غير شائعة). في خلال عشر سنوات، تحوّل القسم على يديه إلى واحد من أقوى أقسام الرياضيات في الولايات المتحدة. كما واصل عمله الخاص، وأعاد التواصل مع معلمه السابق شيينغ-شين تشيرن. حقق سيمونز تقدماً مهماً يتعلق بالفضاءات ثلاثية الأبعاد المنحنية. رأى تشيرن إمكانية تطبيق الفهم نفسه على جميع الأبعاد. نُشر عملهما في العام 1974 تحت عنوان «الأشكال المميزة والثوابت الهندسية»، وفيه فكرة جديدة عُرفت لاحقاً بثوابت تشيرن-سيمونز. أسفر ذلك عن تطوير مجال يُعرف بنظرية تشيرن-سيمونز. في العام 1976، حصل سيمونز على جائزة أوزوالد ڨِبلن في الهندسة، أعلى جائزة في المجال.
كان لهذا العمل تأثير كبير يتجاوز الرياضيات. في العام 1995، قدَّم إدوارد ويتن، وهو فيزيائي يراه البعض أشبه بأينشتاين معاصر، ورقةً أظهر فيها أنّ خمسة نسخ مختلفة متنافسة من نظرية الأوتار ليست إلّا أشكالاً مختلفة لهيكل رياضي واحد، بفضل – انتباه من فضلكم – ثوابت تشيرن-سيمونز. هذه النظرية، المعروفة بنظرية (م) كما أسماها ويتن، توحِّد جميع الأشكال المختلفة لنظرية الأوتار بطريقة مفاجئة وعميقة ومقنعة رياضياً. ومنذ ذلك الحين، صارت هذه النظرية سائدة، مع أنّها لا تزال محل جدل، في مجال الفيزياء النظرية. وهي تعتمد على أعمال جيم سيمونز.
بعدما أنجز كل هذه الأمور – التشفير، الوصول إلى ذروات البحث الرياضي البحت، تأسيس وإدارة قسم جامعي –، استقال سيمونز في سن الأربعين. كان لديه رغبة لم تُشبع تتعلق بالمال، وانشغال فكري دائم بالأسواق، كما كان لديه رأي واضح بأنّ الثروة ليست الهدف، إذ لاحظ منذ صغره أنّ الأغنياء يعيشون حياة أسهل من الفقراء. لكن كما يقول زوكرمان، «لم تكن الاحتمالات في صالح رياضي أربعيني يبدأ مسيرته المهنية الرابعة، آملاً في إحداث ثورة في عالم الاستثمار الذي يعود تاريخه لعدة قرون».
أسّس سيمونز صندوقه، رينيسانس تكنولوجيز، على حدسه بإمكانية إيجاد طريقة جديدة لكسب المال في الأسواق. كانت صناديق التحوط، من قبيل بريدج ووتر، تحاول كسب المال بغض النظر عن ظروف السوق – سواء ارتفعت أو هبطت. الجديد في سيمونز لم يكن تلك الطموحات، بل نيته تحقيق ذلك من خلال مجموعة جديدة من التقنيات الرياضية. انصبَّت خطته على العثور على أنماط رياضية في السوق: إشارات غير مرئية في حركة الأسعار تكشف وتسمح له بتوقع الحركات المستقبلية لتلك الأسعار. يختلف هذا عن الاستثمار القائم على «الأساسيات»، حيث يدرس المستثمر بدقة شركة ما للحصول على معلومات بصدد ما يحدث فعلاً في العمل ويخصص الأموال وفقاً لذلك. وارن بافيت أشهر وأغنى شخصية في هذا الأسلوب من الاستثمار. لم يكن سيمونز مهتماً بالأساسيات. لم يكن لديه اهتمام بالقيمة الحقيقية للسهم أو السند أو السلعة. لم يكن يكترث بحركة الأسعار الأسبوع المقبل، بل أراد أن يجد طريقة لمعرفة وجهة الأسعار الآن، اليوم، وكان يريد الدخول والخروج وكسب المال. خطَّط لوضع لا رهان كبير أو اثنين، بل عشرات الآلاف من الرهانات الصغيرة، ليحقق النجاح في 51% من المرات. هذا كل ما كان يحتاج إليه: ألّا يصيب بالمطلق، بل أن يصيب في معظم الأوقات.
هامش: وجدت دراسة منشورة على arxiv.org العام الماضي نتائج غريبة ولافتة عن الاحتمالات، أظهرت أنّ احتمال الحصول على النتيجة نفسها من تكرار رمي عملة معدنية هو 51%. ربما تعلمت أنّ احتمالية ظهور الملك أو الكتابة في كل رمية متساوية تماماً. لكن، ياللغرابة، تبين أنّ هذا ليس صحيحاً. فالعملة الملقاة بقوة والملتقطة في الهواء لديها احتمال أعلى بنسبة 2% للهبوط على الوجه الظاهر في آخر مرة. يبدو أنّ لمبادئ الديناميكا الهوائية دور هنا: تدفق الهواء حول العملة الملقاة يجعلها أكثر احتمالاً بنسبة ضئيلة لتكرار النتيجة السابقة1. يعترف بعض من أغنى الأشخاص في العالم أنّهم اكتسبوا ثرواتهم بناءً على طريقة الاحتمالات من رمي عملة.
لتحقيق ذلك، كما في أفلام السرقات، جمع سيمونز فريقاً. تحقق نجاح شركته بفضل عبقريته الرياضية ومهارته في معرفة الناس (Menschenkenner). تجنب توظيف أي شخص لديه معرفة مسبقة بأسواق المال، إذ لم يرِد إعادة إنتاج الحكمة الاستثمارية الموجودة بالفعل. بدلاً من ذلك، كان يوظف علماء حاصلين على درجة الدكتوراه في الرياضيات والفيزياء وعلوم الكمبيوتر. يمكن تلخيص تقنيات شركة رينيسانس ببساطة – البحث عن أنماط خفية في تحركات الأسعار –، لكن من المستحيل وصفها بالتفصيل لتعقيد الرياضيات فيها وهوس سيمونز بالسرية. إذا عرف الناس ما كانت تفعله الشركة، ستختفي ميزتها التنافسية. وكان من المفيد أيضاً أن تمتلك الشركة طريقة لا مثيل لها لضمان ولاء موظفيها: الوصول الحصري إلى صندوق Medallion، أفضل مجموعة من الأصول الاستثمارية شهدها التاريخ.
ما كان يحدث فعلياً أنّ ثروة الطبقة الوسطى – أو العائلات العادية التي تعمل بجد... ومعظم حكومات العالم الكبرى – كانت تُسحب منها وتذهب إلى أيدي الأغنياء
الأسواق المالية صفرية المجموع. كانت رينيسانس تحقق الأرباح، لذا كان غيرها يخسرونها. مَن هؤلاء؟ ظهرت استنتاجات متنوعة حول هذا الأمر داخل الشركة. اعتقد سيمونز أنّ «مدير صندوق تحوط عالمي يدأب على التكهن باتجاه سوق السندات الفرنسية يكون من السهل استغلاله». كان لدى أحد زملائه تفسير آخر. «هم مجموعة من أطباء الأسنان»، وأشار إلى «مجموعة مختلفة من المتداولين المعروفين بتداولاتهم وثقتهم المفرطة في توقع اتجاه السوق». بينما كان لرائد أعمال آخر وجهة نظر ثالثة. «نحن متداولون متوسطو الأداء لكن ليس بيننا خلافات - وهذا النوع من الأمور ما يسبّب أنماطاً في الأسواق». بطريقة أو بأخرى، سواء كان ذلك من أطباء الأسنان أو صناديق التحوط أو أشخاص بينهم خلافات، كانت الشركة تستمتع بنجاح غير مسبوق من خلال التنبؤ والاستفادة من أخطاء الآخرين.
بما أنّ كل هذه الأنشطة تُجمع لتصل إلى الصفر، فالكلفة أو الفائدة الاجتماعية لشركة رينيسانس يجب أن تُبحث لا في أنشطة الشركة نفسها، بل في ما فعله المشاركون فيها بالأموال التي كسبوها. ابتعد سيمونز عن إدارة الشركة في 2010 ليركّز على العمل الخيري. تبرع بمبلغ بين 4 مليارات و6 مليارات دولار لقضايا تركز على العلوم والرياضيات، كما قدَّم أكبر تبرع غير مشروط على الإطلاق لجامعة، قدره 500 مليون دولار لجامعة ستوني برووك. وكان أيضاً مانحاً مهماً للحزب الديمقراطي. وقد تزداد الأعمال الخيرية باسمه في المستقبل، فصافي ثروته عند وفاته بلغ 31.4 مليار دولار. بالطبع، كان بإمكان أطباء الأسنان أيضاً فعل شيءٍ بأرباحهم، لو حققوا أي أرباح، لذا من الصعب، كما تعلم، تحديد العواقب الإجمالية على بقية البشرية.
لكنّ الميزانية العامة لشركة رينيسانس ليست كلها حول سيمونز. أحد الرجلين اللذين توليا منصب الرئيس التنفيذي المشارك عند تقاعده، روبرت ميرسر، كان داعماً مدى الحياة للقضايا الليبرتارية. لا يتحدث كثيراً ولا يشرح نفسه، لكن كتاب زوكرمان (The Man Who Solved the Market) يصوره عبقرياً في مجاله ولكن يتوازن ذلك مع غبائه في سياسته التبسيطية الداعية إلى وقف وتفكيك الدولة. عيّن ميرسر ستيف بانون مرشداً سياسياً له. قام وابنته الناشطة، ريبيكا، بناءً على نصيحة من بانون، بدعم بريتبارت نيوز اليمينية المتطرفة، وشركة تحليلات البيانات كامبريدج أناليتيكا. والأهم من ذلك، أنّه تبرع بالكثير من الأموال لدونالد ترَمب وقد وُصِف بأهم ملياردير داعم لترَمب. «وضعت عائلة ميرسر الأساس لثورة ترَمب»، بحسب بانون الأدرى بهذه الأمور. «لا شك، حين تنظر إلى المانحين خلال السنوات الأربع الماضية، فقد كان للعائلة أكبر تأثير على الإطلاق». شجع ميرسر ترَمب على توظيف بانون، واضطلع في تحديد نبرة إدارته الأولى. وكما قال زميله في رينيسانس، ديفيد ماجيرمان، «أحاط ميرسر رئيسنا بأشخاصه، ولأشخاصه تأثير كبير في إدارة بلدنا، ببساطة لأنّ روبرت ميرسر دفع ثمن مقاعدهم».
لست أدري إذا كان هذا نوعاً من السخرية. لعله أكثر كآبة من أن يكون كذلك. لكن الحقيقة أنّ الأثر الرئيس لجيم سيمونز، الرجل الحصيف والشخص الطيب، كان تأمين ما يكفي من المال لزميله في رينيسانس ليتمكن من جعل دونالد ترَمب رئيساً للولايات المتحدة. هذا كله مجرد نتيجة لماهية النظام المالي الحديث ودوره المفرط بشكل بشع في حياتنا اليوم. من السهل تشخيص مظاهر الانحلال في مجتمع بعيد تاريخياً وجغرافياً عنا. ولكن من الصعب رؤية ذلك عن قرب.
نُشِرت هذه المراجعة في London Review of Books في 12 أيلول/سبتمبر 2024، وتُرجِمت إلى العربية ونُشِرت في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.
- 1
طُرِحَت هذه الفرضية في نظرية في العام 2007 وأكدها فرانتيشك بارتوش من جامعة أمستردام ومعه 49 من زملائه رموا قطعة نقدية 350757 مرة.