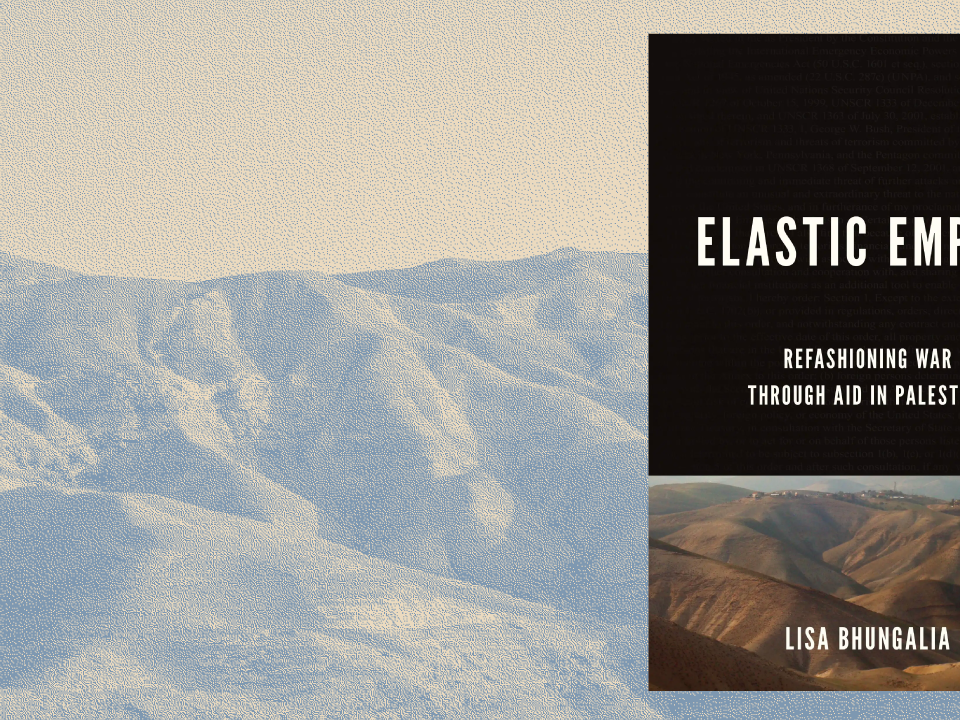الشروط السياسية لنظام عالمي جديد
الرأسمالية لن تقود حتماً إلى الاشتراكية والشيوعية، لكن من المؤكد تماماً أنّها، وبانتظام مُقلِق، تقود إلى الحرب والحرب الأهلية.
عجزنا السياسي الحالي هو نتيجة مباشرة لاستبعاد الحرب والحرب الأهلية من النظرية النقدية الناتجة هي نفسها عن استبعاد آخر هو استبعاد الصراع الطبقي والثورة. وطرح مشكلة الحرب اليوم يعني طرح مشكلة السوق العالمية.
المعلم: «بني، فكِّر في مصدر كل هذه الهدايا. لا يمكنك أن تحصل عليها من نفسك».
الطفل: «حصلت عليها من والدي».
المعلم: «ومن أين حصل عليها والدك؟»
الطفل: «من جدي».
المعلم: «طيب، من أين حصل عليها جدك؟»
الطفل: «لقد أخذها».
ماركس، رأس المال
إنّ عجزنا السياسي الحالي هو نتيجة مباشرة لاستبعاد الحرب والحرب الأهلية من النظرية النقدية الناتجة هي نفسها عن استبعاد آخر هو استبعاد الصراع الطبقي والثورة. وطرح مشكلة الحرب اليوم يعني طرح مشكلة السوق العالمية.
حينما تعود الحروب والحروب الأهلية والإبادة الجماعية والفاشية لتتصدّر العناوين ومعها، للمفارقة، استحالة الثورة، نجد أنفسنا عاجزين، لأنّ هذه الظواهر، على الرغم من كونها نتيجة واضحة للإنتاج الرأسمالي، تستعصي على التفسير في إطار مقولات نقد الاقتصاد السياسي. ما العلاقة بين الحروب وبين الرأسمالية وإنتاجها؟ أهي حوادث عرضية في مسار تطوّرها أم عناصر بنيوية؟ وعلاوة على ذلك: ما العلاقة بين الدولة، صاحبة سلطة إعلان الحرب وإدارتها، وبين رأس المال؟ وهل لا يزال مفهوم الإنتاج الذي يهمِّش الدولة وسيادتها صالحاً؟ وهل لنا أن نستمر في اعتبار الدولة مجرّد عنصر تابع وخاضع لاحتياجات تراكم رأس المال؟
في مقال سابق، رأينا كيف اقترن تأكيد السيادة الأميركية بدور عرّفناه على عجل بأنّه خضوع الدولة للتمويل. في الواقع، لا يمكن للسلطة السيادية، وأعلى تجلياتها الحرب، أن تظهر من دون سلطان التمويل، والاحتكار الاقتصادي للأخير لا يمكن أن يستمر من دون الاحتكار السياسي-العسكري للسلطة التي تعزّز وتفرض الدولرة، وهو شرط لا غنى عنه لوجود الدولة الأميركية والتمويل معاً. إذ تتشابك السلطتين الاقتصادية والسياسية - وأؤكّد هنا أنّ مصطلح «السياسية» يعني العسكرية أيضاً - في علاقة متبادلة يفترض كل طرف منها الطرف الآخر، بيد أنّه في مراحل كالتي نمر بها الآن، تتقدّم السياسة وقوتها العسكرية على غيرها، وإنْ ظلت مسألة الهيمنة الاقتصادية حاسمة في القرار السيادي بشن الحرب. وفي مجتمعاتنا، ترتبط الأفعال الاقتصادية والعسكرية-السياسية ارتباطاً وثيقاً، وتشكّلان معاً «آلة دولة-رأس مال» واحدة، لا يكون فيها رأس المال مجرد أداة خاضعة للدولة. تسعى الدولة ورأس المال إلى أهداف متمايزة لكنها متلاقية؛ إذ تغذّي زيادة سلطة الدولة وتعاظم أرباح رأس المال أحدهما الآخر.
ليس صحيحاً أنّ السياسة قد اختفت أو أنّ الدولة قد انسحبت؛ فالدولة والسياسة هما جزء لا يتجزأ من الآلة التي يعمل فيها تراكم الربح والسلطة جنباً إلى جنب
ليس صحيحاً أنّ السياسة قد اختفت أو أنّ الدولة قد انسحبت؛ فالدولة والسياسة هما جزء لا يتجزأ من الآلة التي يعمل فيها تراكم الربح والسلطة جنباً إلى جنب. لقد كانت مفاهيم السلطة والدولة وحقائقهما محور اهتمام النظرية النقدية منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم. ومن بين الأهداف التي سعت إليها هذه النظرية نقد مفهوم السيادة، والسعي لتجاوز التفسير الماركسي الذي يماهي بين السلطة والإنتاج ويختزل الدولة إلى مجرد تابع أو خادم لسيرورات تراكم القيمة.
بحلول نهاية سبعينيات القرن الماضي، بدا أنّ مفهوم «فن إدارة الحكم» لدى فوكو، أي مجموعة التقنيات العقابية والسياسية الحيوية والرقابية والرعوية، قد حقّق هذا الهدف؛ إذ لم يكتفِ باستنزاف السلطة السيادية وتهميشها، بل ادّعى اشتماله على العلاقات التي تفسر آليات عمل السلطة في المجتمعات المعاصرة، مقدّماً إياها بوصفها غير قابلة للاختزال في عمليتي الإنتاج والدولة. أما أغامبين، فقد صحّح بعد بضع سنوات هذا التصوّر النظري والسياسي الذي يُقصي السيادة، من خلال دمجه فن إدارة الحكم مع السلطة السيادية، والسلطة الحيوية مع الدولة، لكنه جعل هذه المقولات حقائق عابرة للتاريخ، وثوابت لا يغيّرها الزمن. كلاهما يستثني الرأسمالية ودينامياتها وتناقضاتها، سواء عبر تبنّي «لاهوت اقتصادي» مستمدّ من آباء الكنيسة الكاثوليكية كبديل فعّال لنقد الاقتصاد السياسي، وهو أمر مثير للسخرية، أو عبر اختصار عمل الرأسمالية بالفصول الأولى من كتاب رأس المال التي استخدمها فوكو بإيجاز لتفسير آليّات العقاب.
باختصار، أطروحتي بسيطة: يجب دمج الدولة وسيادتها، بما في ذلك احتكارها للعنف الذي يتجلّى بالكامل في الحرب، إلى جانب سلطتها الإدارية، مع مفهومَي رأس المال والإنتاج الماركسيان. دعونا نحاول توضيح هذه العلاقة بدقة أكبر، وهي العلاقة التي تغيب عن فوكو وأغامبين، لكنها تشكّل أساس الوضع الراهن. يمكننا مقاربة المشكلة من خلال السؤال: كيف نعرّف الوضع الذي أفرزته الأزمة المالية لعام 2007-2008؟ يُعزى شرط نفيه إلى نهاية النيوليبرالية وزوال طريقتها في إدارة الحكم، ما يعني إخضاع التقنيات العقابية والسياسية الحيوية والرعوية لاحتياجات نظام الحرب صاحب السلطة في استخدامها أو تعليقها أو ببساطة قمعها.
لقد تسيّدت طوال الأربعين عاماً الماضية أيديولوجيا - ولا يمكن وصفها بغير ذلك - مفادها أنّ الاقتصاد يمكن تنظيمه من خلال السوق والمنافسة، حتى وإن عرّفتهما قانونياً ونشطتهما دولةٌ تتدخّل بشدة وتكرار على غرار الدولة الكينزية كما يدعي الألمان من أتباع الليبرالية المنظّمة. وقد منحها الفكر النقدي المصداقية عن طريق الاعتراف بأنّ السوق والمنافسة تعكسان شيئاً حقيقياً. غير أن فرنان بروديل، وهو الذي لم يكن ماركسياً، علّمنا أنّ الرأسمالية «كانت دائماً احتكارية»، وأنّ المنافسة تُستخدم للقضاء على المنافسين، وأنّ السوق في ظل الرأسمالية لا وجود لها، لأنّها عبارة عن «سوق مضادة» تسيطر عليها قلّة من الفاعلين تقودهم المنافسة دائماً وحكماً نحو الاحتكار.
الرأسمالية «كانت دائماً احتكارية»، وأنّ المنافسة تُستخدم للقضاء على المنافسين، وأنّ السوق في ظل الرأسمالية لا وجود لها، لأنّها عبارة عن «سوق مضادة» تسيطر عليها قلّة من الفاعلين تقودهم المنافسة دائماً وحكماً نحو الاحتكار
ذكر بروديل أن للرأسماليين «ألف طريقة لتحريف قواعد اللعبة لصالحهم، من خلال الائتمان، والعملات، والسلطة السياسية، وغير ذلك. مَن قد يشكّ في أنّهم يملكون احتكارات أو ببساطة القدرة على القضاء على المنافسة في تسع مرات من أصل عشر؟». بالتأكيد، سوف يشك بذلك أتباع الليبرالية المنظّمة والنيوليبرالية وفوكو وداردو ولاڨال، وكل تلاميذ الفيلسوف الفرنسي أو معجبيه، والإعلام والساسة، والقائمة تطول.
كيف لنا أن نفسّر حقيقة أنّ نهاية الحوكمة النيوليبرالية القائمة على السوق قد تركتنا أمام أكبر تركّز احتكاري في تاريخ الرأسمالية، بل في تاريخ البشرية؟ (راجع.ي مقالي السابق). نستطيع تفسير ذلك ببساطة من واقع أنّ المركزة الاقتصادية (شأنها شأن المركزة السياسية) لم تتوقّف قط. في الواقع، تسارعت هذه المركزة بشدة في ظل النيوليبرالية، متخفية وراء أيديولوجيا السوق والمنافسة. يخبرنا بروديل أن السوق والرأسمالية ليستا الشيء نفسه، والخلط بينهما تسبّب – ولا يزال – في ارتباك هائل. وبالمثل، فإن الخلط بين الرأسمالية والنيوليبرالية خطأ فادح.
لفهم الوضع الراهن، يجب أن نأخذ في الحسبان شبكة معقّدة من الأحداث: الأزمة المالية والشعبويات والفاشيات الجديدة والحروب الأهلية والحروب والإبادات الجماعية. كان جيوفاني أريغي ليصف هذه الفترة بأنّها «مرحلة انتقال هيمنة» أو «فوضى نظامية». وبصيغة أدقّ، يمكننا القول إنّ المرحلة السياسية التي افتتحتها الأزمة المالية للعام 2007-2008، وتُمثّل نهاية «الدورات الهيمنية» (بروديل، والرشتاين، أريغي)، تحمل سمات «التراكم البدائي» لكارل ماركس و«حالة الاستثناء» لكارل شميت. وهكذا نجد أنفسنا أمام نسخة «كارلَيْن» [ماركس وشميت – المترجم] تختلف عن نسخة ماريو ترونتي، ولكنّها أكثر قابلية للتطبيق.
ملاحظتان في هذا الصدد: لفهم صورة رأس المال وعلاقته بالسيادة التي تؤدّي دوراً حاسماً في خلال هذه الفترة، لن نبدأ من بداية الكتاب الأول من «رأس المال» بل من نهايته، أي من التراكم البدائي. وصف ماركس هذه المرحلة بأنّها مرحلة تشكيل الطبقات والدولة المطلقة داخلياً من خلال ممارسة العنف الهائل المتمثل في الحروب والحروب الأهلية وحروب الغزو والإبادات الجماعية. اعتقد الثوري الألماني خطأًً أنّه بمجرد أن يرسّخ الإنتاج الرأسمالي نفسه، سيعيد إنتاج شروط وجوده. هذا صحيح لكن بنطاق محدود، إذ يعيد إنتاج شروطه ضمن أسلوب معين من التراكم إلى حين يدخل هذا الأسلوب في أزمة، أو خاطئ لأنّ الانتقال من أسلوب تراكم إلى آخر - على سبيل المثال، من الفوردية إلى النيوليبرالية – لم ينشأ بشكل تلقائي أو جوهري من الإنتاج والاستهلاك الفوردي ومن الدولة الكينزية. بل كان على آلة الدولة-رأس المال أن تمرّ بتنظيم قطيعة، انقطاع تمثّل في العقد الممتدّ بين عامي 1969 و1979، وشمل تدخّل السلطة السيادية واستخدام القوة المسلّحة عند الضرورة. فما يحدّد التكوين الجديد لعلاقات رأس المال وعلاقات القوّة وشكل الدولة ليس الدولة فحسب، أي الحرب والانقلابات والثورات وصراع الطبقات ونتائجها، إنّما السياسي. فالتقسيم الأول للعمل دائماً سياسي، وليس اقتصادياً، إذ عليه أن ينتج الطرف المُهيمن والطرف المُهيمن عليه، وأن يفصل بين المالك وغير المالك. الملكية الخاصة افتراض مُسبق لرأس المال، وهي مؤسّسة لم يخلقها ولم يضمنها رأس المال نفسه، بل الدولة. أما تنظيم الإنتاج والتقسيم الفعلي للعمل، كما قُدّم في «رأس المال»، فيظهر لاحقاً لتطبيع علاقات القوة التي حدّدتها الصراعات السياسية بين الطبقات.
تتعلّق الملاحظة الثانية بمفهوم حالة الاستثناء الذي يتيح تعليق القواعد القانونية والإنتاجية والديمقراطية، ما يترك الدولة واستخدام القوة والحرب لتسيطر وتقرّر. لكن وعلى عكس رأي أغامبين، يجب التمييز بين حالة الاستثناء وحالة الطوارئ. قانون باتريوت الذي أصدره بوش أو الإجراءات التي فرضتها الدول أثناء جائحة كوفيد هي أمثلة على حالات الطوارئ. نحن نحتفظ بمفهوم حالة الاستثناء لفترات تشهد قطيعة جذرية تمثّل انتقالاً من نظام اقتصادي وسياسي عالمي إلى آخر: كالثورة الفرنسية التي أنهت النظام القديم (الإقطاعي)، والحربين العالميتين اللتين كانتا في الواقع حرباً أهلية عالمية طويلة، وضمن هذه الصراعات، الثورات السوفياتية، أو الصينية، التي أسّست معاً نظاماً عالمياً جديداً: الحرب الباردة. شهدت سبعينيات القرن الماضي مرحلة الانتقال من الفوردية إلى النيوليبرالية غير المحدّدة بوضوح، وبالمثل تبشّر الحالة الراهنة بنهاية الأخيرة وبـ«الجديد» الذي سينبثق من هذا الصراع القائم.
شهدت سبعينيات القرن الماضي مرحلة الانتقال من الفوردية إلى النيوليبرالية غير المحدّدة بوضوح، وبالمثل تبشّر الحالة الراهنة بنهاية الأخيرة وبـ«الجديد» الذي سينبثق من هذا الصراع القائم
ربما يكون من الأدق اعتماد أحد مفاهيم شميت كتكملة للتراكم البدائي: «ناموس الأرض»، وهو حدث تاريخي تُنتج فيه الفتوحات والحروب وعمليات الاستحواذ، كالتراكم البدائي عند ماركس، نظاماً جديداً وسلطة جديدة. لا يحتاج هذا الحدث إلى قواعد فورية، إذ ستوضَع لاحقاً. الناموس حدث ومكان ولحظة انقطاع تُحسم فيها، من خلال ممارسة القوّة، ملامح الدولة والطبقات الاجتماعية وعلاقات القوّة. ومن دون التراكم البدائي، أي من دون رأس المال، كان ناموس الأرض ليكون مجرّد حدث سياسي تاريخي، بينما أصبح منذ أواخر القرن التاسع عشر، بل ومنذ الثورة الفرنسية، اقتصادياً وسياسياً متواشجاً. وهذا أمر يدركه شميت تماماً، إذ يرى في الصراع الطبقي الذي أصبح غير قابل للتجاوز منذ القطيعة التي حدثت بين عامي 1830 و1848، السبب الرئيس لنهاية الدولة كما تمنّاها، أي دولة مستقلة عن «المجتمع».
لا يولد القانون في منطقة اللامبالاة بين «الداخل والخارج» التي تُحدِثها حالة تعليق النظام القانوني كما يزعم أغامبين، بل ينشأ من صراع القوى، حيث هناك منتصرون ومهزومون. وبالتالي، لا يمكن بأي حال من الأحوال تعريف معسكر الاعتقال بـ«ناموس الحداثة» أو «مصفوفته الخفية»، لأنه، على غرار حالة الطوارئ، ليس سوى جزءاً من الاستراتيجيات التي تهدم نظاماً قديماً وتؤسِّس نظاماً جديداً. تصبح حالة الطوارئ القاعدة، أي الإدارة اليومية للسلطة، وليس ناموس الأرض الذي يظل حالة استثناء. فالجائحة لا تُعرّف نظاماً عالمياً جديداً، لكن الحرب التي اندلعت مباشرة بعدها تفعل ذلك. أصيب أغامبين باضطراب كبير إبان الجائحة، ولكنه اختفى عملياً في أثناء الحرب، لأنّه يختزل ناموس الأرض إلى مشكلة تعليق النظام القانوني. ما نحتاج إلى فهمه هو أنّ «الفراغ القانوني» لحالة الاستثناء يعجّ بالقوى المتصارعة لتحقيق هيمنة اقتصادية وسياسية جديدة، أو ربما - إذا أمكن - لتحقيق ثورة مستحيلة.
في جذور كل من التراكم البدائي وحالة الاستثناء/ناموس الأرض نجد الغزو، وهو فعل استحواذ يُشكّل مصدر سلطة للدولة وربح لرأس المال. من خلال التملّك والاستحواذ تتواصل الدولة ورأس المال. هنا يخبرنا الكارلان أنّه قبل الإنتاج، يجب الاستحواذ والتملّك والمصادرة وتقسيم ما أُخِذَ بين مالكين وغير مالكين، أي الأرض والبشر والموارد ووسائل الإنتاج والثروات، إلخ... لا يخلق الإنتاج الطبقات أو مؤسّسة الملكية، ولا يمكنه تنظيم مصادرة وسائل الإنتاج والموارد اللازمة لذلك، بل يفترض مسبقاً فعل الاستحواذ والمصادرة والتقسيم بين مالكين وغير مالكين، بين مهيمنين ومهيمن عليهم. ولممارسة العنف الهائل اللازم للاستحواذ والتقسيم، يصبح استخدام القوة والحرب والحرب الأهلية أمراً حاسماً. إذ لا بد من الاستحواذ والتقسيم حتى قبل إنتاج «الحق». وفي حين يرى ماركس العنف «قوة اقتصادية بحد ذاته»، يؤكد شميت بطريقة مبهمة أنّه يتحوّل إلى قوة قانونية، وأقول مبهمة لأنّ حالة الاستثناء الحقيقية – ثورة أو نظام عالمي جديد أو حرب أهلية، إلخ – لا يمكن أن تكون لحظة مُنضبطة بالقانون، إذ يعترف الأخير بالعنف لإنقاذ نفسه والدولة من خلال إدماجه في النظام. لكن يظل واقع ناموس الأرض الجديد ينطوي على قوة تصبح في آن واحد قوة اقتصادية وقانونية جديدة.
في التراكم البدائي الذي وصفه ماركس، كما في كتاباته التاريخية-السياسية، نجد الكثير من التشابهات مع وضعنا الحالي مع تعديل ما يلزم: تعدّدية في الفاعلين، من خاطفين وتجّار عبيد ومغامرين وقراصنة وأصحاب ريع ورجال مال ورأسماليين وفلاحين وجنود وتجار، إلخ… تعددية في أنماط الإنتاج والاستغلال، من عبودية وعمل مُقيّد وعمل مأجور واستغلال مالي وائتماني، إلخ… وتعدّدية في أشكال العنف، من إبادة الشعوب الأصلية ومصادرة الأراضي المشتركة في أوروبا والأراضي «الحرة» في العالم الجديد وحروب الغزو والإخضاع والحروب الأهلية والحروب الإمبريالية البينية، إلخ... في هذه المرحلة المليئة بالعنف، تؤدّي الدولة الدور المركزي، بمعنى أن «البرجوازية الناشئة لا يمكنها الاستغناء عن تدخلها المستمرّ» و«جميع أساليب التراكم البدائي تستغل بلا استثناء، سلطة الدولة»، ولا يقتصر دورها على الدور العسكري بصفتها محتكر القوة أو «الوحشية»، كما يقول ماركس، بل تؤدّي دوراً اقتصادياً أيضاً بصفتها مديرة الائتمان والدين العام، ودوراً سياسياً تشريعياً قادرة على سنّ قوانين خاصة، أي «تشريعات دموية» ضدّ الفلاحين الذين ألقتهم المصادرة إلى التسوّل.
يحتوي الفصل الرابع والعشرون على تأكيد ماركسي مهم يجب مدّه إلى واقعنا الحالي: الدولة تُعجّل، بعنف، الانتقال من نظام إلى آخر (في هذه الحالة، من الإقطاع إلى الرأسمالية)، مُختصرةً مرحلة الانتقال باستعمال القوة.
يُحدث تطوّر الرأسمالية تغييراً جذرياً في العلاقة بين الدولة ورأس المال. وعلى الرغم من أنّ هذه العلاقة قامت دائماً على الاعتماد المتبادل، فإنّه منذ أواخر القرن التاسع عشر، وخصوصاً مطلع القرن العشرين، تضاءلت الاستقلالية النسبية للدولة عن الاقتصاد وفقاً لبولانتزاس، والاقتصاد عن الدولة، لتندمج هاتان الحقيقتان في آلة واحدة ذات رأسين.
ما نحتاج إلى فهمه هو أنّ «الفراغ القانوني» لحالة الاستثناء يعجّ بالقوى المتصارعة لتحقيق هيمنة اقتصادية وسياسية جديدة، أو ربما - إذا أمكن - لتحقيق ثورة مستحيلة
ولادة النيوليبرالية وموتها
التعريف الذي قدمناه للوضع الحالي، أي التراكم البدائي وحالة الاستثناء، يتيح لنا تبديد أي غموض أو التباس أثارته فكرة النيوليبرالية. ويمكننا ربّما من خلال تجربة مولدها وتدهورها السريع استخلاص بعض الدروس المتعلّقة بالظروف التي نمرّ بها حالياً.
بحكم سني عشتُ ورأيت التناوب بين مراحل الحُكم العقلاني ولحظات انفجار عنف التراكم البدائي وحالة الاستثناء. فقد فرضت الحربان العالميتان ناموساً جديداً للأرض: هيمنة أميركية في الغرب، وهيمنة سوفياتية في الشرق. استقرّت علاقات قوة غير مسبوقة وطُبّعت في الشمال العالمي عبر طريقة في إدارة الحُكم تراوحت بين الكينزية والاجتماعية الديمقراطية. دخلت آلة الدولة-رأس المال الأميركية في أزمة بنهاية الستينيات، لتُطلق على الفور عملية تراكم بدائي وحالة استثناء جديدة اجتاحت الكوكب من العام 1969 إلى العام 1979، مُحدثة الانتقال من الفوردية إلى ما بعدها. مهّد الانتصار الذي حقّقته آلة الدولة-رأس المال في ذلك العقد الطريق لنمط جديد من إدارة الحُكم، النيوليبرالية، رافق تراكماً متمحوراً بشأن الائتمان والتمويل، إلى أن انهار هذا الأخير بدوره في العام 2008. وقد وسمت نهايته سلسلة من الأزمات المالية والشعبويات والحروب والإبادات الجماعية. نجد أنفسنا الآن غارقين في العنف الهائل الذي يميز لحظات تشكيل نظام جديد، إنْ كُتِب للقوى العظمى النجاح، وهو أمر غير مضمون بالمرة!.
لنلقِ نظرة أعمق على ما حدث في العقد الممتدّ بين عامي 1969 و1979، فهذا يمنحنا فهماً أوضح لشكل ووظيفة كل من التراكم البدائي وناموس الأرض في نشأة العولمة الجديدة التي بدأت في الثمانينيات وتتفكّك الآن أمام أعيننا. أجبر الحراك العالمي للصراعات الذي بلغ ذروته في العام 1968، آلة الدولة-رأس المال الأميركية على تغيير استراتيجيتها السياسية، إذ سعت، في البداية عبر التجربة والخطأ، ثم بدرجة متزايدة من الوضوح، إلى تعيين شكل جديد للتراكم. بدأ هذا بإلحاق الهزيمة بالتركيبة الطبقية وإعادة تشكيلها، عبر بناء دولة تمثل نقداً عملياً للدولة الكينزية، بعدما نجحت الجماهير، بفضل إنجازات القرن العشرين، في اقتطاع مساحات من القوّة المضادة داخلها. ولم يكن العمل التدميري ممكناً إلّا حيث كانت الذات السياسية أقوى: في الجنوب العالمي. قادت الولايات المتحدة، بزعامة كيسنجر، سلسلة انقلابية نموذجية في أميركا الجنوبية باستخدام عسكريين فاشيين. وتتجلّى قدرة الدولة على إعلان الحرب الأهلية وفرض حالة الاستثناء والاستعانة بالفاشيين حتى في ظل الرأسمالية الناضجة، من خلال ممارسة الحق في القتل والعفو على آلاف الشيوعيين والاشتراكيين. أمّا في الشمال، فكان اندماج الطبقة العاملة النسبي في النظام، عبر الأجور والاستهلاك، يتطلّب مجرد هزيمة سياسية (ريغان وتاتشر). جرى تعليق المعايير القانونية والإنتاجية والاجتماعية والتقنية الحاكمة منذ ما بعد الحرب العالمية الثانية حتى العام 1968. ومن دون المساس بالدستور الشكلي أو القانون، قُلب الدستور المادي وتغيّر بعمق. تغيّرت موازين القوى جذرياً لصالح رأس المال، فتهيّأت ظروف لتغييرات فعلية في المعايير القانونية والإنتاجية، وتقنيات السلطة لم تنشأ بطبيعتها من الإنتاج الفوردي والدولة الكينزية، بل فرضتها القوة المسلّحة للفاشية والقوة السياسية للدولة. ركّز العنف بالأساس على سيرورات تشكيل الذات الثورية. فلا يمكن فرض معايير جديدة في حالة «الفوضى» الناجمة عن صراع طبقي متصاعد، كما في أميركا اللاتينية. لفرضها، يجب أولاً إنشاء نظام على مستوى الذوات؛ إذ لا يمكن إلّا للذوات المهزومة أن تتبنّى سلوكيات جديدة وطرق عمل مبتكرة وأساليب إعادة إنتاج مختلفة.
كان للدولة في سبعينيات القرن العشرين، كما في مفهوم ماركس عن التراكم البدائي، الدور الحاسم في فرض الانتقال العنيف من نظام سياسي-اقتصادي إلى آخر، مع تسريع هذه المرحلة الانتقالية باستخدام القوة. لم يكن الرأسماليون هم مَن قصفوا مقر إقامة ألليندي الرئاسي في السبعينيات أو اعتقلوا وعذبوا الآلاف من المناضلين الاشتراكيين والشيوعيين، أو اغتالوا أعضاء الفهود السود ونظموا استراتيجية التوتر في إيطاليا، بل الدولة هي التي قامت بذلك. لكن بمجرد تحقيق النصر على الثورة، جلس الاقتصاديون النيوليبراليون جنباً إلى جنب مع العسكريين الفاشيين في حكومات أميركا الجنوبية. ولن يتمكّن النيوليبراليون من الانفراد بالحكم، فارضين معايير وسلوكيات جديدة، إلّا بعد تطبيع «الوضع» الذي أوجدته الانقلابات. «السيّد ـ كما يذكّرنا شميت ـ هو مَن يقرر بشكل نهائي ما إذا كانت الحالة الطبيعية قد عادت فعلاً». وبعد استعادة قيادة آلة الدولة-رأس المال، يُطبّع الوضع الجديد عبر بناء إجماع جديد للمنتصرين، يرتكز على اقتصاد الديون والاستهلاك بالائتمان بدلاً من الأجور والرعاية الاجتماعية.
سوف تكون النتيجة السياسية الأهم للتراكم البدائي الجديد وحالة الاستثناء، كما هو الحال دائماً في الرأسمالية، إعادة تشكيل الملكية الخاصة التي لم تعد ترتكز على الرأسمالية الصناعية بل على التمويل. أصبح المبدأ الجديد لتوزيع الثروة لا يضع المنتجين في مركزه، بل حملة الأسهم والسندات والأصول المالية.
لا تتدخّل النيوليبرالية كفن لإدارة الحكم للعلاقات الطبقية الجديدة إلّا بعد أن تزرع آلة الدولة-رأس المال الموت السياسي. وحينها فحسب تتولّى السلطة الحيوية (العقابات والسياسات الحيوية والسلطة الرعوية) مهمة «إدارة الحياة» للذوات المهزومة، لتحكم وجودها الخاضع والمُذعن. لا يستند نموذج فوكو للسلطة (السلطة الحيوية) إلى عنف الدولة أو سيادتها، بل إلى الاقتصاد. لكن، هل ما زال صحيحاً أنّ الرأسمالية والاقتصاد يتطابقان؟ فالرأسمالية المعاصرة التي تتجلّى بأكمل صورها في الافتراس المالي والعنف الهائل لتملّك التراكم البدائي والحرب الطبقية بين المالكين وغير المالكين، لم تعد تشبه كثيراً اقتصاداً يُفترض أنّ البشر فيه، المجهّزين أنثروبولوجياً للتبادل وتجنّب القتال المسلّح، يفضّلون التنافس في الإنتاج والتجارة وفق قوانين الاقتصاد السياسي الاسكتلندي المعقّمة. تأخذ السلطة الحيوية هذه الصورة المسالمة للمنافسة والسوق: هدفها ليس القمع، بل التشجيع والتحفيز وإثارة نشاط المحكومين؛ فهي تعمل لا من أجل الحرب، بل من أجل السلام. ونموذجها هو السلطة الرعوية التي لا تعرف العنف ولا الأعداء: «الوظيفة الأساسية للسلطة الرعوية ليست إيذاء الأعداء، بل فعل الخير لمَن ترعاهم. فعل الخير بالمعنى المادي للكلمة، أي: تغذيتهم وتقديم القوت لهم».
هذه الأيديولوجيا الحقيقية التي تعارض فن إدارة الحكم السياسي الحيوي بالسلطة السيادية عبر محو المتصارعين في حرب الطبقات (سواء قوة آلة الدولة-رأس المال أو قوة الثورة)، تسلّلت إلى عمق الفكر النقدي، كما يظهر مثلاً في ما يسمّى بـ«النظرية الإيطالية» المدينة لمفاهيم فن إدارة الحكم والسلطة الحيوية. يتبنّى كلّ من أغامبين ونيغري وإسبوزيتو هذه المقولات بطرائق مختلفة، لكنّهم يبدون غير واعين بأن افتراضاتها لدى فوكو تستند إلى التخلّي عن الحرب الأهلية (الحرب الطبقية) كنموذج للعلاقات الاجتماعية. لم تعد علاقة القوة قانونية أو حربية، بل حكومية، ولا يمكن العثور عليها في العقد أو العنف أو النضال. فالعلاقة بين الصديق والعدو التي فرضتها الثورة العالمية الناتجة عن انهيار الاتحاد السوفياتي واستمرّت حتى الستينيات والسبعينيات أصبحت علاقة بريئة سلمية وتوافقية بين الحكّام والمحكومين: تقلّص الهجوم على السماء إلى مجرّد «رفض الحكم» بهذه الطريقة أو تلك. لقد بات المفهوم الجديد للسلطة الذي قدّمه فوكو عديم الفائدة مقارنة بممارستها الحالية في الغرب الرأسمالي.
تعود العلاقة الحربية التي لم تختفِ مُطلقاً بل شكّلت أساس فن إدارة الحكم، إلى الظهور بكل عنفها حين يعجز الأخير عن التعامل مع تناقضات الرأسمالية. وإغفال هذه العلاقة هو السبب الجوهري لفشل جميع هذه النظريات التي تعجز عن التنبؤ بالحرب والحرب الأهلية والإبادة الجماعية، أو قل تعجز عن فهم طبيعة الرأسمالية.
لقد أُبيدت الليبرالية الكلاسيكية مع الحرب العالمية الأولى، لكن الرأسمالية واصلت إعادة إنتاج نفسها، متحالفة مع الفاشية والنازية. اليوم، ماتت النيوليبرالية، لكن الرأسمالية تستمرّ عبر الحرب والحرب الأهلية وتجديد تحالفاتها مع فاشيات جديدة، متخذة من عنف الإبادة الجماعية وجهاً لها
تمزّقت هذه السرديات التسكينية بفعل أزمة الاقتصاد ذاته، الأساس الذي تقوم عليه السلطة الحيوية. ما لم يتراجع قط عاد ليظهر بكل قوته الرهيبة: السلطة السيادية على الحياة والموت، في إشارة إلى أنّ تراكماً بدائياً جديداً يُحضّر لتهيئة الظروف السياسية لنظام عالمي جديد. لقد أُبيدت الليبرالية الكلاسيكية مع الحرب العالمية الأولى، لكن الرأسمالية واصلت إعادة إنتاج نفسها، متحالفة مع الفاشية والنازية. اليوم، ماتت النيوليبرالية، لكن الرأسمالية تستمرّ عبر الحرب والحرب الأهلية وتجديد تحالفاتها مع فاشيات جديدة، متخذة من عنف الإبادة الجماعية وجهاً لها.
مفهوم جديد عن الإنتاج؟
ممّا تقدّم، يمكننا أن نستنتج أن التراكم البدائي وعنفه الهائل، شأنه شأن حالة الاستثناء أو ناموس الأرض، وقبل كل شيء الصراع الطبقي، يجب أن يكونا جزءاً لا يتجزّأ من مفهوم الإنتاج، وأن يشكِّلا المقدمات التي تحدّد شكله في كل حالة. وبهذا، نتحرّر نهائياً من الالتباسات والقيود، بما فيها الماركسية، لمفهوم الإنتاج التي كثيراً ما تعرّض أتباعها لخطر الوقوع في اقتصادوية محرجة. فالعنف والحرب والحرب الأهلية والإبادة الجماعية ليست طارئاً في سيرورة تراكم رأس المال، بل عناصر بنيوية فيها ومؤسِّسة لها.
جرت في الستينيات والسبعينيات من القرن الماضي محاولات عدّة لتوسيع مفهوم الإنتاج وإثرائه، في محاولة لتجاوز القيود الاقتصادوية للماركسية في ذلك الوقت: الاقتصاد الليبيدي (ليوتار) واقتصاد التأثير (كلوسوفسكي) وخطاب الرأسمالي (لاكان) الإنتاج الرغبوي (دولوز وغواتاري) والسياسة الحيوية (فوكو) والأنطولوجيا السبينوزية للوجود كإنتاج (نيغري). تبدو جميع هذه النظريات وكأنّها خطوة للأمام من الناحية النظرية، بحكم أنّ الرأسمالية تعمل أيضاً من خلال الرغبات والتأثيرات، لكن من الناحية السياسية، يبدو أنّها تتراجع خطوتين أو أكثر، إذ ساهمت في تسكين الرأسمالية من خلال فصل الإنتاج عن الحروب وجذرية الصراعات الطبقية.
وُلدت الرأسمالية من عنف هائل ومجازر وإبادة جماعية ومصادرات وحروب وعبودية. فآلة الدولة-رأس المال تجدّد نفسها وتعيد إنتاج نفسها وتفرض نفسها من خلال همجية تنمو باطراد عبر القرون، بما يتناسب مع تطور القوى الإنتاجية للعمل والتكنولوجيا التي إذا لم تُوجه نحو التحرّر من خلال الثورات فإنّها تنحو نحو تدمير ليس رأس المال المتغيّر أو الثابت وحده، كما يعتقد ماركس في نظرية الأزمة، بل تدمير النوع البشري وعالمه أيضاً.
إنّ الغضب الدموي الذي يسيطر على حكامنا ليس سمة نفسية، ولا مرضاً عقلياً، ولا أمراً جديداً، بل أمرٌ يتكرر بانتظام مثير للدهشة، وما استبعاده من تعريف الرأسمالية ورأس المال إلا تصرّف غبي وانتحاري. إنّ تقليص الرأسمالية إلى السوق، والسلطة إلى العقاب والحكومة والسياسة الحيوية، مع الاعتقاد بأنّ هذه الأمور قد قطعت رأس اللوياثان الحديث (الذي يرفع في يد شعار السلطة السياسية وفي اليد الأخرى السلطة الاقتصادية بدلاً من الدينية)، بينما هو في الواقع لا يزال يستمر، من دون رهبة، في تحديد الحياة والموت، لهو أحد أسوأ نتائج النظرية النقدية بعد العام 1968. ويمكن التحقّق من حقيقة ممارستها المميتة بسهولة اليوم، ولكن المواجهة مع واقع الحرب الطبقية يبدو من المستحيل تحملها في الغرب الذي يشرف الآن على أفوله النهائي. يتغذّى الربح الرأسمالي وسلطة الدولة من بعضهما البعض، ولكن في الأوقات التي يستمر فيها التراكم البدائي في العمل بالتوازي مع حالة الاستثناء تهيمن بالضرورة السلطة السيادية على القتل والانتزاع والتقسيم. وهذه السلطة لم يعد يمكن مماهاتها مع الدولة وحدها، بل مع السلطة السياسية لآلة الدولة-رأس المال التي تقرّر وتوجّه الاستراتيجية. أما الوجه الآخر لهذه الحالة فهو ما يمكن تسميته من منظور المقهورين باللحظة اللينينية، أي اللحظة التي قد تصبح فيها استحالة الثورة ممكنة، بشرط، كما هو الحال دائماً، أن تكون الظروف الذاتية ملائمة.
ما الديمقراطية؟
لم تقم الديمقراطية في الغرب إلا لفترة قصيرة بفضل الصراع الطبقي وثورات القرن العشرين. ومع غياب الأخيرة، عاد الغرب إلى ما كان عليه دوماً في نظر الغرب: ديمقراطية للمالكين (ذكر ماركس أنّ الدستور الفعلي في الغرب هو الملكية)، وديمقراطية للحرب والإبادة الجماعية وديمقراطية للفاشيات.
ثمة عنصر مفقود في مفهوم ماركس عن التراكم البدائي ألا وهو الفاشية التي ظهرت في الواقع مع الإمبريالية. فالرأسمالية الاحتكارية، على عكس الرأسمالية التنافسية، «لم تعد تطور نزعة نحو الاشتراكية، بل بالأحرى نحو البربرية الفاشية»، كما أشار هانز-يورغن كراهل.
آلة الدولة-رأس المال تجدّد نفسها وتعيد إنتاج نفسها وتفرض نفسها من خلال همجية تنمو باطراد عبر القرون، بما يتناسب مع تطور القوى الإنتاجية للعمل والتكنولوجيا التي إذا لم تُوجه نحو التحرّر من خلال الثورات فإنّها تنحو نحو تدمير النوع البشري وعالمه
من أبرز سمات الفاشية التاريخية أنّها، على عكس الشيوعيين والثوريين، لا تحتاج إلى انتزاع السلطة، إذ تُقدّمها لها على طبق من فضّة الطبقات الحاكمة المذعورة من أزماتها التي تجعل، في كل مرة، إلغاء الملكية الخاصة، وهو الأساس الحقيقي الوحيد للغرب، احتمالاً واقعاً. الفاشية والنازية عنصران لا غنى عنهما لوجود آلة الدولة-رأس المال واستمرارها، حين تحشد التراكم البدائي وحالة الاستثناء.
يحدث الأمر نفسه اليوم، مع تعديل ما يلزم. تقدّم لنا «جمهورية الموز» الفرنسية مثالاً نموذجياً على ذلك. فعند إعادة انتخاب الرئيس ماكرون، لم يعد لديه غالبية وكان يحكم بالمراسيم، ما حرم البرلمان من سلطته، وهي عملية بدأت منذ الحرب العالمية الأولى ولم تزدد إلا تعمقاً!. وبعد خسارته في الانتخابات الأوروبية، كانت خطته تتمثّل في إيصال الفاشيين إلى السلطة، كما فعل أسلافه في القرن العشرين، لأنّهم الحل المثالي في أوقات الكوارث الرأسمالية: ينفّذون سياسات رأس المال كالليبراليين، ولكن بحوكمة «غير ليبرالية».
خذ مثلاً المواقف المزعومة المناهضة للنظام التي يروج لها الفاشيون الإيطاليون الذين هم بالفعل في السلطة. فما إنْ وصلوا إلى الحكم، حتى تخلّوا فوراً عن النزعة السيادية، ليصبحوا منفّذين مطيعين لأوامر أوروبا وخدماً للأطلسية، متعهّدين في الوقت ذاته ببيع «الوطن» لصناديق التقاعد الأميركية. هؤلاء الفاشيون، الوطنيون العظماء، يفتحون حدودهم لرأس المال «الأجنبي» لإفقار «الأم الحنون»، بينما يغلقونها أمام بضعة آلاف من المهاجرين أو يُرَحلونَهم إلى ألبانيا. وفي مقابل خدماتها المخلصة للسادة الأميركيين، نالت خادمتهم ميلوني مكافأتها من المجلس الأطلسي، واسمه وحده يقول كل شيء.
كما عمدت الحكومة إلى خفض الموارد المخصّصة للرعاية الصحية والمدارس العامة لتعزيز خصخصة جميع الخدمات العامة، وهي السياسة ذاتها التي تتبعها الصناديق الأميركية. وقد أفقرت البلاد، وخصوصاً المتقاعدين، ومرّرت قوانين قمعية تحدّ من الإضرابات والمظاهرات، بل وابتكرت جريمة «المقاومة السلبية» (وسمتها غاندي). ولم تفرض أي ضرائب على الأرباح الهائلة للبنوك وشركات التأمين والشركات متعددة الجنسيات في قطاعي الطاقة والصيدلة أو عمالقة التكنولوجيا الرقمية. كما شجعت التهرب الضريبي المقنن، المعروف أيضاً بـ«تحسين الضرائب»، الذي يُعد شرطاً أساسياً للرأسمالية المالية. هذا التحويل الهائل للثروة إلى جيوب أصحاب العمل استنزف الحسابات العامة، والآن يدعو الفاشيون إلى بذل «التضحيات». وفي خلال السنوات السبع المقبلة، وبعد انتقادها للتقشف حين كانت في المعارضة، تفرض ميلوني تخفيضات بقيمة 12 مليار يورو سنوياً في الإنفاق العام لتتوافق مع المعايير التي يحدّدها ميثاق الاستقرار الأوروبي الجديد (الذي انتقدته بشدة قبل وصولها إلى السلطة). في السياسة الاقتصادية والضريبية، يظهر الفاشيون ليبرالية أكثر من الليبراليين أنفسهم. أما المجال الوحيد الذي يلتزمون فيه بوعودهم الفاشية، فهو قمع كل أشكال المعارضة والاختلاف. هل لا يزال زملاؤهم الفرنسيون عاجزين عن الوصول إلى السلطة عبر الانتخابات؟ يتولى ماكرون الأمر، مقتنعاً بأنّ حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات عامة جديدة أفضل طريقة لتمهيد الطريق لهؤلاء الحلفاء «الأكثر من موثوقين»، ولكنهم دائماً ما يحتمل أن يسلكوا طريقهم الخاص، كما فعل النازيون. لكن الحظ لم يحالفه! فقد خسر الفاشيون، وكذلك خسر ماكرون، وتبيّن أنّ القوة السياسية الأولى هي اليسار. وعلى الفور رفض الرئيس الاعتراف بنتائج الانتخابات. وفي وضع يتسم بالتراكم البدائي وناموس الأرض حيث لا يُعتد إلا بالقوة، يصبح القيام بما تتطلّبه آلة الدولة-رأس المال أمراً ضرورياً. فالمعايير الديمقراطية معلّقة فعلياً وتخضع لإرادة «السيد» الديمقراطي ماكرون الذي عيّن حكومة فيها تمثيل كامل لليمين، من الجمهوريين إلى الفاشيين، أي القوى التي خرجت مهزومة من الانتخابات. لم تتشكّل الحكومة إلا بسبب امتناع الفاشيين عن التصويت الذين يمسكون بزمامها ويفتخرون بذلك علناً. كان الطريق السياسي مفتوحاً أمام السلطة الفاشية، وكل ما كان ينقصها هو المسار الاقتصادي. وها هو: على الحكومة الجديدة تغطية العجز في الميزانية الذي تركته الحكومة السابقة، المكونة من المصرفيين، والتي أنفقت بسخاء المليارات من الأموال العامة على الشركات والأثرياء. أما الآن فيجب خفض الإنفاق العام بمقدار 60 مليار يورو، وهو ما لا يمكن تحقيقه إلا بثمن التقشف بالقيمة نفسها (2% من الناتج المحلي الإجمالي) التي فرضتها أوروبا «الكريمة» على اليونان.
لم تزدهر النازية بين الحربين بسبب التضخّم، كما تروج الرواية الديمقراطية الألمانية، بل بسبب التقشف الذي فرضته أزمة العام 1929. باتت كل الشروط مهيأة لعودة الفاشيين الذين رفضهم «الشعب» في الانتخابات إلى السلطة في المستقبل القريب. هاكم الديمقراطية
لم تزدهر النازية بين الحربين بسبب التضخّم، كما تروج الرواية الديمقراطية الألمانية، بل بسبب التقشف الذي فرضته أزمة العام 1929. باتت كل الشروط مهيأة لعودة الفاشيين الذين رفضهم «الشعب» في الانتخابات إلى السلطة في المستقبل القريب. هاكم الديمقراطية!
الوضع الحالي للديمقراطيات الغربية تجسّده مفاهيم كارل شميت بشأن «الحرب العادلة» و«الحرب الأهلية المعلنة أو الكامنة»، حيث كتب: «كلاهما، وبشكل مطلق وغير مشروط، يضع الخصم خارج إطار القانون». فالإدارة الكارثية لحلف الناتو في الحرب الأوكرانية تسلب جميع الحقوق من الخصم، أي روسيا، ومن خلفها تلوح الصين، تحت ذريعة التفوّق السياسي والأخلاقي لما يُسمّى بالديمقراطيات، بما في ذلك إسرائيل! يُجرَّم الأعداء إلى حد تحويلهم إلى «غير متحضرين» و«برابرة» و«متوحشين»، وهي تعريفات تحيي ذكريات الاستعمار. تتحول العداوة إلى عداوة مطلقة في «الإيمان الهستيري بالحق المُطلق». يُطبّق الإجراء الخطابي والسياسي نفسه على «العدو الداخلي» في حرب أهلية كامنة لكنها واضحة المعالم من خلال «التشهير القانوني والعام والتمييز وقوائم الحظر العلنية أو السرية، وإعلان شخص ما عدواً للدولة أو الشعب أو الإنسانية»، بهدف قمع أي معارضة ولو ضئيلة تجاه الحرب مع روسيا أو الإبادة الجماعية للفلسطينيين. وحين لا تكفي الخطابات الإعلامية والسياسية، تتدخل الشرطة. يختصر الاستخدام المشين لتهمة معاداة السامية تعريف العدو اليوم. فمنذ بداية الحرب ضد روسيا، وبشكل أكبر مع الإبادة الجماعية التي أُطلِقت ضد الفلسطينيين — وهما لحظتان في المواجهة مع الجنوب العالمي — تُنفّذ مبادئ شميت عن الحرب العادلة والحرب الأهلية علناً ضد كل من يرفض الخضوع للعسكرة الجارية: «الشك في الحق الخاص خيانة؛ الاهتمام بحجة الخصم عدم ولاء؛ ومحاولة النقاش تصبح توافقاً مع العدو».
يقدّم لنا تحليل شميت تشريحاً مثالياً للوضع المحيط بالحروب، بما فيها الحرب العادلة والحرب الأهلية المعلنة أو الكامنة، التي اختارتها الديمقراطيات الرأسمالية كآخر محاولاتها اليائسة لوقف أفولها المحتوم.
ختاماً: الحال أنّ الرأسمالية لن تقود حتماً إلى الاشتراكية والشيوعية، لكن من المؤكد تماماً أنّها، وبانتظام مُقلِق، تقود إلى الحرب والحرب الأهلية.
نُشِر هذا المقال في ILL Will في 11 كانون الأول/ديسمبر 2024، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مُسبقة من الجهة الناشرة.