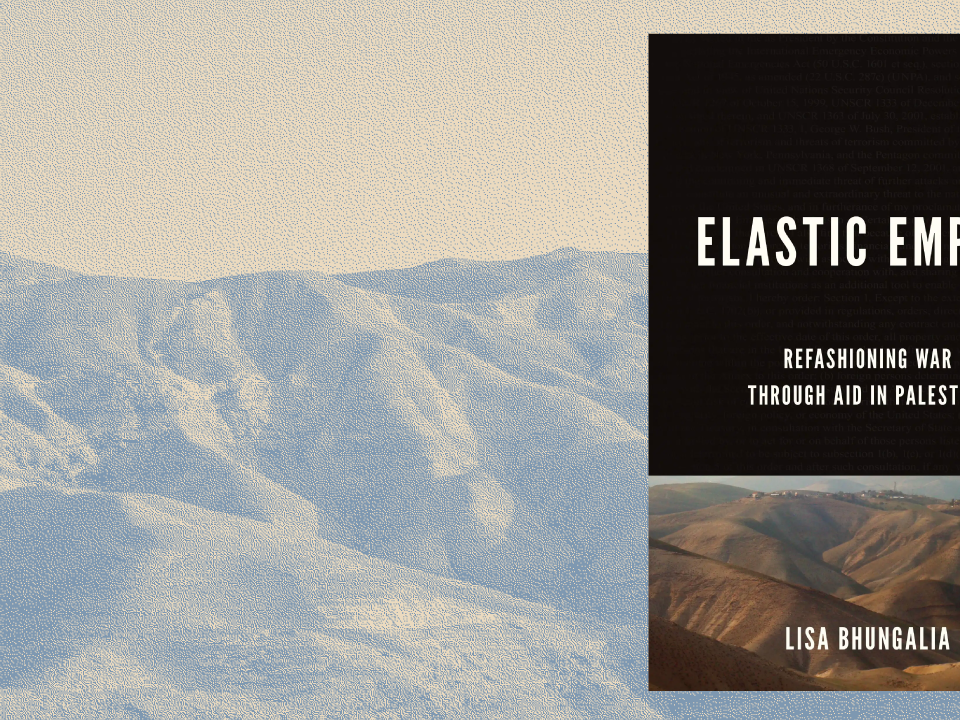الحرب الباردة الثانية وزوال منظومة المساعدات الخارجية الغربية
في العام 1961، أسّست الدول الغربية لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في إطار مساعٍ منسّقة لمواجهة النفوذ السوفياتي في الجنوب العالمي. بيد أنّ هذه الركيزة المؤسسية لنظام المساعدات الخارجية بزعامة الغرب تواجه اليوم تحدّيات متصاعدة. على الصعيد الخارجي، تسعى الصين علناً إلى تبوّؤ موقع القيادة في أجندة التنمية العالمية، معلنة بذلك نهاية احتكار الغرب لتحديد غايات المساعدات الخارجية وسبلها. وفي الوقت نفسه، غيّرت الجهات المانحة الغربية دوافعها لتقديم المساعدات، إذ باتت في كثير من الأحيان تُغلّب مصالحها الجيوسياسية والتجارية على الاعتبارات الجماعية. ونتيجة لذلك، لم يصل في العام 2023 سوى 22% من المساعدات الخارجية إلى البلدان الأفقر، بعدما كانت النسبة 35% قبل عقد، إذ باتت الدول المانحة توجّه أموالها إلى البلدان متوسطة الدخل، سعياً وراء مكاسب استراتيجية أو تجارية أكبر (UNCTAD, 2024). فهل انقلب نظام المساعدات الغربية إلى سعي مشتّت وراء المصالح الذاتية، بعدما كان ذات يوم مشروعاً جماعياً للنظام الدولي الليبرالي؟ وما دلالات هذا التحوّل على مستقبل التنمية العالمية؟
منظومة المساعدات الخارجية: النشأة في الحرب الباردة
أضحت منظومة المساعدات الخارجية في القرن العشرين ركيزة أساسية من ركائز النظام العالمي لما بعد الحرب، صاغته ضرورات الأيديولوجيا والاستراتيجيا في خِضم الحرب الباردة. وعلى الرغم من أنّ ممارسة نقل الموارد الميسّرة بين الأمم تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، ولا سيما في ممارسات إدامة الاستعمار المتأخّر وتسكين الاضطرابات، فإنّ تقديم المساعدات الخارجية بصورة جماعية ومؤسّسية من قِبَل الدول الغربية في سياق ما بعد الحرب لم يكن أمراً حتمياً بأي حال من الأحوال. ويمكن عزو جل هذا التطور إلى المساعي الاستراتيجية للقوة المهيمنة آنذاك: الولايات المتحدة الأميركية. فبعد الحرب العالمية الثانية، سعت واشنطن إلى استنساخ نجاح مشروع مارشال في الدول حديثة الاستقلال في الجنوب العالمي. وهدفت إلى دمج هذه الدول في الاقتصاد العالمي لما بعد الحرب، ومعالجة النقص المزمن في الموارد في الداخل، وتحقيق ذلك كله من دون إثارة مشاعر مناهضة للإمبريالية.
وإذ أدركت الولايات المتحدة تكاليف برنامجها الطموح للمساعدة الخارجية وما ينطوي عليه من تحديات، فقد سعت إلى «تقاسم الأعباء» عبر استقطاب الدول الصناعية الأخرى إلى ما عُرف بـ«جهد المساعدات المشترك». وقد تُوّجت هذه المساعي بإنشاء لجنة المساعدات التنموية التابعة لمنظّمة التعاون الاقتصادي والتنمية التي غدت مؤسّسة محورية في بلورة القواعد والمعايير الناظمة للمساعدات التنموية الدولية.
منذ ذلك الحين، اضطلعت لجنة المساعدات التنموية بدور محوري في تعريف المساعدات الخارجية (المعروفة رسمياً بالمساعدة التنموية الرسمية)، وإرساء مبادئ «المانح الصالح»، وتحديد وسائل وغايات ما يجب أن تتضمّنه «التنمية». لقد صُمِّمت المساعدة التنموية الرسمية، في المقام الأول، لتكونَ مورداً عاماًَ ذي طابع تيسيري وتنموي خاص، مختلفةً بوضوح عن التدفقات المالية العامة المدفوعة بالمصالح التجارية أو الأمنية. وبقوننة هذه المعايير، أرست اللجنة عملياً الأساس لنظام المساعدات الخارجية الحديث، وخلقت إطاراً للمشاركة الجماعية للدول الصناعية في جهود «التنمية» العالمية. وتجلّى نجاحها في تعزيزها هوية جماعية بين الدول الغربية، مُصوِّرةً تقديم المساعدات، بحسب كلمات أول أمين عام لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية كريستنسن، بأنّه «وظيفة طبيعية وثابتة للدولة الصناعية» (Schmelzer, 2016: 227).
لم يكن نظام المساعدات الغربية عملاً من أعمال الإحسان الجماعي ولا بادرة تكفير عن مظالم الاستعمار، بل أداةً استراتيجية سخّرتها القوى الرأسمالية الغربية لمنافسة الاتحاد السوفياتي
غير أنّ نشأة لجنة المساعدات التنموية لا يمكن فهمها بمعزل عن سياق الحرب الباردة الأوسع. فقبل شهر واحد من تأسيسها، أطلق الاتحاد السوفياتي «اللجنة الدائمة للمساعدة التقنية» لتنسيق جهود المساعدات من المعسكر الشرقي للجنوب العالمي (Lorenzini, 2019: 82). وهكذا، لم يكن نظام المساعدات الغربية، المتمثل في اللجنة، عملاً من أعمال الإحسان الجماعي ولا بادرة تكفير عن مظالم الاستعمار، بل أداةً استراتيجية سخّرتها القوى الرأسمالية الغربية لمنافسة الاتحاد السوفياتي في استمالة «القلوب والعقول» في دول «العالم الثالث» غير المنحازة.
صُمِّمت لجنة المساعدات التنموي كمنتدى حصري للمانحين الغربيين، يعمل خارج إطار الأمم المتحدة، فصار للدول الرأسمالية منصّة لإملاء وتشكيل وسائل وغايات «التنمية» وفق شروطها الخاصة. وتكشف مراسلة بريطانية من العام 1964 عن هذه النيّة، إذ وصفت اللجنة بأنّها «هيئة أساسية يستطيع فيها الغرب، متحرراً من الخُطب الهستيرية للكتلة الأفرو-آسيوية أو المناورات التخريبية من وراء الستارين الحديدي والخيزراني، دراسة جوهر مشكلات المساعدات بكل موضوعية وابتكار موقف منسّق لتبنيه في نيويورك وجنيف» (Schmelzer, 2014: 180).
وعلى الرغم من أنّ المساعدات الخارجية منحت شعوب الدول المانحة وحكوماتها سردية مطمئنة عن سخائها وإحسانها، فقد كانت في الوقت ذاته أداةً أساسية لتأمين القبول بالنظام الرأسمالي السائد بعد الحرب. فقد اضطلعت منظومة المساعدات، في جوهره، بدور الوسيلة ترسّخ بها الهيمنة الأخلاقية للغرب (Hattori, 2001)، إذ قدّمت لمتلقيها وعوداً بالتقدّم الاقتصادي، والاستقلال ما بعد الاستعمار، وفرصة التمتع بالحريات الديمقراطية الليبرالية، على خلاف النموذج السوفياتي.
غير أنّ سردية التقدّم هذه حملت في طيّاتها تراتبيةً ضمنية. فقد عزّزت المساعدات الخارجية بخفاءٍ التفوّق التكنولوجي والمادي المتصَوَّر للمانحين الغربيين الذين صُوِّروا كمَن يسير في طليعة «قافلة التقدّم العظيمة» (Hickel, 2017). لكنّ المتلقّين من الجنوب، بقبولهم المساعدات، وُضِعوا ضمنياً في موضع المسؤول الأساسي عن تخلّفهم، بدلاً من عزو هذا التخلّف إلى إرث الاستغلال الاستعماري أو بنية الاقتصاد العالمي الناشئة بعد الحرب.
المساعدات الخارجية والتجدّد بعد الحرب الباردة
مع نهاية الحرب الباردة، اختفى المُسوِّغ الجيوسياسي الصريح لوجود منظومة المساعدات الخارجية، ما ألقى بلجنة المساعدات التنموية في أزمة غاية وشرعية. وانهارت مستويات المساعدات تبعاً لذلك، إذ تقلّصت إلى النصف بين العامين 1990 و1997، بعدما استسلمت الجهات المانحة الغربية لـ«إجهاد المانحين». وتفاقم هذا التراجع بسبب الإخفاقات التنموية لبرامج التكيّف الهيكلي النيوليبرالية التي سببت تراجعاً اقتصادياً واجتماعياً في كثير من البلدان المتلقية وصاحبها ردود فعل عنيفة. وبحلول منتصف التسعينيات، غدت المساعدات الخارجية مفهوماً مشوّهاً، مرتبطاً على نطاق واسع بالفشل وخيبة الأمل على جناحي اليسار واليمين السياسيين.
غير أنّه مع مطلع الألفية، شهدت المساعدات الخارجية انتعاشاً لافتاً، دعمته زيادة الموارد وحماسة متجدّدة. واضطلعت لجنة المساعدات التنموية بدور محوري في هذه العودة، فنشّطَت مشروع المساعدات الخارجية وأعادت تعريف غايته. وتجلّى هذا التجديد في نشر تقرير لجنة المساعدات التنموية الموسوم «تشكيل القرن الحادي والعشرين» في العام 1996، وبشّرت فيه بتحوّل أيديولوجي كبير. سعى التقرير إلى تجاوز التراتبية البالية «المانح-المتلقي»، ودعا إلى شراكات أفقية مع البلدان المتلقية، في إشارةٍ إلى التزام بنموذج تنموي أكثر تعاوناً ومشاركة.
مع نهاية الحرب الباردة، اختفى المُسوِّغ الجيوسياسي الصريح لوجود منظومة المساعدات الخارجية، ما ألقى بلجنة المساعدات التنموية في أزمة غاية وشرعية. وانهارت مستويات المساعدات تبعاً لذلك
كما قدّم التقرير سلسلة من الأهداف الطموحة للتنمية الدولية، حظيت لاحقاً بتأييد الأمم المتحدة ووُثّقت ضمن الأهداف التنموية للألفية. وبالتوازي مع ذلك، مهّدت لجنة المساعدات التنموية الطريق لأجندة إصلاحية، عُرفت بـ«أجندة فاعلية المساعدات»، لم تقتصر على التصدّي للتحديات المستعصية في تحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة، بل سعت أيضاً إلى «توسيع دائرة» حوكمة المساعدات الخارجية. فقد هدفت إلى تجاوز طابعها الحصري الذي ظلّ حكراً على المانح الغربي، عبر إشراك حكومات الدول المتلقية، ومنظمات المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والجهات المماثلة الجديدة من خارج اللجنة، بدورٍ يتجاوز الدور الثانوي في عمليات منظومة المساعدات التقليدية.
لئنْ بدت هذه التحوّلات نحو نموذج أقل وصاية وأكثر تشاركية في حوكمة المساعدات الخارجية مستحسنة، فإنّها لم تكن قطيعة مع النيوليبرالية ولا مع السعي إلى ترسيخ الهيمنة الغربية (Ruckert, 2006). بل يمكن القول إنّها أفرزت شكلاً أكثر تغلغلاً وتدخلاً، متستراً بلغة «الشراكة». فقد حجب هذا الخطاب ما بقي قائماً من تَراتبيات بين الشمال والجنوب، بل ورسخها في بعض الجوانب. لكن تكشف هذه التغيرات عن قدرة المشروع الغربي للمعونة ولجنة المساعدات التنموية على التكيّف مع مشهد ما بعد الحرب الباردة. فالثنائية الصارمة لتلك الحرب (نحن في مقابل هم) أُزيحت لصالح نداءات عالمية كونية، بات معها مشروع المساعدات الخارجية غلافاً رقيقاً من الرأفة يغلّف التمدد الحثيث لقوى السوق العالمية.
المساعدات الخارجية اليوم
على الرغم من انتعاش مشروع المساعدات الغربية في مطلع الألفية الثالثة، فإنه يواجه اليوم تحدّيات جذرية تهدّد تماسكه وصلاحيته. على الصعيد الخارجي، أحدث صعود التعاون بين بلدان الجنوب، بقيادة الصين، تحوّلاً عميقاً في ممارسات المساعدات الخارجية وخطاباتها. ولم يكن هذا التعاون وافداً جديداً، إذ قدمت دوله المساعدة التقنية منذ مؤتمر باندونغ في العام 1955، أي قبل نشأة لجنة المساعدات التنموية واللجنة الدائمة السوفياتية. غير أنّ هذه الجهود ظلت، طوال معظم القرن العشرين، محدودة النطاق وبعيدة من مجهر النظام التقليدي للمعونة الخارجية. لكنّ لنشأة هذا التعاون في باندونغ دلالة بالغة، إذ تعكس استجابة مضادة لبارادايمات المساعدات الغربية، ارتكزت على مبادئ عدم التدخل والتضامن مع دول ما بعد الاستعمار واحترام السيادة والمطالبة بنظام عالمي أعدل. أما من الناحية المادية، فقد باتت الصين اليوم تقدّم تمويلاً للبنية التحتية يعادل 2.5 ضعف ما تقدمه الولايات المتّحدة وبريطانيا واليابان وألمانيا مجتمعة (CGD, 2022).
يسلّط البعض الضوء على انحسارٍ حديث في تمويل الصين للتنمية، لكنّ التحدي المؤسسي والفكري الأهم أمام لجنة المساعدات التنموية والنظام الغربي للمعونة ينبثق من «مبادرة التنمية العالمية» التي أطلقتها بكين في العام 2021. على خلاف الجهود السابقة الرامية إلى إرساء بدائل مؤسسية بالتعاون مع قوى ناشئة أخرى (منها البنك الآسيوي للاستثمار في البنية التحتية وبنك التنمية الجديد لمجموعة «بريكس»)، تتسم هذه المبادرة بطابع مركزي صينيّ محض. إذ تطرح تصوراً لما تصفه الصين بـ«التعددية الحقيقية»، في انتقادٍ مستتر للنموذج المؤسسي «الحصري» الذي تتبناه اللجنة (FMPRC, 2022). وبعدما رفضت الصين في خلال العقد الماضي مساعي لجنة المساعدات التنموية لتوسيع نطاقها عبر أجندة «فاعلية المساعدات» ومحاولاتها «ضمّها قسرياً إلى منظومتها» (Xiaoyun, 2017)، باتت المبادرة الصينية تمثّل أداة لترسيخ رؤية شي جين بينغ لقيام «مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية». يؤسّس هذا الإطار المعياري لنظام عالمي بديل يرتكز على العلاقات التعدّدية بين الدول، ومرجعية الأمم المتحدة، واحترام السيادة الوطنية، مع دور قيادي متصاعد للصين في أجندة التنمية العالمية.
يعكف المجتمع الدولي اليوم على مواجهة التعثر في تنفيذ أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، وهو تعثّر يعزى في أحد جوانبه إلى إخفاق الرهان على تحويل «المليارات» من المساعدات الخارجية إلى «تريليونات» من الاستثمارات المالية الخاصة (Bernards, 2024). وفي خضم ذلك، بدأت ملامح الإطار التنموي العالمي لما بعد 2030 تتبلور. ههنا، توفر «مبادرة التنمية العالمية» لبكين منصّة قوية لترويج رؤيتها للتنمية والنظام العالمي، وهي رؤية أُُدمِجت بالفعل ضمن إجراءات وآليات الأمم المتحدة. تشدّد هذه الرؤية على الحقوق الجماعية دون الفردية، وعدم التدخل، وسيادة الدول، مع تجنبٍ صريحٍ لنزعة «التوسع في المهام» المرتبطة بنشر الديمقراطية وغيرها من أجندات دس السم في العسل المرتبطة بمشروع المساعدات الغربي. الحال أنّ بعض النقّاد قد يستخف بالمبادرة الصينية ويصفها بمجرد مشروع رمزي أو غامض، يُراد به أساساً نقل بوصلة بكين بعيداً من المشروعات الثقيلة في البنية التحتية نحو مبادرات أقل كلفة في القطاعات الناعمة، لكنّ هذه الرؤية تتجاهل حجم الالتزامات المالية من الصين في إطار المبادرة. ففي العام 2021، خصصت بكين 4 مليارات دولار عبر «صندوق التنمية العالمية والتعاون بين بلدان الجنوب»، ثم رفعت التزاماتها إلى 12 مليار دولار إضافية في العام 2023 في شكل صناديق خاصة استندت إلى تمويل من مؤسسات مالية محلية ودولية (CIDCA, 2023).
يكشف تنامي النفوذ الصيني في الجنوب العالمي عن الدور الاستراتيجي لـ«مبادرة التنمية العالمية». فالاجتماعات المتكررة لـ«أصدقاء المبادرة»، المنعقدة ضمن فعاليات الأمم المتحدة وعلى هامشها، ويشارك فيها ممثلو أكثر من 80 دولة، تكشف قدرة بكين على حشد الدول النامية حول رؤيتها التنموية في خضم النقاشات عن أجندة ما بعد 2030. وعلى الرغم من أنّ المبادرة لا تزال في مراحلها الأولى، ويمكن وصفها بـ«الهيمنة المضادة بميزانية محدودة»، فإنّها مع ذلك تمثل تحدياً صريحاً لأعراف ومؤسسات الحوكمة التنموية بزعامة الغرب.
ما تبقى من المساعدات الأميركية مرشّح لأن يُوظّف أكثر فأكثر أداة للمنافسة الجيوسياسية الثنائية مع الصين
بيد أنّ لجنة المساعدات التنموية ومنظومة المساعدات الغربية تشهد منذ نشوئها تحديات من رؤى تنموية منافسة. في القرن العشرين، حفّزت الضغوط الخارجية، سواء من الاتحاد السوفييتي أو من التحالفات الجنوبية داخل الأمم المتحدة، نشأة اللجنة وترسيخ أركانها. أما اليوم، ومع تقدّم الصين لاعتلاء موقع القيادة في أجندة التنمية العالمية، لكنّ اللجنة والمنظومة الغربية برمتها عاجزتان (أو غير راغبتين) عن بلورة نموذج مضاد يتسم بالتماسك والقدرة على الهيمنة.
وفي ظل إدارة ترامب الحالية، يخيّم شبح انسحاب الولايات المتحدة من منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، يزيد من حدّته التوجّه المتوقع نحو تقليص ميزانية المساعدات لدى أكبر مانح في العالم. وما تبقى من المساعدات الأميركية مرشّح لأن يُوظّف أكثر فأكثر أداة للمنافسة الجيوسياسية الثنائية مع الصين، فلا يكاد يترك مجالاً لأهداف من قبيل الحدّ من الفقر أو مكافحة التغير المناخي أو تحقيق المساواة بين الجنسين (Regilme, 2023).
يزيد من قتامة هذا المشهد تحوّلٌ أوسع نطاقاً في دوافع المانحين الغربيين على مدى السنوات الـ15 الماضية، إذ غدت المصلحة الذاتية مبرراً صريحاً وأساساً لتقديم المساعدات الخارجية. فبريطانيا، وقد كانت تُلقّب يوماً بـ«القوة العظمى في التنمية»، سارت على المنوال ذاته، إذ قلّصت التزاماتها في مجال التنمية. فمنذ خفضت ميزانيتها المخصّصة للمساعدات الخارجية إلى النصف في العام 2020 (لم تعُد إلى مستوياتها بعد)، باتت تخصّص نحو 30% من مساعداتها للإنفاق الداخلي على اللاجئين (Bond, 2023). أما إعادة هيكلة وزارة التنمية الدولية، التي أسّسها توني بلير، ودمجها في وزارة الخارجية، فهي تجسيد لهذا التحوّل. فمن جهة، توحي هذه الخطوة بتراجع أولوية التنمية والمساعدات الخارجية، لتصبح تابعةً للاعتبارات الجيوسياسية والتجارية الأوسع. ومن جهة أخرى، تعكس انخراط بريطانيا في نهج «تجاري بلا خجل»، يوجّه المساعدات بعيداً من أهدافها المعهودة بعد الحرب الباردة، من قبيل الحد من الفقر ورفع كفاءة المساعدات، ونحو مشاريع تتفق مع المصالح الوطنية.
لا يقتصر هذا التوجّه على بريطانيا، إذ تبنّى الكثير من المانحين في لجنة المساعدات التنموية، مثل هولندا وأستراليا، استراتيجيات معونة تحرّكها المصالح الذاتية. حتى الدول الإسكندنافية، وهي التي طالما وُصفت بنهجها الإنساني ونزعتها الإيثارية في تقديم المساعدات، بدأت تنزاح نحو أنماط تغلب عليها المصلحة الذاتية في تقديم المساعدات (Puyvallée & Bjørkdahl, 2021). وتشير هذه التحوّلات إلى إعادة ترتيب أوسع لأولويات المانحين، باتت معها المصالح الجيوسياسية والتجارية تطغى على التركيز الذي ساد بعد الحرب الباردة على التنمية والحد من الفقر. ونتيجة لذلك، يُعاد توجيه المساعدات بعيداً من الدول والسياقات «الأشد احتياجاً» لها، إذ يفضّل المانحون المشروعات الواعدة بمكاسب تجارية أو استراتيجية (Craviotto, 2023). والنتيجة نهج أقل «إيثارية» في تقديم المساعدات الخارجية، بات يُصاغ وفق مصالح المانحين الأفراد بدلاً من الأجندات الجماعية.
من ناحية، يعكس هذا التوجه تبنّي الغرب للخطاب المرتبط بالتعاون بين بلدان الجنوب، خصوصاً الحجة القائلة بأنّ سعي المانحين لتحقيق «منافع متبادلة» مع البلدان المتلقية أمرٌ مبرّر ومشروع، سواء كان ذلك بمصطلحات تجارية أو جيوسياسية. ومن ناحية أخرى، يعكس تحوّلات سياسية واقتصادية أوسع داخل البلدان المانحة، فقد عزّزت تدابير التقشّف في العقود الأخيرة وصعود الشعبوية اليمينية المشاعر المناهضة للمساعدات. وقد رسّخ هذا المناخ السياسي المتغير فكرة أنّ على المساعدات الخارجية أن تعطي الأولوية «للمصلحة الوطنية» على احتياجات «الآخرين البعيدين» في الخارج.
بطبيعة الحال، ألقت المصلحة الذاتية منذ زمن بظلالها على عمليات الدول الصناعية طوال 70 سنة من عمر منظومة المساعدات الخارجية. وفي حين كانت ضمنية على مر تاريخها، لم يسبق أن أُعطيت الأولوية بشكل صارخ لمسوغات المصلحة الذاتية على مُثُل الإيثار التي – مهما بلغت من السطحية – دعمت شرعية النظام وأدامت فعاليته كأداة هيمنة. وتكمن القضية الأساسية في المصلحة الذاتية كدافع لتقديم المساعدات الغربية في عدم شرعيتها بين المتلقين. وخلافاً لمقدّمي التعاون بين بلدان الجنوب، الذين يمكنهم الاستناد إلى مبادئ «المنفعة المتبادلة» أو التعاون «المربح للطرفين» على أساس اشتراك البلدين المُقدِّم والمتلقي في وضع «البلدان النامية» ومساعداتهم مدفوعة بمبادئ باندونغ للشراكة الأفقية، فإنّ المساعدات الغربية المؤطّرة بالمصلحة الذاتية تعزّز في الغالب التفاوتات التاريخية. ويرى كثير من المتلقين المساعدات الخارجية من الدول الصناعية شكلاً من أشكال التعويض الاستعماري وينظرون إلى المصلحة الذاتية كإهانة لسيادتهم. وفضلاً عن ذلك، تميل المصلحة الذاتية إلى التجلّي في المساعدات القائمة على المشروعات بدلاً من دعم الميزانية المباشر، وهذا يقوّض «ملكية» البلدان المتلقية للمساعدات وأجنداتها التنموية – وهو مبدأ أساسي في أجندة فعالية المساعدات المتراجعة الآن.
في تسعينيات القرن الماضي، أظهرت لجنة المساعدات التنموية قدرةً على التأمل الذاتي، فأحيت مشروع المساعدات الخارجية الجماعي من خلال مبادرات مثل الأهداف الإنمائية للألفية وأجندة فعالية المساعدات الطموحة. غير أنّ مسارها الحالي يعكس موقفاً أكثر دفاعية وانفصالاً وتشظياً. فمنذ أكثر من عقد، استغرقت اللجنة في مناقشات تقنية – لكنها سياسية في جوهرها – حول إعادة تعريف نطاق ومضمون المساعدة التنموية الرسمية. وقد ركزت هذه الجهود – وُصِفت من باب التجميل بـ«تحديث» المساعدات الخارجية – على توسيع تعريفات المساعدة التنموية الرسمية لتشمل التدفقات غير الميسرة وأدوات القطاع الخاص وتمويل السلع العامة العالمية التي ليست بالضرورة «تنموية» في توجهها، مثل الحد من تغير المناخ والاستجابة للجوائح.
أتاحت إعادة التعريف هذه للمانحين إدراج عناصر مثل التمويل من القطاع الخاص، وتخفيف الديون، وتبرعات اللقاحات منتهية الصلاحية في حسابات المساعدة التنموية الرسمية. وفي حين ساعدت هذه التغييرات على تضخيم المساهمات المُعلن عنها إلى مستويات قياسية - وصلت إلى 223.8 مليار دولار في العام 2023 - فقد قلّلت غالباً من الالتزامات المالية الفعلية (UNCTAD, 2023). ويعكس الكثير من هذه الزيادة الإنفاق المعاد توجيهه نحو أولويات تتمحور حول المانحين، من بينها التكاليف المرتبطة باللاجئين داخل الدول المانحة والمخصصات لأوكرانيا. ويرى المؤيدون أنّ هذه التغييرات تُوائم المساعدات مع التحديات العالمية المعاصرة، لكن يزعم المنتقدون أنّها تقوّض مصداقية المساعدة التنموية الرسمية كمقياس لكرم المانحين وكتدفق للموارد العامة والميسرة المخصصة لتحقيق «التنمية» (Cutts, 2022; cf. Moorhead, 2022).
وانشغال لجنة المساعدات التنموية بتعديل القواعد يكشف لنا عن تراجع قدرتها على تشكيل أجندة التنمية العالمية. فتاريخياً، أدّت دور منتدى محوري للمانحين الغربيين لتحديد وتطوير هوية ورؤية مشتركة للتنمية. أما اليوم، فثمة داخل اللجنة شهية فاترة للتأمل العميق، ولا توجد جهود منسقة لصياغة رؤية أيديولوجية متماسكة وطويلة الأمد لسياسة التنمية. وقد رفض باحثون جنوبيون الجهود المبذولة للحفاظ على صلاحيتها، مثل استحداث مقياس الدعم الرسمي الإجمالي للتنمية المستدامة، بحجة أنّها سطحية ومصممة لخدمة مصالح المانحين (Besharati, 2017). وعلى خلفية الحرب الباردة الثانية الناشئة، فعلت هذه المناقشات الداخلية القليل لمواجهة التحدي الفكري الذي تطرحه قيادة الصين الصاعدة في التنمية العالمية من جهة. وعلاوة على ذلك، يغيب بشكل لافت داخل اللجنة تأمل أكثر جوهرية في دور المؤسسة في عالم تغلب عليه الجيوسياسة وأقل تمركزاً حول الغرب.
ومع استعداد منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية لوضع الصيغة النهائية لما تُسمِّيه «استراتيجية شاملة للتنمية» في وقت لاحق من هذا العام، فإنّها تواجه فرصة حاسمة لإعادة تنشيط نظام المساعدات الخارجية الغربي المحاصر بالتحديات. لكنّ العائق الأهم أمام هذا التجديد لا ينبع بالضرورة من الضغوط الخارجية، مثل مطامح الصين في قيادة أجندة التنمية العالمية، بل من الداخل: نوازع المصلحة الذاتية التي تُفتِّت وحدة وغاية مشروع المساعدات الخارجية الغربي في الظرف الراهن.
نُشِر هذا المقال في 8 شباط/فبراير 2025 في Second Cold War Observatory، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مسبقة من الجهة الناشرة.