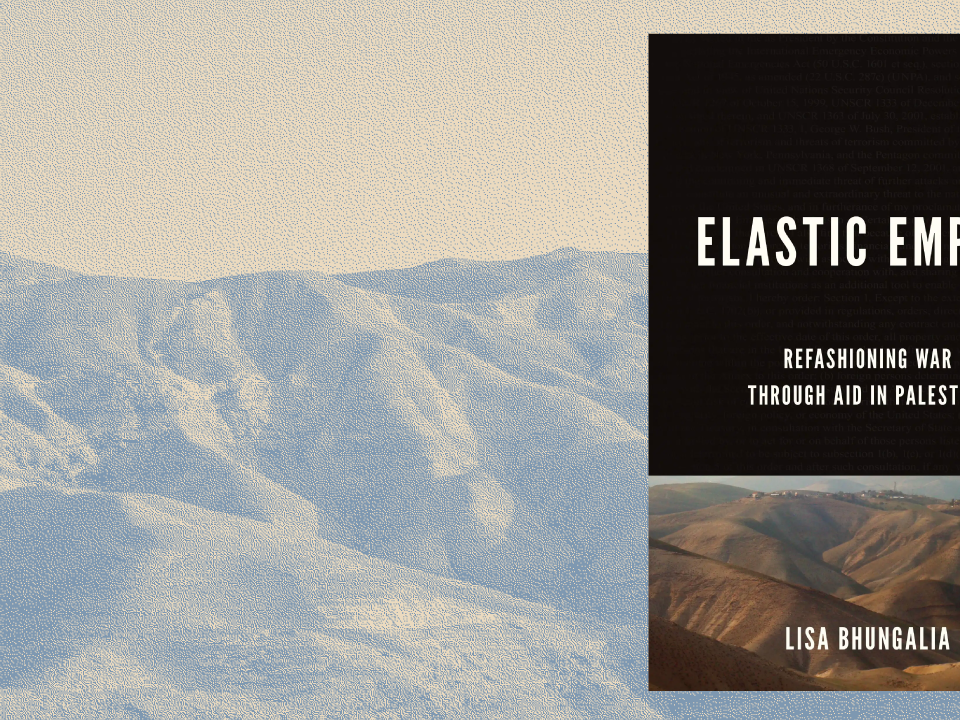حياة العمل الرقمية
مراجعة لكتاب «حياة العمل الرقمية: استقلالية العامل واقتصاد العمل المؤقت»، لمؤلّفه تيم كريستيانز، وهو يدرس ما يُسمى بـ«اقتصاد المشاركة»، الذي وعد بتحقيق التحرر لكثير من العمال، لكنه تسبب، عند كثيرين، بـ«أوبرة» (من أوبر) العمل، وأكد ببساطة فقدان ترتيبات العمل اللائق والآمن.
الحياة العملية الرقمية كتاب قصير يتناول موضوعاً بالغ الاتساع، أو هو بالأحرى كتاب قصير عن موضوعات عدّة شديدة الاتساع منها: ظهور التقنيات الرقمية التي تشكّل حياة العمال والمستهلكين وزيادة قدرة الشركات الكبرى بالتبعية على المراقبة في أماكن العمل، وصعود ما يُسمى بـ«اقتصاد الوظائف المؤقتة» وانتشار العمل المؤقت وتراجع كثافة النقابات العمالية في العالم الغربي، وتوسع الأسواق لتغزو مجالات من الحياة الإنسانية كانت في السابق بعيدة عن متناول الرأسمالية، والسلطة المطلقة للقطاع المالي في توجيه تدفقات رأس المال إلى أيدي التقنيين الذين يروّجون لمشروعات مشكوك في جدواها، والاعتراف الشعبي المتنامي بوجود خلل عميق في الاقتصاد السياسي النيوليبرالي السائد، يحبط تطلعات الكثيرين لعيش حياة مستقرة وكريمة والانخراط في عمل ذي معنى، وما يمكن فعله حيال ذلك.
كلٌّ من هذه الموضوعات يستحق معالجة موسّعة في كتاب مستقل، والعديد منها حظي بذلك بالفعل. لكن هدف تيم كريستيانز ليس جمع كل هذه الخيوط في أطروحة شاملة، بل دراسة جانب واحد من حياتنا الاجتماعية والاقتصادية، ذلك الجانب الذي تتقاطع فيه هذه التطورات: ما يُسمى بـ«اقتصاد المشاركة» الذي شاع بعد الأزمة المالية لعام 2007-2008، والذي وعد بتحقيق التحرر لكثير من العمال، لكنه تسبب، عند كثيرين، بـ«أوبرة» [من أوبر – م] العمل وأكد ببساطة فقدان ترتيبات العمل اللائق والآمن.
هذه الشركات ترى العمال مستهلكين لخدماتها بقدر ما ترى مستهلكي الخدمات النهائية عملاء لها
تسير القصة على النحو التالي: في أعقاب الأزمة المالية وإجراءات التقشف الحكومي، ومع ظهور منصات التجارة الإلكترونية مثل أوبر وأمازون، وُعِد العمال بأن يصبحوا «رؤساء أنفسهم» وأن ينخرطوا في مسيرة مهنية أشبه بريادة الأعمال المصغّرة. وُعدوا بجمع بين ساعات العمل المرنة والحرية في بيع عملهم وفق شروطهم الخاصة، وذلك بمجرد تحميل تطبيق (برنامج مصمم لأداء وظائف محددة) على هواتفهم الذكية. لكن الواقع كان عكس ذلك؛ إذ يرى كريستيانز أنّ العمال قد بيعوا وعداً زائفاً. فالواقع الذي يقدمه اقتصاد المشاركة، بحسب كريستيانز، يمكن وصفه بعبارة أدق بـ«اقتصاد العمل الرقمي المؤقت»، وهو لا يقدم سوى نسخة مشوهة وبائسة من ريادة الأعمال. وعلى العكس من ذلك، يجادل بأنّ المنصات الرقمية «تمثل مرحلة جديدة في تأزيم العمل بالعموم» (2).
ماذا يعني اقتصاد العمل الرقمي المؤقت؟ بحسب كريستيانز، يمثّل هذا الاقتصاد مرحلة جديدة في التراجع المستمر لعقد العمل التقليدي (بأجوره الثابتة، وإمكانية الحصول على المعاشات والمزايا الإضافية، واللجوء إلى الحقوق القانونية، وما إلى ذلك)، وهو تراجع بدأ منذ سبعينيات القرن الماضي. وعلى الرغم من أنّ صعود ما يُسمى بشركات التكنولوجيا الكبرى والمنصات الرقمية لم يكن السبب المباشر لهذه الظاهرة، فقد سرّعت وتيرتها إلى درجة مقلقة. ومع أنّ هذه الشركات تمثل بالفعل مرحلة جديدة في هذا المسار، فإنّها تُعد نقلة نوعية. كانت الشركات التقليدية توظف العمال الذين يبيعون قوة عملهم مقابل أجر لإنتاج السلع والخدمات وبيعها للمستهلكين بهدف تحقيق الربح. لكن سلوك الشركات الرقمية يتوافق مع هذا النموذج بشكل فضفاض للغاية. فشركات مثل أوبر وديليفرو وإير بي إن بي لا تقدم عقود عمل، بل توفر للـ«متعاقدين المستقلين» الباحثين عن عمل إمكانية الوصول إلى منصاتها. بعبارة أخرى، هذه الشركات ترى العمال مستهلكين لخدماتها بقدر ما ترى مستهلكي الخدمات النهائية عملاء لها. وهكذا، تمتلك الشركات الرقمية السوق (المنصة الوسيطة) الذي يلتقي فيه البائعون والمشترون، لتقتطع نصيبها من الإيرادات المتولدة عن المعاملات، إلى جانب أساليب أخرى لتحقيق الأرباح.
تسارعت وتيرة «أوبرة» العمل في قطاع الخدمات باسم الراحة والسهولة، وحققت بالفعل فوائد ملموسة للكثيرين؛ إذ يستفيد العملاء من توصيل الطرود إلى منازلهم بسرعة، وحجز سيارات الأجرة في وقت قصير، وطلب وجبات الطعام بلمسة زر. وبالمثل، يجد العديد من العمال في ساعات العمل المرنة والوظائف الجزئية مصدر دخل إضافياً قيّماً وهواية ممتعة. أما العمال المهاجرين على وجه الخصوص، ممن يواجهون صعوبات لغوية، فقد وفرت لهم المنصات الرقمية وسيلة لكسب الأجر بسهولة بفضل تقليل عوائق الدخول إلى هذا النوع من العمل. يعترف كريستيانز بهذه المكاسب، لكنّه يركز على «العمال الذين يعتمدون على المنصات الرقمية في معيشتهم اليومية» (5). لكن من غير المعلوم نسبة هؤلاء من إجمالي عمال اقتصاد الوظائف المؤقتة، ما يُصعّب تقييم فعالية المقترحات التي يقدمها في نهاية الكتاب لتحقيق «الاستقلال التعاوني» للعمال في العصر الرقمي. والحال أنّ هذا لا يطعن في وجاهة حجج الكتاب، لكنّه يترك تطبيقها العملي في دائرة الالتباس.
الأكثر إثارة للقلق والجدة، كما يؤكد كريستيانز، هو ظاهرة المراقبة الرقمية و«حكم الخوارزمية» التي تتبع سلوك العمال وتنسقه
وسلبيات اقتصاد الوظائف الرقمية المؤقتة هذا، على ما فيه من مكاسب، تفوق إيجابياته. ولا تقتصر التكاليف على تعميم العمل المؤقت ورداءته في ظل المنصات الرقمية، على الرغم من خطورة هذه الاعتراضات. وكما أُشير سابقاً، فقد بدأت هذه الاتجاهات المؤسفة منذ زمن طويل قبل ظهور التطبيقات والهواتف الذكية. بيد أنّ الأكثر إثارة للقلق والجدة، كما يؤكد كريستيانز، هو ظاهرة المراقبة الرقمية و«حكم الخوارزمية» التي تتبع سلوك العمال وتنسقه. يقول المؤلف: «تشكِّل استراتيجية التحكم الخوارزمي جوهر الإشكالية» في الكتاب (5). وتتخذ هذه السمة في الاقتصاد الرقمي بُعداً أورويليّاً مقلقاً، لا سيما حين نكتشف أنّ جمع البيانات المتعلقة بعادات المستهلكين (أي العمال) وتفضيلاتهم وسيلة أساسية لبقاء العديد من المنصات الرقمية مربحة، إذ تبيع الوصول إلى مستودعات بياناتها بدلاً من تحقيق أرباح استثنائية من أنشطتها الأساسية.
ينقسم الكتاب إلى قسمين رئيسين: يتناول الأول آليات اقتصاد الوظائف الرقمية المؤقتة، بما فيها نماذج أعمال الشركات. الحالة النموذجية هنا هي «أوبر»، الشركة التي تخلّت عن تعظيم أرباحها من أجل تعظيم حصتها السوقية، سعياً للتحول إلى مُحتكر والانتفاع بما يُعرف بـ«تأثيرات الشبكة» (حيث يؤدي استخدام عدد كبير من المنتجين والمستهلكين للمنصة إلى جعلها ضرورة للمنتجين حتى يظلوا قادرين على المنافسة). تتبع العديد من الشركات الرقمية هذه الاستراتيجية (أمازون مثال آخر)، إذ تعتمد على استثمارات شركات رأس المال المُغامر في المدى القصير، والأخيرة تراهن على أنّ الجهات المستفيدة من تمويلها قد تصبح المحتكر التكنولوجي المقبل، لتبرر على أثرها المخاطرة المتضمنة. أما القسم الثاني من الكتاب، فيوظف فلسفة التكنولوجيا التي طرحها إيفان إيليش لابتكار تصور جديد لاستقلالية العمال ويطرح عدة مقترحات مفيدة (وإنْ كانت أقل جِدة) لجعل التكنولوجيا الرقمية في خدمة العمال، من بينها توسيع الحركة التعاونية إلى العالم الرقمي على غرار نموذج الاشتراكية النقابية لجورج كول.
الجوانب السلبية للتكنولوجيا الرقمية ليست متأصلة فيها ويمكن تحديدها واستئصالها، ما يتيح نمطاً أكثر إنسانية وتعاوناً للتنسيق الاقتصادي يكون مهيأً للملكية الجماعية من قِبل العمال
قد تختلف تفضيلات القرّاء، لكنني وجدت النقاش الوارد في الفصول الأولى من الكتاب الأكثر جذباً للاهتمام بلا منازع. والسبب بسيط إذ من الضروري الوصول إلى فهم أعمق لبنية المنصات الرقمية وعملياتها لاقتراح سياسات لمكافحة ممارساتها الاستغلالية، أما طرح نظرية حول استقلالية العمال لتوضيح مكامن الخلل في اقتصاد الوظائف المؤقتة الرقمي فيبدو أقل فائدة. فأي شخص عاش في مدينة كبرى في العالم الغربي في العقد الماضي سيكون قد شهد (وربما شارك في) ظروف العمل الشاق والآثار السلبية الناتجة عن هذه المنصات بفعل هياكل الحوافز التي تعتمدها، إلى جانب الأجور الهزيلة وغير المستقرة التي يتلقاها «المتعاقدون» معها. قد يقع المرء هنا في خطر الإفراط بالتنظير لنمط استغلال متغلغل بدرجة أكبر في حياة العمال، وإنْ كان يتنكّر بعباءة التحرر وريادة الأعمال. لحسن الحظ، لم يقع الكتاب في هذا الخطر، وقلما سقط في فخ المصطلحات المعقدة، فاستطاع تقديم تأملات أكثر واقعية وملموسية.
المفاجئ في الأمر أنّ الكتاب يخلو من أي نقاش حول الأساس المادي لاقتصاد الوظائف المؤقتة الرقمي. والمقصود هنا العمليات الإنتاجية وسلاسل التوريد المعقدة التي مكّنت من الانتشار الواسع للمنصات الرقمية، خاصة تطور تكنولوجيا أشباه الموصلات، والتنقيب عن المعادن الأرضية النادرة، وملكية البنية التحتية للإنترنت. قد يكون الرد المنطقي أنّ هذه موضوعات واسعة النطاق تتجاوز إطار تحليل الكتاب. لكن يشير هذا إلى مشكلة في منطق الكتاب ذاته. يكتب كريستيان: «التكنولوجيا الرقمية ليست سيئة بطبيعتها»، وبالتالي «لا حاجة للريبة التشاؤمية تجاه التقنية» (6). أطروحته تقول إنّ الجوانب السلبية للتكنولوجيا الرقمية ليست متأصلة فيها ويمكن تحديدها واستئصالها، ما يتيح نمطاً أكثر إنسانية وتعاوناً للتنسيق الاقتصادي يكون مهيأً للملكية الجماعية من قِبل العمال. لكن من دون مناقشة ملكية وسائل الإنتاج المادي وكيفية تحقيق ذلك في ظل الاشتراكية التعاونية، فإنّ المشكلة المتعلقة بهيمنة رأس المال على العمال تُدفع ببساطة إلى مستوى آخر. قد يمتلك العمال البرامج ويديرونها، لكن الأجهزة تظل في أيدٍ خاصة. (يمكن طرح نقطة مماثلة حول النظام المالي غير المنظم الذي مكّن هذه المنصات الرقمية عبر استثمارات رأس المال المغامر).
في نهاية المطاف، يُعد مشروع كريستيانز جزءاً من نقاش أوسع حول كيفية الحفاظ على المكاسب الحقيقية للرأسمالية، بل والتفوق عليها، في إطار نظام اشتراكي (تُفهم الاشتراكية هنا بوصفها ما فوق الرأسمالية وليس ما بعد الرأسمالية). ليس واضحاً ما قد يبدو عليه هذا الأمر في الاقتصاد الصناعي، لكن في الاقتصاد الرقمي الجديد – حيث مسألة الأجور والأسعار أقل أهمية مقارنةً بالقضية الجوهرية المتمثلة في: من يمتلك السوق نفسه – يكتسب هذا السؤال أهمية جديدة وملحة. كتاب الحياة العملية الرقمية يضيف إلى هذا النقاش ويحفز التفكير.
نُشرت هذه المراجعة في Marx and Philosophy Review of Books في 3 كانون الأول/ديسمبر 2024 بموجب رخصة المشاع الإبداعي.