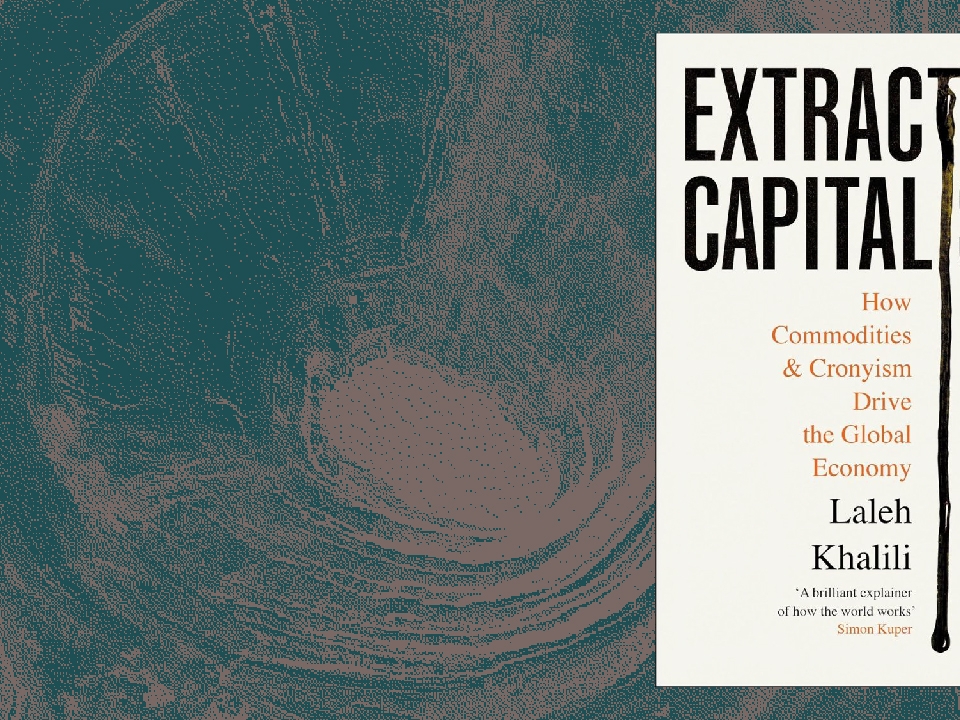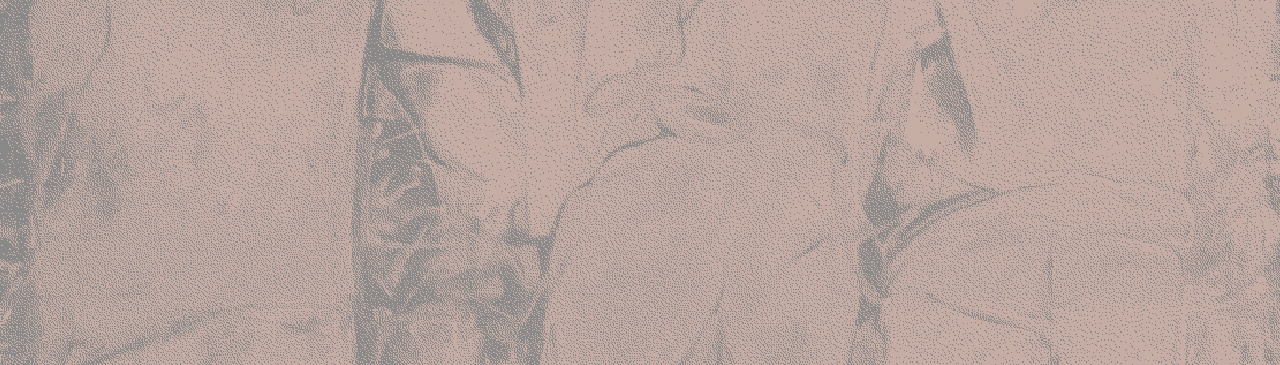
كيف يُعيد خطاب «نزع الاستعمار» إنتاج المنطق الذي يدّعي انتقاده؟
قراءة في كتابَي «ضدّ نزع الاستعمار» لأولوفيمي تايوو و«نظرية ما بعد الاستعمار وشبح رأس المال» لفيفيك تشيبر اللذين يقدّمان نقداً جذرياً لخطاب «نزع الاستعمار»، من خلال مساءلة افتراضاته بشأن وكالة المجتمعات المستعمَرة سابقاً. يطرح الكاتبان تساؤلات نقدية في خطابٍ مقاومة الاستعمار الذي يعيد إنتاج منطق الاستعمار نفسه من خلال اختزال الشعوب كضحايا عاجزين عن التفكير وسلبهم قدرتهم على الفعل والتكيّف.
في السنوات الأخيرة، أصبح مصطلح «نزع الاستعمار» decolonization حاضراً في كلّ مكان، في المتاحف، أقسام الفنون في الجامعات، المهرجانات الثقافية، المناهج التعليمية والخطابات السياسية. في العالم العربي، حيث لا تزال آثار الاستعمار الأوروبي ملموسة في البنى السياسية والاقتصادية والثقافية، ويحمل هذا المصطلح جاذبية خاصة كأداة لتصحيح مظالم الماضي. لكن هل يكفي أن نُدين الاستعمار كي نتحرّر منه؟ وهل يمكن أن يتحوّل خطاب «نزع الاستعمار» من أداة تحرّر إلى قيدٍ جديدٍ يحدّ من وكالة الشعوب المستعمَرة سابقاً؟
يشكّل هذان السؤالان محوراً أساسياً في كتابين مهمّين هما «ضدّ نزع الاستعمار» (2022) للفيلسوف الأفريقي أولوفيمي تايوو و«نظرية ما بعد الاستعمار وشبح رأس المال» (2013) للمفكّر الماركسي فيفيك تشيبر، اللذين يستخدمان مفهوم الوكالة (agency) – أي قدرة الشعوب على اتخاذ القرارات وتشكيل مصيرها – كمدخل لفهم التحدّيات التي تواجه خطاب ما بعد الاستعمار.
محدودية خطاب نزع الاستعمار
في كتابه «ضد نزع الاستعمار: استعادة الوكالة الأفريقية» ينتقد تايوو الاستخدام الرائج وغير النقدي لمصطلح «نزع الاستعمار» في الخطاب المعاصر، ويشكّك في الطريقة التي بات يُستخدَم بها كسردية أخلاقية مغلقة تحجب عن المجتمعات المستعمَرة سابقاً أهمّ ما تمتلكه: الوكالة، أي القدرة على الفعل والاختيار.
يميّز تايوو بين نسختين من المصطلح. نزع الاستعمار 1: وهو العملية التاريخية التي تضمّنت تحرّر الدول المستعمَرة من الاحتلال الأجنبي واستعادة السيادة السياسية والاقتصادية وتأسيس الدول القومية. وهذه النسخة من الاستعمار، كما يراها تايوو، كانت مشروعاً سياسياً ملموساً حقّق إنجازات فعلية في منتصف القرن العشرين مع استقلال دول أفريقيا والعالم العربي وصياغة دساتير وطنية وبناء مؤسسات سيادية، ويرى تايوو أن هذه المرحلة قد اكتملت إلى حدّ كبير. فضلاً عن نزع الاستعمار 2: وهو مشروع رمزي-ثقافي يسعى إلى «تطهير» المجتمعات من كلّ ما له صلة بالإرث الاستعماري سواء في الفضاءات العامة أو اللغة أو أنظمة التعليم أو حتى الأطر والبنى الفكرية المتأثرة بالحداثة الأوروبية. ويتسم هذا المشروع، كما يراه تايوو، بطابعٍ شمولي وأخلاقي، ويقترح رفضاً جذرياً لكلّ ما يُنظر إليه كـ «غربي» من دون تمييز أو تحليل.
إن اختزال كلّ أزمة سياسية أو اقتصادية أو بيئية بأنّها أثر مباشر للاستعمار يهمّش عوامل تفسيرية أخرى لا تقلّ أهمية مثل إخفاقات الحكم المحلّي، أو البنى الطبقية أو الديناميات الاجتماعية الداخلية، أو حتى التفاوتات العميقة في النظام الرأسمالي العالمي
في العالم العربي، يظهر «نزع الاستعمار 2» في دعوات لإحياء اللغة العربية كأداة مقاومة ضد الهيمنة الثقافية الغربية، أو إعادة كتابة المناهج الدراسية لتسليط الضوء على المعارف المحلّية. لكن على الرغم من النوايا النبيلة المفترضة، يرى تايوو أن اختزال التحرّر في محو التأثيرات الغربية، يضع خطاب نزع الاستعمار في مواجهة المنطق الذي يدّعي تجاوزه. بدلاً من أن يكون مشروعاً للتمكين يتحوّل إلى مشروع «تطهير» لا ينتهي، بلا أهداف قابلة للقياس أو الإنجاز، على عكس «نزع الاستعمار 1» الذي كان له أهداف محدّدة تتعلق بالتحرّر الفعلي من الاستعمار.
يقول تايوو: «الكثير من الخطاب عن نزع الاستعمار يعامل المستعمَرين كما لو كانوا حضوراً صامتاً في دراما يكتبها الآخرون. يُقدَّم نزع الاستعمار كما لو أن هناك وجهتي نظر مهمّتين فقط: وجهة نظر الظالمين/المستعمِرين ووجهة نظر المؤيدين [لنزع الاستعمار] الذين يعتقدون أنهم يعرفون الأفضل. ما يتمّ تجاهله أو إهماله في كثير من الأحيان هو أفعال المستعمَرين أنفسهم، وخصوصاً تلك التي لا تنسجم مع توقعاتنا بشأن ارتباطهم بالإرث الاستعماري». (صفحة 43)
المشكلة الأساسية، كما يرى تايوو، هي أن «نزع الاستعمار 2» يستند إلى فرضية تبسيطية مفادها أنّ التأثّر بالاستعمار كان كلّياً ومطلقاً وأن الشعوب المستعمَرة لم تكن سوى كتلاً من متلقّين سلبيين، خاضعين بالكامل للهيمنة، وأنها لم تتفاعل مع «الحداثة» إلّا من موقع الفرض والخضوع.
وهنا تحديداً، يرى تايوو أن هذا الخطاب يُخفق في الاعتراف بأن الاستعمار، على قسوته وعمقه، لم يكن قادراً على إلغاء وكالة الشعوب المستعمَرة. بل على العكس، استخدمت هذه الشعوب ما توفّر لها من أدوات، بما في ذلك الأدوات الغربية، لإعادة بناء ذاتها وصياغة قيَمها، وكانوا مُشاركين فاعلين في تشكيل وتكييف وإعادة توظيف عناصر الحكم والتعليم والفلسفة لتتناسب مع السياقات والطموحات المحلّية. إن تصوير كلّ مؤسسات وأفكار الحقبة الاستعمارية على أنها «غير شرعية بطبيعتها» هو في جوهره محو للوكالة السياسية والإبداع الفكري لمجتمعات ما بعد الاستعمار. ويعكس هذا التكيّف وكالةً فكرية وسياسية، وهي الوكالة التي يرى تايوو أن خطاب «نزع الاستعمار 2» ينكرها.
يتمّ استخدام مفهوم «نزع الاستعمار 2» كذلك لتأطير كلّ المشاكل التي تمرّ بها المجتمعات المستعمَرة سابقاً كآثار للاستعمار، وعلى الرغم من أن الاستعمار ترك آثاراً عميقة لا يمكن إنكارها، إلا أن تحويله إلى سبب جذري أو وحيد لكلّ مشكلة يؤدي إلى تغييب عوامل أخرى حاسمة، مثل إخفاقات الحكم المحلّي، أو الفساد، أو الطبقية، أو الديناميات الاجتماعية الداخلية، أو حتى اختلالات النظام الرأسمالي العالمي. مثلاً، إذا حاولنا تطبيق مفهوم «نزع الاستعمار 2» في المجالات الأكاديمية أو في صياغة المناهج الدراسية، قد يُترجَم ذلك إلى إقصاء النصوص الغربية أو رفض الأطر الأوروبية المركزية أو تطهير اللغة من التأثيرات الأجنبية. وضمن هذا السياق، يفترض أنّ بناء مستقبل أفضل يمرّ عبر التخلّص من رواسب الاستعمار والقطع المعرفي مع الغرب. ولكن ما تفشل هذه النظرية برؤيته أو نقده هو الاعتراف بالمشاكل البنيوية الأعمق: فشل التخطيط المؤسسي، نقص الموارد، الاعتماد المفرط على المساعدات الخارجية، وهجرة الكفاءات. تكمن المشكلة، ببساطة، في إعطاء الأولوية لخطاب «المقاومة الثقافية» على حساب متطلّبات الإصلاح المؤسسي ومعالجة التحدّيات المادية التي تواجه دول ما بعد الاستعمار. إن اختزال كلّ أزمة سياسية أو اقتصادية أو بيئية بأنّها أثر مباشر للاستعمار يهمّش عوامل تفسيرية أخرى لا تقلّ أهمية مثل إخفاقات الحكم المحلّي، أو البنى الطبقية أو الديناميات الاجتماعية الداخلية، أو حتى التفاوتات العميقة في النظام الرأسمالي العالمي.
المشكلة هنا أن الاستخدام المفرط لمصطلحات نزع الاستعمار يمنح الخطاب طابعاً أخلاقياً يصعب الاعتراض عليه. فحين يتمّ تغليف كل مبادرة، أو نقد، أو سياسة، بلغة «نزع الاستعمار»، يصبح من الصعب مساءلتها، إذ أنها تستمدّ مشروعيتها من ارتباطها التاريخي بـ«نزع الاستعمار 1»، أي حركات التحرّر الوطني. وبذلك، تُطمَس الحدود بين المشروعين، ويصبح أيّ تشكيك في «نزع الاستعمار 2» بمثابة إنكارٍ لنضال الشعوب ضد الاستعمار نفسه.
ما يُقلق تايوو ليس «اختزال نزع الاستعمار إلي شعارات ثقافية» فقط بل تبنّي ما يُطلق عليه «سياسة النقاء» purity politics وهو يعني في سياق الاستعمار السعي وراء هوية «أصلية» خالية من أي تأثير غربي، كأنّ على المجتمعات المستعمَرة أن «تتطهّر» من كل ما هو حديث كي تعود إلى حقيقتها. هذا النزوع إلى الأصالة الثقافية والتاريخية للشعوب الأصلية أو المستعمَرة يتغذّى من رؤى رومانسية لماضٍ ما قبل استعماري مثالي، نقي وبلا سوء، خالٍ من التناقضات والانقسامات. والنتيجة هي إعادة تدوين المُستعمَرين كمجتمعات لا تعرّف نفسها إلا من خلال «صدمة الاستعمار» وهو ما يعيد إنتاج المنطق الاستعماري ذاته: تصوير المجتمعات غير الغربية كضحايا عاجزين عن اتخاذ قرارات عقلانية تخصّ حاضرهم. هكذا، يتحوّل «نزع الاستعمار» من أداة تحرّر إلى عقيدة تُجرّد الشعوب من وكالتها، وتختزلها بما فُرض عليها، لا بما تفعله بما ورثته – أي في قدرتها على الفعل والتكيّف والتغيير والنقد وصياغة مصيرها.
نخبوية ما بعد الاستعمار
يلتقي المفكّر الماركسي تشيبر مع تايوو في نقده خطاب ما بعد الاستعمار، لكنّه يركّز على البعد الاقتصادي والطبقي. في كتابه عن «نظرية ما بعد الاستعمار» Postcolonial Theory، ينتقد تشيبر نزعة كثير من المنظّرين ما بعد الاستعماريين إلى تهميش ديناميات الطبقة والاستغلال الاقتصادي في دول الجنوب لصالح التركيز على الفروقات الثقافية والخصوصيات الهوياتية. في السياق العربي، يمكن رؤية تجلّيات هذا الخطاب في بعض الدراسات الأكاديمية التي تضع الهوية الثقافية العربية أو الدينية في قلب مقاومة الإمبريالية والأفكار الغربية، بينما تهمل قضايا أخرى مثل التفاوت الاقتصادي، البطالة، واستغلال العمّال وهجرة العقول إلى الشمال العالمي.
يرى تشيبر أن ظهور «نظرية ما بعد الاستعمار» في المجال الأكاديمي في خلال أواخر القرن العشرين، لم يكن مجرّد تطوّر فكري، بل تزامن مع التراجع العالمي للحركات العمّالية وتفكّك اليسار منذ السبعينيات، وهو ما خلق فراغاً في الخطاب الفكري الراديكالي تولّت نظرية ما بعد الاستعمار ملأه. وعلى الرغم من أنها قدّمت نقداً للإمبريالية، إلا أنها تخلّت عن أدوات التحليل الماركسية الكلاسيكية: الطبقة، رأس المال والصراع الاجتماعي.
في نظر تشيبر، تنزلق «نظرية ما بعد الاستعمار» إلى شكلٍ من الجوهرية أو الماهوية الثقافية cultural essentialism، حيث يُقسَّم العالم إلى ثنائية صارمة: «الغرب» مقابل «غير الغرب»، ما يعزّز الحدود التي تدّعي النظرية أنها تريد تجاوزها أو نقدها. من الأمثلة على ذلك، دراسات التابع Subaltern Studies التي تجادل بأن المفاهيم السياسية والاقتصادية الغربية (مثل الاختيار العقلاني، والعدالة وحقوق الإنسان والديمقراطية) هي مفاهيم «غربية» لا تنطبق على السياقات غير الغربية التي يفترض أن تحكمها منطلقات ثقافية مختلفة جذرياً. هذا الموقف، كما يراه تشيبر، هو محاكاة للرواية الاستعمارية التي برّرت إخضاع الشعوب غير الغربية باعتبارها ما قبل حداثية، مختلفة جوهرياً، وغير عقلانية وبالتالي غير قادرة على الحكم الذاتي.
يقول تشيبر أن منظّري دراسات التابع يقيمون جداراً فاصلاً بين الشرق والغرب، ويزعمون أن الاهتمامات البشرية الأساسية لا يمكن أن تتقاطع عبر الثقافات. ويضيف في مقابلته مع مجلة جاكوبين إنه «رغم الاختلافات الثقافية بين شعوب الشرق والغرب، إلا أن هناك أيضاً مجموعةً جوهرية من الاهتمامات المشتركة التي يشترك بها البشر سواء وُلدوا في مصر أو الهند أو مانشستر أو نيويورك. هذه الاهتمامات ليست كثيرة، لكن يُمكننا حصر اثنين أو ثلاثة منها على الأقل: الاهتمام بالصحة الجسدية، الاستقلالية وتقرير المصير؛ ورفاه مادي أساسي. هذا ليس بالأمر الكبير، لكنّك ستُدهَش من مدى تأثيره في تفسير التحوّلات التاريخية المهمّة حقاً».
في أبحاثه، يشير تشيبر إلى أن دراسات التابع و«نظرية ما بعد الاستعمار» تفشل في دعم حجج متبنّيها حول الفاعلية الاجتماعية social agency واعتبار أن الجنوب لا توجد له تطلّعات أو مصالح عالمية متشابهة مع الغرب. «في الواقع، من الأمور التي أُبيّنها في كتابي أن مؤرّخي دراسات التابع، عندما يُجرون أبحاثًا تجريبية على انتفاضات الفلاحين، يُظهرون بوضوح تام أن الفلاحين [في الهند]، عندما ينخرطون في العمل الجماعي، يتصرّفون تقريباً وفقاً لنفس التطلعات والدوافع التي كان يتصرّف بها الفلاحون الغربيون [تحسين ظروفهم المعيشية]» يقول تشيبر في المقابلة ذاتها مؤكداً أنّ الفارق بين الاثنين يكمن في الشكل الثقافي التي تُعبّر بها كلّ فئة عن هذه التطلّعات، لكن هذه التطلّعات نفسها تميل إلى الاتساق.
«نظرية ما بعد الاستعمار» لا تدافع عن الخصوصية الثقافية بقدر ما تُنكر وكالة الطبقات الشعبية في الجنوب العالمي، بحسب تشيبر، إذ تفترض ضمنياً أنّ تبنّي أي مفهوم «غربي» هو بالضرورة استلاب ثقافي. هذا التركيز على «القمع الثقافي» يُنتج صورة للمجتمعات ما بعد الاستعمارية كـ«مفعول بها» ثقافياً، تماماً كما كانت تُصوَّر سابقاً كـ«مفعول بها» سياسياً. وهكذا، يصبح الانخراط في أفكار عالمية كالديمقراطية أو العدالة الاجتماعية تهمةً بالخيانة أو الزيف أو التبعية، لا تعبيراً عن خيارٍ سياسي واعٍ.
إعادة الوكالة كمشروع نضالي
سواء انطلقنا من نقد تايوو للتمثيلات الثقافية، أو من تحليل تشيبر للبنى الاقتصادية، يظل السؤال الجوهري: كيف نعيد للمجتمعات المستعمَرة سابقاً حقّها في الفعل؟ يتقاطع نقد تايوو وتشيبر في التأكيد على أهمية استعادة الوكالة، ليس كمسألة هوية أو رمز، بل كمشروعٍ سياسي وفكري.
يرى تايوو أن السعي إلى تطهير حركة «نزع الاستعمار 2» من جميع بقايا النفوذ الاستعماري تقيّد قدرة الشعوب المستعمَرة على التفاعل النقدي مع الأفكار الغربية وتبنّيها وإعادة صياغتها لتلبية الاحتياجات والتطلّعات المحلّية. هذا الرفض ليس تحرّراً، بل شكل من أشكال التبعية المعكوسة، تُصوَّر فيه مجتمعات ما بعد الاستعمار كأنها لا تملك قدرة التمييز بين الهيمنة والفائدة، وأنها عاجزة عن المشاركة في التبادل الفكري أو السياسي العالمي دون أن يُنظَر إليها على أنها معرّضة للخطر أو فقدان أصلانيتها. كما أنها تُستخدم كأدوات تصنيف أخلاقي: من يتبنّى قيماً «غربية» فهو متواطئ، ومن يرفضها فهو مخلص لهويته. هذه النظرة تُعلي من شأن «النقاء» على حساب «الإمكانية» وتضع المُستعمَر في وضعٍ دائم الاعتماد على التعريف الاستعماري بأنه «حرٌّ فقط عندما لا يمسّه أي تأثير خارجي».
«نظرية ما بعد الاستعمار» لا تدافع عن الخصوصية الثقافية بقدر ما تُنكر وكالة الطبقات الشعبية في الجنوب العالمي، بحسب تشيبر، إذ تفترض ضمنياً أنّ تبنّي أي مفهوم «غربي» هو بالضرورة استلاب ثقافي
يشدّد تشيبر على النقطة نفسها، لكن من زاوية طبقية: تبنّي مفاهيم مثل الديمقراطية أو العقلانية أو الاشتراكية في الجنوب العالمي لا يجب أن يُفهَم كخضوع للغرب أو«تقليد أعمى» للنماذج الغربية، بل كاستجابات استراتيجية وواعية، تعكس خصوصيات محلّية ولكنها بنفس الوقت لا تلغي المشترَك الإنساني. عند إنكار هذه الفاعلية، ما يحصل هو إعادة إنتاج شكل من أشكال الأبوية الفكرية (الشعوب غير الغربية لا تفعل، بل يُفعَل بها) التي تتستّر وراء لغة المقاومة ضد الاستعمار.
ما يعارضه الباحثان ليس نقد الاستعمار، بل احتكاره ضمن سرديات تفرّغ المجتمعات من قدرتها على الفعل الحرّ. من خلال المبالغة في التركيز على الاختلاف الثقافي والتميّز الهوياتي، فإن كلّاً من «نزع الاستعمار 2» والتوجهات السائدة لـ«نظرية ما بعد الاستعمار» تحوّل المجتمعات إلى كائنات تتصرّف كردّة فعل للأبد، دون أي فرصة لإنقاذ نفسها بنفسها.
إنّ تكريس خطاب الضحية أو التماهي مع هوية «أصلية» متخيَّلة ليس حلّاً واستعادة الوكالة لا تعني النقاء بل الاعتراف بأن الهوية متحرّكة وأنّ الفعل السياسي يتطلّب بنى تعليمية واقتصادية وسياسية ترسّخ القدرة على الاختيار والمساءلة والتفكير النقدي. بمعنى آخر، نزع الاستعمار لا يتعلّق فقط بإزالة الرموز والإدانة المتكرّرة للإرث الغربي، بل من المفترض أن يكون مشروعاً فعلياً لاستعادة الفعل التاريخي: القدرة على تأويل الذات وتحديد الأولويات، واختيار ما نريد أن نحمله معنا من الماضي، وما نرغب في تركه خلفنا.
إن أخطر ما في بعض سرديات «نزع الاستعمار» المعاصرة ليس فشلها في تفكيك إرث الاستعمار، بل تجميدها للفاعلية في قوالب ثقافية ضيّقة وخانقة، بدلًا من فتح المجال أمام تعدد الخيارات، تتحوّل هذه السرديات إلى أداة بلاغية مُنفصلة عن التاريخ ومُجرَّدة من سياقه. ما تحتاجه مجتمعات ما بعد الاستعمار هو خطاب يعزّز فاعلية مجتمعات ما بعد الاستعمار وتعقيداتها وتعدّديتها، خطاب يَنظر إليها من خارج ثنائية المفعول به/المُخلص. لعلّ الخطوة الأولى نحو مواجهة الواقع ما بعد الاستعماري، ليست في الإكثار من حديث «نزع الاستعمار»، بل في التحرّر من الأدبيات التي اختزلته في الفروقات بدلاً من التقاطعات المشتركة.