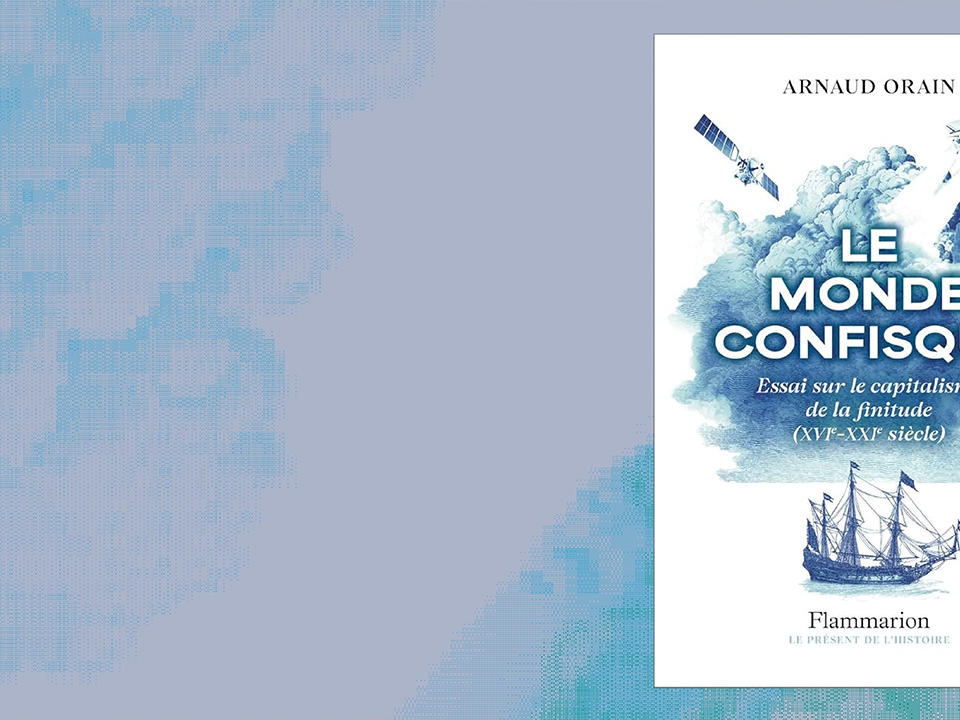الطبقة والتغير الفلاحي في سياق عربي
مراجعة لكتاب عالم الاجتماع البريطاني هنري برنستين «الطبقة والتغير الفلاحي»، الذي يقدّم مقاربة ماركسية غير دوغمائية لفهم التحوّلات البنيوية في العالم الريفي، ويعيد النقاش حول الفلاحين ودورهم في الثورات والتغيير الاجتماعي، خصوصاً في المنطقة العربية التي عانت من تغييب هذا الفاعل التاريخي.
«الطبقة والتغير الفلاحي» هو إصدار جديد اغتنت به المكتبة العربية. الكتاب من تأليف هنري برنستين، (مواليد 9 شباط/فبراير 1945) وهو عالم اجتماع بريطاني وأستاذ فخري لدراسات التنمية في كلية الدراسات الشرقية والأفريقية في جامعة لندن (SOAS). الكتاب من ترجمة عمرو خيري، وصادر عن «سلسلة التغير الفِلاحي والدراسات الفلاّحية»، الصادرة بدورها عن «مبادرات في الدراسات الفلاّحية النقدية».1الكتاب مطبوع في دار المرايا للثقافة والفنون في مصر، بدعم المعهد الدولي TNI وشراكة من شبكة سيادة.
تفسير وتغيير
على الخطى القديمة لكارل ماركس وأطروحته الـ11 عن فيورباخ القائلة «إن الفلاسفة لم يفعلوا غير أن فسّروا العالم بأشكال مختلفة ولكن المهمة تقوم في تغييره»، تنخرط «مبادرات في الدراسات الفلاّحية النقدية» في مشروع ضخم يستهدف تطوير «فهمنا لديناميات التغيير»، بمعنى تأدية دور في إعادة تفسير العالم الزراعي بطرائق مختلفة وتغييره أيضاً، مع انحياز واضح إلى الطبقات الكادحة والفقراء. ومن دون اعتبار ما أنُجز سابقاً كافياً لفهم العالم والإسهام في تغييره، تتبنّى «مبادرات في الدراسات الفلاّحية النقدية» نهجاً غير دوغمائي يعتقد أن لا شيء استجد تحت شمس الرأسمالية والإمبريالية، بل تؤمن أن سيرورة العولمة النيوليبرالية المعاصرة حوّلت «العالَم الزراعي على نحو عميق، الأمر الذي يتطلّب طرائق جديدة في فهم الشروط البنيوية والمؤسسية، كما يتطلب رؤى جديدة في كيفية تغييرها». سيكون للمنهج، وهو نفسه الذي اعتمده برنستين، إفادة عظمى في منطقة تُعتَبر فيها الدوغمائية الفكرية أقرب إلى ديانة رسمية لغالبية التيّارات السياسية والأكاديمية.
استحضارُ لماركس غير دوغمائي
منذ البداية يُعلن هنري برنستين منهجه «إن الاقتصاد السياسي الفِلاحي، والاقتصاد السياسي للرأسمالية بشكل أعم، كما أوظّفه في هذا الكتاب لاستكشاف القضايا والديناميات العريضة، مستلهَم من مقاربة كارل ماركس النظرية». لكن ماركسيته ليست دوغمائية. بالنسبة إليه ماركس لم يقدّم لنا «كل شيء نحتاج إلى معرفته عن الرأسمالية من حيث النظرية ومن حيث التاريخ، ولقد أوضح هو نفسه هذه النقطة».
العولمة النيوليبرالية المعاصرة حوّلت «العالَم الزراعي على نحو عميق، الأمر الذي يتطلّب طرائق جديدة في فهم الشروط البنيوية والمؤسسية، كما يتطلب رؤى جديدة في كيفية تغييرها»
لا يعلن برنستين انتماءه إلى أي مدرسة من مدارس الماركسية المتصارعة طيلة القرن العشرين، فماركسيته منفتحة على منجزات جميع الماركسيين سواء في المركز الإمبريالي أو ماركسيي الجنوب العالمي، وهذا ما يُعطي لإسهامه قيمة نوعية. ويُحسَب له أن نفض الغبار عن اسم ماركسي روسي قديم، كان ضحية الإعدامات في الاتحاد السوفياتي أثناء حقبة الثلاثينيات المُظلمة وهو بريوبرجينسكي ونظريته عن «التراكم البدائي الاشتراكي».2
كتاب صعب؟
هذا ما دبجه برنستين في مطلع كتابه: «هذا كتاب صعب»، شارحاً ذلك بقول: «لكن كيف لنا أن نفهم العالم الذي نعيش فيه بكل تعقيداته وتناقضاته بشكل مبسّط. إن هدفي هو تقديم بعض الأدوات اللازمة للتفكير، وليس أن أقدّم للقرّاء قصصاً أخلاقية قد نجدها جذّابة من منطلقات أيديولوجية. كما أن نقول مثل «الصغير جميل ومقابله الكبير قبيح، دلالة على الفلاحة الفاضلة في مقابل الزراعة الشركاتية الشريرة».
يمكن أن نختلف مع برنستين على أنّ كتابه صعبٌ، فهو في متناول الجميع، خصوصاً بلغته البسيطة واختصاراته البعيدة من الإسهاب. لكن نتفهّم كون الصعوبة ناشئة عن ضرورة اختصار حقب تاريخية تمتد عبر 5 قرون وتشمل كل قارات الكوكب. إلا أنّ الشقّ الثاني من تفسيره مناسب لنا في المنطقة الناطقة بالعربية، حيث اعتدنا على «القصص الأخلاقية التي نجدها جذّابة من منطلقات أيديولوجية». كتاب برنستين ليس مُمتعاً من الناحية «الأخلاقية» ولا يقدّم لنا «رومانسية» ماضوية نجعلها سنداً لتغيير عالم عاصف، لكنه كتاب مُقنِع، يستند على فهم الواقع للتطلّع إلى المستقبل.
تاريخ حافل بالتاريخ
في أحد أعظم انتقادات الفيلسوف السوري الراحل صادق جلال العظم لتاريخ الفلسفة قوله إن «أول وأعظم ما تفتقده تواريخ الفلسفة الكلاسيكية والسائدة هو التاريخ نفسه».3 والمقصود حسب صادق جلال العظم هو افتقاد المنظور التاريخ الجدّي في معالجة موضوعات الفلسفة في عرضها وتفسيرها. ويمكن القول على غراره بأن التاريخ الاقتصادي السائد مليء بكل شيء باستثناء التاريخ، وهو ما لا يفتقده كتاب «الطبقة والتغير الفلّاحي»، فهو لا يضع الأحداث والنظريات حسب تعاقبها الزمني واحدة إلى جانب الأخرى، ولا ينتقي ما يناسبه ليُعطيه شرف الانتماء إلى نادي الأحداث التاريخية الخاص به.
عبر سجال بين مكوّنات ثلاث هي رأس المال التجاري والصناعي/ الزراعي والمالي، والعمل أي طبقات العمّال بكل شرائحها وما يكتنفها من صراعات واختراقات جندرية وإثنية-طائفية، والأرض وكل ما تحيل إليه من حيز مكاني ومردودية وخصوبة وتكنولوجيا وعلاقات اجتماعية، يأخذنا المؤلف في رحلة تاريخية شاملة وجدلية تمتدّ على مدى زمني طويل جداً، من القرن الـ15 حتى القرن الـ21، وكل ما عرفته من تطورات اقتصادية وثورات، اجتماعية كانت أو سياسية أو صناعية، رحلة تشمل كل قارات العالم.
أدوات للفهم والتغيير
هذه الشمولية مقصودة من طرف المؤلف، فهي بالنسبة إليه ضرورية لغاية الكتاب «فهم العالم لتغييره». النظرة الشمولية ضرورية في عصر التشظي المتصاعد ضمن جميع فروع العلم، بما فيها العلوم الاجتماعية، وهو ما نبّه إليه الكاتب العراقي عصام الخفاجي في أحد أكثر كتبه قيمة: «ولادات متعسرة»، بقوله «التخصص المتعمّق في ميادين محدّدة بالضبط، وهو أمر مطلوب وضروري لتطور العلم والمعرفة، لكنه يهدّد بنسيان الصورة الأشمل إن لم يترافق مع نظرية أو أبحاث تضع الجزء، الذي نتعرف إليه بشكل أعمق بفضل هذا التخصص، ضمن الإطار الأوسع الذي يتغير ويتطوّر هو أيضاً بسبب الاكتشافات في ميادين التخصّص هذه».4
لا يمكن تغيير العالم من دون فهمه. على الرغم من بديهية الفكرة، فإنها تجد صعوبة في سياق عربي مليء باليقينيات الأيديولوجية وحتى بعض أمارات الإيمان السحري وعبادة الشخصية، موروثة عن حقب خلت. يقول برنستين: «تواجه تحدياتُ التعقيد من حيث الممارسة أعمالَ النشطاء المعنيين بمحاولة بناء سياسات تقدّمية للتغيير الفلاحي على جميع نطاقاته، من المحلي إلى أقصى درجة وحتى العالمي والكوكبي. ولتحقيق هذه الغاية، لا تكفي على الإطلاق الشعارات البرّاقة وقائمة بأسماء الأبطال والأشرار».
لا يمكن تغيير العالم من دون فهمه. على الرغم من بديهية الفكرة، فإنها تجد صعوبة في سياق عربي مليء باليقينيات الأيديولوجية وحتى بعض أمارات الإيمان السحري وعبادة الشخصية
للقيام بمهمّتيْ الفهم والتغيير، يقدّم كتاب برنستين طيفاً واسعاً من أدوات التحليل والفهم مثل: الرأسمال والأرض والعمل، الفائض والاستغلال والتراكم والإنتاجية والمردودية وفائض القيمة (النسبي والمطلق)، إعادة الإنتاج الموسّعة والبسيطة...5 النظام الغذائي الدولي والحمائية والتجارة الحرة... إلخ.
إغناء للنقاش عربياً
ليس هدفنا في هذه المقالة تقديم تعريف بالكتاب بحد ذاته، بل إظهار مدى أهمية تعريبه في الإسهام بالدفع بالنقاش عن التغيير الفلاحي في المنطقة الناطقة بالعربية، أو بالأحرى إعادة إحياء هذا النقاش الذي جرى دفنه منذ عقود. بعد هزيمة حركة التحرّر الوطني عربياً وانهيار المعسكر المسمى «شرقياً/شيوعياً»، عاتت الأيديولوجية النيوليبرالية خراباً في وعي شعوب المنطقة. وعِوَضَ الهويات الجمعية وبدائل التحرّر والخلاص الجماعي التقدّمية واليسارية، حلّت بالمنطقة أيديولوجية الفرد الاقتصادي الذي يحسب ويتخذ قراراته عقلانياً بما يُعظم إيرادَه ويقلّل خسارته، وفي وجهها قامت ردود فعل جماعية، لكنها نكوصية، تعتمد الجماعة-الدينية أو الطائفية أو الاثنية/الثقافية/اللغوية.
يساعد الكتاب على استعادة واستئناف النقاش القديم في شروط جديدة، لكن يبقى المفهوم الرئيسي هو ذاته: «الطبقة» في مواجهة أيديولوجية «الفرد» الاقتصادي. وهذه هي بالذات النصيحة التي أنهى به برنستين كتابه: «لا بد للحركات الناشطة أن تحلّل بفعالية الحقائق الاجتماعية المعقّدة والمتناقضة التي تسعى لإحداث تحوّلات كبرى في العالم. في العالم الرأسمالي، يجب أن يكون فهم ديناميات الطبقة دائماً نقطة الانطلاق والعنصر الأساسي في مثل هذا التحليل».
ثورة من دون فلاحين لمنطقة من دون فلاحين؟
«انقرض الفلاحون في مصر»، «الريف المتروك»، جمل توحي بأن المنطقة فعلاً أصبحت بلا فلاحين. وقد يوحي بهذا الاستنتاج سياساتُ «التحيز الحضري» التي كانت في أساس التجارب الإنمائية بعد موجة استقلالات المنطقة في النصف الثاني من القرن العشرين، التي اعتمدت التصنيع وتضخيم القطاع الثالثي وتشجيع ظهور برجوازية فلاحية، وبرامج إصلاح زراعي لم تستهدف القضاء النهائي على المِلكية العقارية الكبيرة بل إنماء برجوازية زراعية.
يُلقي كتاب برنستين ضوءاً كاشفاً على مسألة «نهاية الفِلاحة والفلاّحين». ويُقدّم تنويعات تخترق الفلاحين بعد إدماجهم في الدائرة الواسعة للرأسمالية والاقتصاد النقدي و«تسليع الكفاف». ويطرح أسئلة تستوجب توطينها عربياً والإجابة عنها نظرياً وتجريبياً، بدل الاستنتاجات المتسرّعة عن «انقراض الفلاح». ومن هذه الأسئلة: «هل التسليع الجاري والآخذ في الاشتداد للكفاف في ظل الأحوال الجارية للعولمة، والذي يصل إلى ذروته في فقدان قدرة استغلال الأراضي وانتهاء الفلاحة صغيرة النطاق، أقول هل هو تسليع أكثر شمولاً من مثيله في الماضي؟ هل تمثل العولمة ذروةً ما في عملية عالمية للقضاء على الفلاح، كانت حتى الآن ماضية في طريقها بشكل لامتكافئ وغير كامل عبر مختلف الأوقات والأماكن في نطاق تاريخ الرأسمالية؟».
«نهاية الفلاحين» تجد مسوغاً آخر لها في «غياب» الفلاحين كطبقة في سيرورة الثورات الإقليمية التي شهدتها المنطقة الناطقة بالعربية منذ العام 2011. ليس غريباً أن أهم مؤلّفين صادرين عن ماركسيين عربيين، هما «الشعب يريد» (2013) لجلبير الأشقر و«جذور الغضب» (ترجمة عربية 2020) لآدم هنية، خاليين من أي إشارة إلى الفلاحين. لكن هناك مقالات عدّة تتناول الموضوع من وجهات نظر مختلفة. صدر مقال لمحمد سامي الكيال تحت عنوان «سوريا: ثورة الفلاحين الذين لم يعودوا كذلك»، وآخر لصقر النور تحت عنوان «الفلاحون والثورة في مصر: فاعلون منسيون».
بعد أن أدرج سامي الكيال واقع طبقة الفلاحين في سوريا مستنتجاً: «الفلاحون أصبحوا منذ زمن أقلية غير مؤثرة اقتصادياً في البلاد»، ودور «الجفاف والسياسات الزراعية الكارثية للنظام السوري» التي أدت إلى «نزوح حوالي مليون ونصف مواطن من المناطق الريفية إلى المدن في سنوات ما قبل الثورة»، خلص إلى ما يلي: «إلا أن هذا لم يكن عاملاً حاسماً في انفجار الوضع في البلاد، ولا يوجد ما يؤكد أن هؤلاء النازحين قد قاموا بدور فعال في الحراك الثوري، كما لم تُرصد أي شعارات أو مطالب في سياق الثورة تتعلّق بأوضاعهم».
عاتت الأيديولوجية النيوليبرالية خراباً في وعي شعوب المنطقة. وعِوَضَ الهويات الجمعية وبدائل التحرّر والخلاص الجماعي التقدّمية واليسارية، حلّت بالمنطقة أيديولوجية الفرد الاقتصادي
في مقال نشرته شبكة سيادة تحت عنوان «الفلاحون والثورة المستمرة»، تحدث أحمد وجدي عن سعي الفلاحين إلى تأسيس «نقابات مستقلة تعبر عن مطالبهم الحقيقية بعيداً من نقابة الفلاحين الرسمية التي ترعاها الدولة»، منبّهاً إلى أن الحراك الفلاحي المرتبط بالثورة لم يقتصر على التنظيم النقابي، بل تعداه إلى مشاركة «الفلاحين في مئات المظاهرات والمسيرات الاحتجاجية وارتفعت رايات المطالب الفلاحية القديمة مرة أخرى». وفي مقالة بعنوان «الفلاحون والثورة، استعادة الأرض» تتحدّى معتز ياسمين «الاقتناع الشعبي الذي يفيد بأن الريف المصري هو الحصن، أو الخزّان الاستراتيجي للثورة المضادة».
يساعد كتاب برنستين على تبصّر أشكال المقاومة سواء الملحوظة التي يسمّيها «بطولية على نطاقات كبيرة»، أو «صغيرة وهادئة الوتيرة»، مشيراً إلى حركات فلاحية عالمية ضد العولمة النيوليبرالي وإضفاء الطابع الشركاتي على الفلاحة، مثل «نهج الفلاحين-لافيا كامبسينيا». لكن لحدود اللحظة، لم يستطع الفلاحون في المنطقة العربية إرساء بنية تحتية قادرة لحركات فلاحية دائمة في الزمان ومنتشرة في المكان، وتقتصر على لحظات الاندلاع والاشتباك الكبرى، مثلما حدث في العام 2011.
4 أسئلة وسؤال واحد
لعل تفسير ذلك يُعزى بالدرجة الأولى إلى السؤال الجوهري المطروح في المنطقة العربية منذ النضال ضد الاستعمار. بالنسبة إلى برنستين يثير الاقتصاد السياسي 4 أسئلة أساسية وهي: من يملكون ماذا؟، من يفعلون ماذا؟، من يحصلون على ماذا؟، ماذا يفعلون بماذا؟. وهي بالنسبة إليه أسئلة «تخصّ العلاقات الاجتماعية للإنتاج وإعادة الإنتاج».
لكن في المنطقة العربية يظل السؤال الرئيسي هو: من يحكم؟. لذلك تصدّر شعار «إسقاط النظام» الثورات التي عرفتها المنطقة منذ العام 2011. طبعاً هناك شعارات أخرى مثل «عيش»، «عدالة اجتماعية»، لكنها ظلت ثانوية أمام المسألة التي اعتُبرت رئيسة وهي مسألة السلطة السياسية، من دون إقرانها بالنظام الاقتصادي والاجتماعي الذي تخدمه السلطة الساعي لإسقاطها، وتلك المراد بناؤها.
انعكس هذا أيضاً في التركيبة الطبقية للثورة التي نالت الاهتمام الإعلامي، حتى من طرف كتاب لا يتحرّجون من إعلان انتمائهم اليساري/الماركسي. وهذا ما أدّى إلى سيطرة النخب المدينية، وقد أكّد عليه صقر النور في مقاله المنوه به أعلاه، بقوله «يشير جاك قبانجي إلى تمركز النماذج الفكرية المسيطرة في العلوم الاجتماعية بشكل عام، والسياسية منها بشكل خاص، في رؤيتها لمركز الفعل والتغيّر في السلطة السياسية والنخبة، وأحياناً الطبقة الوسطى، الأمر الذي يقوّض من فرص فهم وتحليل الديناميات الاجتماعية في إطار أوسع. وتشكّل هذه القراءة الحضرية واللحظية للثورة المصرية عائقاً أمام قراءة وفهم وتحليل مدى وجود دور للفلاحين في الثورة المصرية من عدمه». وهو أمر أكّد عليه برنستين بدوره، في تناوله للسوسيولوجيا الاقتصادية والسوسيولوجيا السياسية: «هناك قضية محورية في السوسيولوجيا السياسية للطبقات (المتشظية) للعمّال، وردت في ملاحظة ماماداني بأن «ترجمة الوقائع الاجتماعية إلى حقائق سياسية هي عملية مرتبطة بتقلبات الصدف وغير قابلة للتنبؤ. هذا بسبب السبل العديدة لكيفية قيام السلطة بتكسير وتشويه ظروف وخبرات المضطهَدين». وفي مقال منشور على موقع المعهد الدولي (TNI) بعنوان «الثورة السورية وسياسة الخبز»، يشير ياسر منيف على دور السلطة هذا، بقوله «لتجنب تكون حركات اجتماعية مستقلة، أنشأ النظام أيضاً الاتحاد العام للفلاحين في العام 1964. قاد الاتحاد موالون للبعث وأُدير بصيغة الإدارة الهرمية، أي من أعلى إلى أسفل، ومن دون الأخذ بآراء الأعضاء. وكان الاتحاد أداة فعّالة لتوسيع انتشار الدولة، والحد من استقلالية الفلاحين، وإبقاء رقابة لصيقة على نشاطهم السياسي».
وربما يكون لسياسات الإصلاح الزراعي التي سنتها الأنظمة القومية في خمسينيات وستينيات القرن العشرين دور كبير في هذا، إذ ظهرت هذه الأنظمة كمناصرة للفلاحين (وعموم البرجوازيين الصغار)، وهي واقعة أثبت عصام الخفاجي حدودها التاريخية في كتابه «ولادات متعسّرة»، بتأكيده أن تلك الأنظمة كانت مولّدة لرأسمالية ناشئة، وبالتالي ما كان كل البرجوازيين الصغار (بما فيهم الفلاحون) متاحٌ لهم إمكانُ الصعود الطبقي. لكن وجود ذلك الاحتمال، متضافراً مع القمع السياسي الشديد، أثر على وعي الفلاحين.
تحدّث برنستين أثناء استعراضه للسوسيولوجيا السياسية عن صراع مزدوج؛ هو «الصراع على وعي الطبقة» السابق «للصراع بين الطبقات»، مشيراً (باستحضار حالة الهند) إلى أن الغالبية العظمى من الطبقات العمالية... «لا تزال مشتبكة في الصراع الأول» على الطبقة، يتيح لنا هذا فهم غياب «طبقات العمّال»، بمن فيها الفلاحون عن سطح الحياة السياسية أثناء الثورة، وهو ما أسماه صقر النور: «فاعلون منسيون».
بعث نقاش قديم
لمفهوم «البعث» مكانة في المخيال العربي، سياسياً وأدبياً. يتيح لنا كتاب برنستين بعث نقاش قديم عن انتقال المنطقة العربية من الإقطاعية إلى الرأسمالية. وكان هذا النقاش قد قام بين كتاب يصرون على فرادة مسار الشرق (أمثال سمير أمين)، وآخرين يستبعدون فكرة الفرادة والخصوصية تلك (عصام الخفاجي من العراق، والهواري عدي من الجزائر).6
يستحضر برنستين مرة أخرى روح ماركس للتأكيد على أن «الرأسمالية - وعلى وجه الخصوص الرأسمالية الصناعية - هي «تاريخ-عالمية» في طبيعتها وعواقبها، أي تحقّقت في سياق التاريخ العالمي. ليس هناك أي شيء طبيعي أو حتمي في ظهورها كنمط إنتاج جديد وثوري، لكن ما إن فرضت منطقها الفريد من نوعه للاستغلال والتراكم، والمنافسة والتطور المستمر لسعة الإنتاج، حتى فرضت نفسها على جميع مناطق العالم».
لم يستطع الفلاحون في المنطقة العربية إرساء بنية تحتية قادرة لحركات فلاحية دائمة في الزمان ومنتشرة في المكان، وتقتصر على لحظات الاندلاع والاشتباك، مثلما حدث في العام 2011
في النقاش القديم، كان سمير أمين حريصاً على تأكيد فرادة الشرق، مُحْدِثاً مفهوم «نمط الإنتاج الخراجي». وفي شمال أفريقيا تحدث آخرون عن «النظام الزعماتي/ القائدي»، لكن إصراره على الفرادة والاستثناء، دفعه إلى اختزال كل التطور التاريخي إلى استثناءات،7 ما ينفي إمكانية تصور مادي للتاريخ يمكن من خلاله التعميم الذي يُعتبر أحد أسس علم الاجتماع. أما عصام الخفاجي فكان على النقيض من ذلك يؤكد أن هدفه هو «البرهنة على عدم تفرد مسارات العالم الثالث نحو الحداثة، ما يعني ضمنياً عدم فرادة مسار أساس المقارنة (الذي هو أوروبا) نحو الحداثة». وكان صُلب هذا النقاش هو التغير الفلاحي ومسألة الأرض. يستند سمير أمين، لتأكيد انعدام الإقطاعية في الشرق، على استمرار مِلكية الجماعة الفلاحية للأرض، بينما ينفيها في النظام الإقطاعي الأوروبي حيث تفقد الجماعة الفلاحية الملكية المباشرة للأرض. بينما يجيب عصام الخفاجي باستحضار مثال من الشرق هو الإمبراطورية العثمانية، مميزاً بين «الملكية القانونية» التي تعود للدولة/السلطان، و«الحيازة الفعلية» التي تكون بيد الفلاحين وهو أمر عرفته أوروبا الإقطاعية أيضاً، حسب الخفاجي.
ليس هذا محض نقاش قديم، فآثاره تمتد إلى الحاضر وإن كانت مغيّبة، فذلك لا ينفي أهميتها وراهنيتها، في منطقة لا تزال ترزح تحت تبعية للإمبريالية ونمطيات خاصة بالرأسمالية في المنطقة العربية، حسب تعبير جلبير الأشقر في كتابه «الشعب يريد».
لنفهم منطقتنا كي نتمكّن من تغييرها
كتب برنستين في مطلع كتابه إن «أمل المؤلف الوحيد دائماً هو أن يجد القراء في كتابه ما يكفي من أسباب الفهم والاهتمام والاستفزاز للأفكار، لكي يفكروا في ما يطرحه الكتاب ويسعون بعد قراءته نحو المزيد من المعرفة والتفكير لما طُرح من موضوعات وأفكار». وإن أكبر رد جميلٍ لبرنستين من طرف القراء والقارئات العرب، ليس فقط التأمل في ما طرح من موضوعات وأفكار، وإنّما استلهام أدوات التحليل والفهم التي اعتمدها من أجل فهم واقع منطقتنا والإسهام في تغييرها.
- 1
جماعة عالمية النطاق من الباحثين المتقاربين في التفكير وممارسي التنمية والناشطين الذين يعملون على قضايا زراعية.
- 2
من الأخطاء الشائعة في الترجمات العربية «التراكم البدائي»، حتى ترجمة كتاب برنستين «الطبقة والتغير الفلاحي» تضمّن هذا الخطأ الشائع.
- 3
صادق جلال العظم (1990)، «ثلاث محاورات فلسفية، دفاعاً عن المادية والتاريخ، مداخلة نقدية مقاربة في تاريخ الفلسفة الحديثة والمعاصرة»، دار الفكر الجديد، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى، ص. 17- 18.
- 4
عصام الخفاجي (2013)، «ولادات متعسرة، العبور إلى الحداثة في أوروبا والمشرق»، المركز القومي للترجمة، الهيئة العامة المصرية للكتاب، القاهرة، الطبعة الأولى.
- 5
وردت في الكتاب كالآتي: «إعادة الإنتاج الموسّع والبسيط»، والأصح هو «الموسّعة والبسيطة»، لأن النعت هنا يعود على الإعادة وليس الإنتاج.
- 6
عدي الهواري (1983)، «الاستعمار الفرنسي في الجزائر، سياسة التفكيك الاقتصادي الاجتماعي 1830- 1960»، ترجمة جوزف عبد الله، دار الحداثة، بيروت - لبنان، الطبعة الأولى.
- 7
سمير أمين (1978)، «التطور اللامتكافئ، دراسة في التشكيلات الاجتماعية للرأسمالية المحيطية»، ترجمة برهان غليون، دار الطليعة، بيروت - لبنان، الطبعة الثانية.