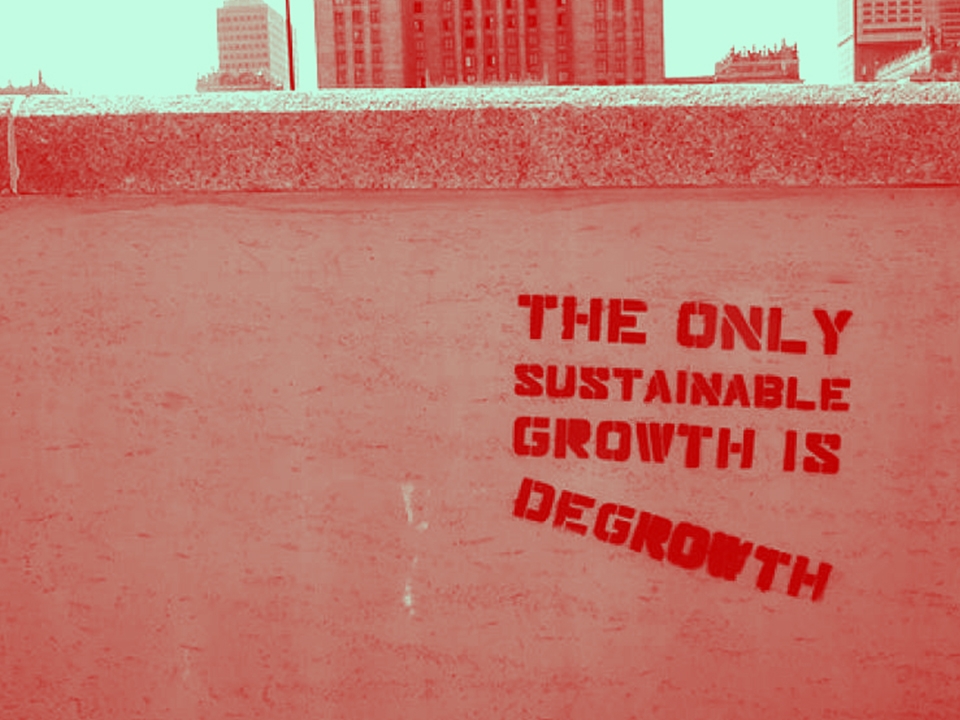خفض معدل الإنتاج من دون التضحية بالفقراء؟
تطمح النظريات غورز إلى إعادة بناء النموذج الاقتصادي والعلاقة مع العمل، فضلاً عن تحرير الأفراد. ويميل هذا المشروع السياسي إلى حلّ التناقض المتأصِّل في الرأسمالية، وهو النمو اللانهائي في عالم محدود بطريقة غير مالتوسية.
إن الهدف الوحيد للاحتياجات هو التفرقة الاجتماعية والطبقية، التي تعتبر العنصر الحديث من التمييز البرجوازي. وبالتالي فإن الأفق الوحيد للمجتمع الرأسمالي هو مشروع الاستهلاك المفرط إلى نقطة اللاعودة.
هل نحن محكومون بالاختيار بين النمو المستنزف لموارد الكوكب وبين تراجع الإنتاج الذي يضحّي بالفقراء؟ يقود الخيار الأول إلى انهيار المجتمعات الغربية، ويؤدي الثاني إلى انخفاض أكبر لمستوى معيشة الأشخاص الأكثر فقراً، الذين وقعوا بالفعل ضحايا النمو البطيء الناجم عن النيوليبرالية. ومن المألوف في عالم الإعلام إلقاء اللوم على استهلاك المواطنين، والتفكير في أدوات سياسية لتقييده أو إعادة توجيهه من دون قول كلمة واحدة عن البنيات الإنتاجية أو ديناميات تراكم رأس المال التي أضفت طابعاً مؤسسياً على هذا الاستهلاك الشامل الضخم. إنها إحدى المزايا العظيمة لفلسفة المفكّر أندريه غورز.
في خلال مؤتمر الأمم المتحدة للتغير المناخي 2021 (COP-26)، اجتمعت القوى العالمية الرئيسة، باستثناء الصين وروسيا، لمكافحة تغير المناخ. لم تجتمع تلك القوى بسبب رغبة خيرة في تغيير العالم. بحلول العام 2030، سوف ترتفع درجة الحرارة بمقدار 1.5 درجة مئوية، وتجاوز تلك الدرجة قد يؤدي إلى عواقب كارثية. يبدو التغيير الجذري للنظام هو الحل الوحيد للحدّ من الآثار الضارّة لأزمة المناخ.
يبدو إذاً تراجع النمو الاقتصادي كأحد المسارات المحتملة. وكان يُنظر إليها سابقاً على أنها علامة على «العودة إلى العصر الحجري»، ودلالة على كراهية التكنولوجيا ومعاداة الحداثة. على الرغم من ذلك، استطاعت تلك الفكرة أن ترسّخ نفسها في السنوات الأخيرة في المشهد السياسي والإعلامي، وأصبحت موضوعاً يصعب تجاهله عندما يتعلّق الأمر بالمسألة البيئية. في خلال الانتخابات التمهيدية داخل الحزب البيئي الفرنسي (EELV)، كان تراجع النمو الاقتصادي أحد الموضوعات البارزة في المناقشات بين المرشحين، ما جعلها تدريجياً ذات مصداقية في أعين الفرنسيين.
وكما كشف استطلاع أجرته مؤسسة أودوكسا في كانون الأول/ديسمبر 2019 لصالح منتدى رجال الأعمال الفرنسيين، الـ MEDEF، فإن 67% من الفرنسيين يؤيدون تراجع النمو الاقتصادي، الذي يمكن تعريفه بـ«خفض إنتاج السلع والخدمات للحفاظ على البيئة لصالح الإنسانية». تمثل هذه البيانات تقدّماً ملحوظاً في الرأي العام، ولكن يعتبر هذا الفهم للتراجع الاقتصادي مختزلاً مقارنة بالثراء النظري للمفهوم. لذلك، تسمح نظريات أندريه غورز أخذ ذلك بالاعتبار إذ ينبغي أن نفهم تراجع النمو باعتباره مشروعاً اجتماعياً ذو بعد عالمي، كما تطمح النظريات غورز إلى إعادة بناء النموذج الاقتصادي والعلاقة مع العمل، فضلاً عن تحرير الأفراد. ويميل هذا المشروع السياسي إلى حلّ التناقض المتأصِّل في الرأسمالية، وهو النمو اللانهائي في عالم محدود بطريقة غير مالتوسية.
التحليل التاريخي للرأسمالية وأصل أسطورة النمو اللانهائي
يتبنّى أندريه غورز وجهة نظر ماركسية. ويرى أن نشأة الرأسمالية هي نتاج علاقة طبقية، ويعطي اهتماماً كبيراً لعلاقات الإنتاج. تعتبر رؤية غورز مفيدة وتساعد في التحليل خصوصاً في وقت يتهم فيه من يؤيدون تراجع النمو الاقتصادي على قنوات التلفزيون أنّ سبب الدمار البيئي هو الاستهلاك، إذ يستهدفون النزعة الاستهلاكية من دون أن يقولوا أي شيء عن النظام الإنتاجي وديناميات تراكم رأس المال التي أضفت عليه طابعاً مؤسسياً.
تم التنظير لعلاقات العمل من خلال قاعدة الاكتفاء بين التجّار والعمّال. وكان الحل الوسط يتلخّص وفق هذا المبدأ الفعّال بتحقيق «كسب كافٍ للحرفي، وربح كافٍ للتاجر»
في مجلة «الإيكولوجيا السياسية بين حكم الخبراء وتقييد الذات» (Actuel Marx n°12, 1992)، يتتبع أندريه غورز تاريخ الرأسمالية ويؤكد على الانقلاب الأساسي الذي أحدثه نمط الإنتاج الرأسمالي فيما يتعلق بالعلاقة بين العمل والإنتاج. وبالفعل، قبل الثورة الصناعية التي أدّت إلى مكننة أدوات الإنتاج، لم يكن العامل، بالنسبة إلى ماكس فيبر: «يسأل نفسه كم يمكن أن يكسب في اليوم إذا قام بأكبر قدر ممكن من العمل؟ ولكن كان يسأل نفسه: كم يجب أن أعمل لأحصل على المال الذي حصلت عليه سابقاً ويغطّي راهناً الاحتياجات الحالية؟». تم التنظير لعلاقات العمل من خلال قاعدة الاكتفاء بين التجّار والعمّال. وكان الحل الوسط يتلخّص وفق هذا المبدأ الفعّال بتحقيق «كسب كافٍ للحرفي، وربح كافٍ للتاجر». من هنا، لم يكن العمّال ملزمين بحد أدنى مُعيّن من العمل.
هذه الحرّية في العمل التي يتمتّع بها العمّال ويلاحظها فيبر وغورز، وسبقت مكننة أدوات العمل، كانت متناقضة مع مصالح الرأسماليين الذين يريدون تضخيم أرباحهم. إن عدم التوافق بين معيار ما هو كاف، ونموذج عمل العمّال، والرغبة للإثراء اللانهائي عند الرأسماليين، أدّى إلى ظهور الحاجة إلى تصنيع الإنتاج. سمحت هذه القفزة التكنولوجية للرأسماليين بالسيطرة، وبالتالي «انتزاع السيطرة على وسائل الإنتاج» من أيدي العمّال وفرض «تنظيم وتقسيم العمل الذي سوف يُملى عليهم من خلاله طبيعة وكمية وكثافة العمل الذي سيتم تقديمه». إن منطق التراكم الرأسمالي ذاته يعارض قاعدة الاكتفاء، لأنه يمنع الرأسماليين من إنتاج المزيد من السلع كون العمّال يستطيعون إذا رغبوا في ذلك، العمل بالحد الأدنى لتلبية الاحتياجات الأساسية. وفي هذه الحالة، سيصبح إنتاج السلع محدوداً للغاية، وكذلك الأرباح. لذلك، يجب على الرأسماليين إيجاد طريقة لجعل العمّال خاضعين. حدث ذلك مع الثورة الصناعية، التي فرضت «استلاب ثلاثي» على العمّال.
حدث هذا «الاستلاب الثلاثي» عن طريق بداية مكننة أدوات الإنتاج والتي حرمت العمّال من كل الحرية في عملهم. إن الاستلاب الأول هو جعل العامل غير قادر على امتلاك عمله. تقول لدانييل لينهارت، عالمة اجتماع تدرس مجال العمل: «نماذج تنظيم العمل سعت دائماً إلى تجريد العاملين من معارفهم المهنية». وتحدث عملية السلب هذه، خصوصاً في صناعة السيارات، من خلال «التكرار الموحّد» (بحسب تيري بيلون) لأفعال العامل.
هذا «الاستلاب الثلاثي» جعل التنظيم العلمي للعمل مُمكناً. وفي هذا الصدد، أكد فريدريك وينسلو تايلور أن المعرفة قوّة. ويجب أن نفهم المعرفة هنا بأنها جميع المهارات الفنية التي يكتسبها العامل في سياق عمله، ما يعني أنه يستطيع تنفيذ معرفته من أجل استخدامها في سياق معيّن. وقد أدى تقسيم العمل على وجه التحديد إلى توزيعه، إذ لا يستطيع أي عامل فهم الأداء العام للآلات. وفي الوقت الحاضر، يُنسب هذا الدور إلى حدّ كبير إلى المديرين الذين يوجّهون عمل فرقهم.
إن شرط تجريد العامل من عمله، عندما يتحقّق، يسمح بإنتاج فائض اقتصادي لا يستمد منه العمّال أي فائدة. ولم يعد رأي أو قرار العامل قائماً على ما يراه جيداً من حيث الكمّية أو النوعية مما يجب إنتاجه. فيصبح منفّذاً فقط للأوامر، ضحية لعملية الاغتراب الموضوعي، إذ يحرمه مديرينه صراحة من الوسائل اللازمة لإتقان خصوصيات وعموميات عمله.
من هنا بدأت الرأسمالية حقّاً، من هذا الوضع الأولي، في افتراس الطبيعة. يمكن فهم عمل غورز على أنه نقد مباشر موجّه إلى من يؤيّدون تقليص النمو الاقتصادي، الذين يدينون النزعة الاستهلاكية من دون أن يقولوا كلمة واحدة عن نمط الإنتاج السائد. يرى غورز أن الإفراط في الاستهلاك هو نتيجة للإفراط في الإنتاج وليس نتيجة لممارسة ثقافية تستحق الإدانة الأخلاقي. فبدلاً من توجيه أصابع الاتهام إلى التصرفات الفردية وتشجيع الناس على تقييد الاستهلاك، علينا أن ننتقد الهياكل الإنتاجية.
أعمل أكثر، استهلك أكثر
يُعدّ نقد الاحتياجات التي أفسدتها الرأسمالية موضوعاً مركزياً لدى أندريه غورز. إن الاحتياجات في العصر الرأسمالي هي القوّة الدافعة وراء الاستهلاك المفرط للسلع والخدمات، ومعظمها لها قوّة مدمّرة للغاية على الطبيعة، بالإضافة إلى كونها عديمة الفائدة. إن الهدف الوحيد للاحتياجات هو التفرقة الاجتماعية والطبقية، التي تعتبر العنصر الحديث من التمييز البرجوازي. وبالتالي فإن الأفق الوحيد للمجتمع الرأسمالي هو مشروع الاستهلاك المفرط إلى نقطة اللاعودة.
يرى أندريه غورز أن قبل الثورة الصناعية، كان إنتاج السلع والبضائع يهدف إلى تلبية احتياجاتنا الطبيعية. لكن أدى ظهور المكننة الصناعية إلى انقلاب هذه البنية، بحيث لم يهدف إنتاج السلع إلى تلبية الاحتياجات الأساسية، لأن تولد الرأسمالية احتياجات جديدة. منذ ذلك الحين، أصبحت الرأسمالية مدفوعة بحلقة من الاحتياجات بأثر رجعي، إذ يصبح المنتج نتيجة لخلق حاجة جديدة من قبل الرأسمالية. هكذا يخلق النظام الرأسمالي أصل أسطورة النمو اللامتناهي، الضروري حتى يعمل النظام الرأسمالي ككل بشكل سليم.
لا يمكن لمجتمع الاستهلاك المفرط هذا أن يوجد إلّا على أساس طبقة من العمال المستهلكين. ويُطلب من العمال، الخاضعين لتنظيم علمي للعمل، احترام كمية معينة من العمل في الساعة. ويدرك أصحاب العمل هذا جيداً، إذ أنهم مدفوعين بهوس التحكّم في وقت عمل عمّالهم.
يفضّل دائماً أصحاب العمل منح إجازات بدلاً من تقليل ساعات العمل. ومن وجهة نظر غورز، فهذا ليست صدفة. ينبغي فهم الإجازات على أنها «انقطاع مخطّط للحياة النشطة»، وتشكّل الوقت المثالي للاستهلاك. من ناحية أخرى، يمثل تقليل ساعات العمل خطراً على أصحاب العمل، لأنها تمنح لأفراد الطبقات العاملة الفرصة لإثراء حياتهم اليومية من خلال المشاركة المجتمعية أو السياسية أو النقابية أو الثقافية التي قد تكون ثورية. على العكس، فإن العمل بدوام كامل يحد ميكانيكياً من المشاركة في هذه المجالات. من هنا تم تحديد نموذج العامل-المستهلك الذي ليس لديه سوى الوقت للعمل والاستهلاك.
تقليل النمو الاقتصادي كفلسفة لتحرّر الإنسان
إن خفض أو تقليل النمو الاقتصادي هو مشروع للانفصال عن الرأسمالية، استناداً إلى النتائج التي توصل إليها تقرير ميدوز بعنوان «حدود النمو الاقتصادي». كما يشير عنوانه، يكشف هذا التقرير للمرة الأولى عن الضرر الفظيع اللا رجعة فيه الذي تسبّبه الرأسمالية للطبيعة. دعا دونيلا ودينيس ميدوز في العام 1972 إلى تغيير جذري في النظام الاقتصادي، وإلا فإن البشرية سوف تتجه مباشرة نحو انهيار مجتمعاتنا الحديثة، وهما يقول هنا: «لا ينبغي أن نفهم الانهيار هنا بأنه نهاية البشرية، بل بمعنى التخفيض العنيف لعدد السكان المصحوب بتدهور كبير في الظروف المعيشية».
يبدو أن تقليص النمو الاقتصادي من دون فترة إنتقالية يمثل تحدياً كبيراً. وفي سياق النظام الرأسمالي فإن دينامية التقليص النمو من شأنها أن تؤدّي إلى تدمير عدد كبير من الوظائف، وستؤدي أيضاً إلى زيادة الفقر
إن كوكب الأرض، بسبب حدودها الفيزيائية والبيولوجية، لا تستطيع أن تتحمّل النمو اللانهائي المقترن بالنمو الديموغرافي المفرط. إن تقرير ميدوز في جوهره عبارة عن حثّ على الرصانة الاقتصادية، عنصر أساسي في تقليل النمو الاقتصادي، وهو ما يوضحه المثل الشهير: «الأفضل يمكن أن يكون أقل». يستخدم أندريه غورز هذه الصيغة ليدعو إلى تقليل وقت العمل بالإضافة إلى تقليل الاستهلاك.
ولكن تلخيص تعريف تراجع النمو الاقتصادي إلى هذا الجانب الأخير يعتبر خطأ في الفهم، ويرى غورز أن الأمر لا يتعلّق بتقديم تضحيات مادية بقدر ما يتعلّق بالتخلّص من احتياجات غير ضرورية، لصالح أنشطة أكثر جوهرية، بما في ذلك «المشاركة في الحياة الاجتماعية».
ولذلك، نفهم لماذا يرى غورز الرأسمالية كنظام يستعبد الإنسان ويدمّر التنوّع البيولوجي والحيوي.
الدخل الأساسي الشامل أم ضمان العمل؟
أيد أندريه غورز «الحق الغير مشروط في الدخل الأساسي»، إذ يراه مقدّمة لتحرر الأفراد1. ويزعم غورز أنه تردّد لفترة طويلة قبل أن يدعم مثل هذا التحول، إذ يبدو أن الفكرة قد تم استباقها من قبل التيارات الليبرالية لفترة طويلة. إنه إجراء يدعمه، على سبيل المثال، المفكر الأميركي جون راولز، الذي يرى أن العمل «سلعة» يجب تقديمه لجميع الأفراد باسم مبدأ العدالة الاجتماعية.
لكن يرفض أندريه غورز التفكير في العمل باعتباره «سلعة». بالنسبة إليه، العمل مجرّد وسيلة ضرورية لتحقيق غاية، وهي تلبية احتياجاتنا الأساسية. وباعتباره «نشاطاً ضرورياً» فهو يمنح، وفقاً لغورز، الاعتراف المجتمعي عن طريق العمل، إذ يمنح شرعية ودوراً ما داخل المجتمع. لذلك، فإن العمل يحقق «بُعد للمواطنة».
ومع ذلك، فإن غورز لا يجهل حدود الدخل الشامل، مثل خطر تحوّله إلى وسيلة لزيادة الاستهلاك. ولهذا السبب يعتبره أندريه غورز مجرد أداة في خدمة ثورة سياسية أوسع. ففي غياب تغيير بنيوي، لن يكون الدخل الشامل إلا وسيلة لإدامة النظام الرأسمالي، بل حتى لاختلال توازن القوى بين الموظفين وأصحاب العمل، إذا سيستخدم لتبرير حذف بعض الحقوق الاجتماعية الدنيا. يعطي البعض معنى معين للدخل الشامل، حيث يعتبروه كحل لندرة العمل في المجتمعات الرأسمالية، ويعمل بمثابة مسكِن لهذه البطالة المتزايدة. الفكرة ليست مثيرة للاهتمام، خصوصاً إذا لم نعتبر العمل كحق.
مع ذلك، هذه هي مشكلة الضمان الوظيفي الأخضر، الذي يهدف إلى خلق فرص عمل في قطاع الاقتصاد الأخضر للاستجابة للتحديات البيئية والاجتماعية الحالية، لأن يجب اعتبار العمل حقاً وليس سلعة. وللقيام بذلك، لا بد من إعادة النظر في مفهوم العمل وانتزاعه من مفهومه الرأسمالي. إن الدخل الأساسي الشامل كما تراه الغالبية، لن يكون في نهاية المطاف سوى طريقة للتكيّف مع الرأسمالية، إذ يحاول الضمان الوظيفي الأخضر وضع حدّ لأحد ركائز الرأسمالية، وهي البطالة الواسعة المنظمة. لكنها أبعد ما تكون عن كونها حتمية اقتصادية، وهي تسمح لأصحاب رأس المال بتعظيم أرباحهم في حين لا تزال هناك حاجة إلى خلق الكثير من الوظائف المفيدة للمجتمع، لا سيما في مجال التحوّل البيئي.
إن حدوث اضطراب كبير في نظامنا الاقتصادي والاجتماعي هو الذي سيطلق حركة قادرة على الاستجابة لتحديات التحرر الفردي وتغير المناخ. هذا هو الدرس المستفاد من التفكير البيئي لأندريه غورز، الذي لا تقتصر مبادئه على حماية الطبيعة.
ومع ذلك، يبدو أن تقليص النمو الاقتصادي من دون فترة إنتقالية يمثل تحدياً كبيراً. وفي سياق النظام الرأسمالي، الذي من المفترض أنه لن يسقط بين عشية وضحاها، فإن دينامية التقليص النمو من شأنها أن تؤدّي إلى تدمير عدد كبير من الوظائف، وستؤدي أيضاً إلى زيادة الفقر. ولن تؤدي كذلك إلا إلى زيادة المشاكل التي تنتجها النيوليبرالية، التي تتسم بالفعل بالتباطؤ في النمو الاقتصادي، الذي يعاني منه غالبية السكان. لذا، أليس من العملي أكثر أن نفكّر في سبل ربط النمو بالأنشطة غير الملوّثة والصديقة للبيئة؟ وفي الأمد القريب، تبدو إعادة تأهيل المبادئ الكينزية على أسس بيئية منظوراً أكثر فائدة من الترويج لخفض النمو الاقتصادي بالمعنى الضيّق للكلمة. إنه يظل الأفق المرغوب لمجتمع ما بعد الرأسمالية، والذي يحدّد فكر غورز معالمه. ولكنه لا يوفّر الحلول للانفصال عن الرأسمالية ذاتها، بل وحتى عن الرأسمالية النيوليبرالية.
نُشِر هذا المقال في Le Vent Se Lève في 3 آب/أغسطس 2022، وتُرجِم إلى العربية ونُشِر في موقع «صفر» بموافقة مُسبقة من الجهة الناشرة.
- 1أندريه جورز، «من أجل دخل كافٍ غير مشروط»، مجلة العلوم والثقافة المستعرضة، 2002، العدد الثالث.