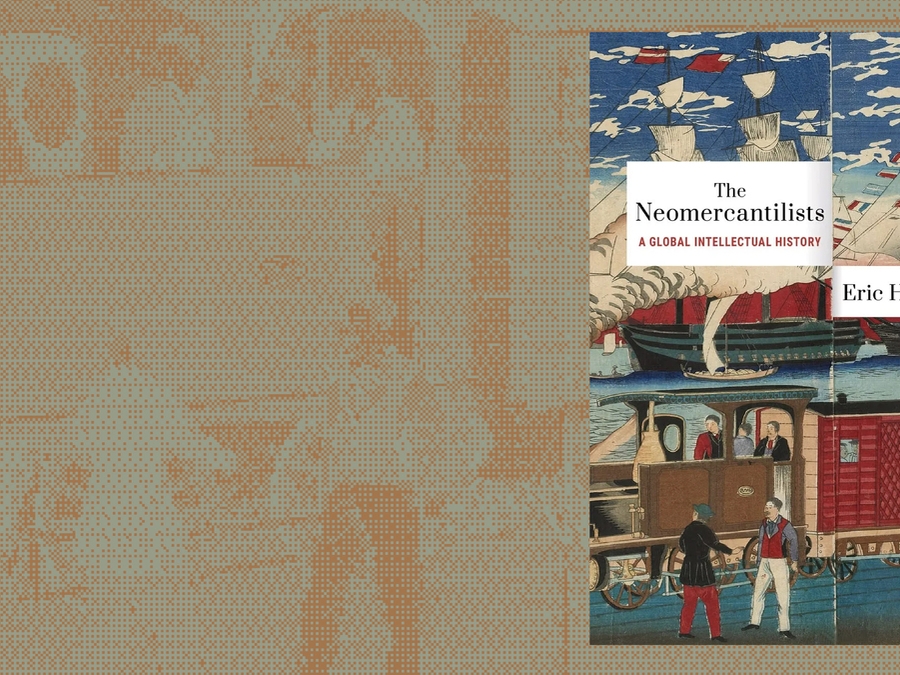الفلّاحون وفن الزراعة: بيان تشايانوفي
مراجعة لكتاب «الفلّاحون وفن الزراعة: بيان تشايانوفي» للكاتب يان داو فان دِر بلوخ، الذي يعتمد على أفكار تشايانوف لفهم كيف تؤثر القوى الخارجية على الزراعة الفلّاحية، ويُظهر كيف قوّضت النيوليبرالية التوازنات التي كانت تحكم علاقة الفلاحين بالأسواق والمجتمع. يبرز النص مقاومة الفلاحين لهذا التهميش عبر التعاونيات والمبادرات المحلية، مؤكداً أن المزرعة الفلاحية ليست بقايا من الماضي، بل نموذج بديل ومرن يقدم رؤية أكثر عدالة واستدامة للتنمية الزراعية.
مراجعة لكتاب «الفلّاحون وفن الزراعة: بيان تشايانوفي» للكاتب يان داو فان دِر بلوخ (Jan Douwe van der Ploeg)، وهو أستاذ فخري في جامعة فاجينينجن في هولندا، وأستاذ مساعد في كلية العلوم الإنسانية ودراسات التنمية في جامعة الزراعة الصينية في بكين. الكتاب من ترجمة ثائر ديب ومهيار ديب، وصادر عن «سلسلة التغير الفلاحي والدراسات الفلاّحية»،1 الصادرة بدورها عن «مبادرات في الدراسات الفلاّحية النقدية». والنسخة العربية من إصدار شبكة «سيادة» والمعهد العابر للقوميات.
من هو ألكسندر تشايانوف، ولماذا يهتم الباحثون بأعماله؟
تتركز فكرة كتاب فان دِر بلوخ حول مساهمات الاقتصادي الروسي السوفياتي ألكسندر تشايانوف في الاقتصاد السياسي الزراعي، والذي اتُهمه جوزف ستالين بـ«العمالة للإمبريالية»، إلى جانب اقتصاديين بارزين آخرين مثل نيكولاي كوندراتييف، وذلك بسبب نشاطهم في حزب العمّال الفلاحين، وتحالفهم مع الحركة النارودنية التي اعتبرت أن الفلّاحين هم القوة المركزية في بناء الاشتراكية. وانتهى الأمر بإعدام تشايانوف بعد النفي والسجن.
يُعتبر تشايانوف أحد مؤسّسي علم الزراعة الاجتماعي، إذ ساهم في تفسير ديناميات التغيير الزراعي والتفاعلات والتوازنات التي تحكم تطوّر أو انكماش البُنى الزراعية الفلّاحية والأسرية، في زمن من التغيرات التكنولوجية السريعة. وبالتوازي مع تعاظم الشكوك بشأن قدرة الرأسمالية على تحقيق التنمية الريفية والعمل على وقف اتساع الفجوة بين المدن والأرياف من جهة، والتكيّف الفعّال مع آثار التغير المناخي، والاستمرار في تحقيق استدامة الموارد الغذائية من جهة أخرى. اعتمد الكثير من العلماء بشكل واضح على أعمال تشايانوف في أبحاثهم، وقام بعضهم «بإعادة ابتكار» المنهج التشايانوفي من دون أن يكونوا على دراية بعمله.
تعتمد أعمال تشايانوف على تحليل سيرورات المزرعة، إذ اعتبر أن المبادئ الاقتصادية الرأسمالية لا تطبق على الزراعة الفلّاحية التي ترتكز على عمل الأسر الفلّاحية. وبما أنه ما من أجور تُدفَع، فلا وجود لأي «ربح صاف» في المزرعة الفلّاحية، ومن المستحيل تطبيق حساب الربح الرأسمالي فيها. ومع ذلك، يؤكد فان دِر بلوخ أن كل مزرعة تحوي رأسمال، على الرغم من أنه ليس بالطريقة التي يُفهَم بها بالمعنى الماركسي: أي كعلاقة استغلال للعمل المأجور. ولا يُستعمَل لإنتاج فائض قيمة يُستثمَر من جديد في إنتاج مزيد من فائض القيمة. وقد تبنّت شبكة «سيادة» وحركة لا ڨيا كامپيسينا والكثير من الحركات المناضلة إرث تشايانوف في مسعى الدفاع عن الزراعة الفلّاحية والسيادة الغذائية، فالقضية ليست إنتاج المزيد من الطعام، بل أين يُنتَج، ومن ينتجه، وكيف.
تعتمد أعمال تشايانوف على تحليل سيرورات المزرعة، إذ اعتبر أن المبادئ الاقتصادية الرأسمالية لا تطبق على الزراعة الفلّاحية التي ترتكز على عمل الأسر الفلّاحية. وبما أنه ما من أجور تُدفَع، فلا وجود لأي «ربح صاف» في المزرعة الفلّاحية
ويشير الكاتب إلى أن «عبقرية» تشايانوف كانت بشكل أساسي نتاج ظروفه، فقد «كان ملمّاً بالخلفية التاريخية المحدّدة التي اشتملت على الريف الروسي شديد التنوّع، والركود الاقتصادي في منتصف القرن التاسع عشر، والجماعات الفلّاحية الكثيرة، والحركات السياسية الراديكالية التي تصوّرت مستقبلاً روسياً يقوم على الفلّاحين ويُبنى معهم، بالإضافة إلى معرفته العميقة بالحياة الفلّاحية من خلال المواجهات اليومية». وكانت لديه «إمكانية الوصول إلى قاعدة بيانات فريدة، هي إحصائيات الزيمستوف (جهاز الحكم الذاتي الريفي في الإمبراطورية الروسية وأوكرانيا)»، والتي كانت غنيّة لدرجة أن كارل ماركس عبّر عن إعجابه بها، إذ أتاحت «اكتشاف الأنساق التجريبية التي كانت تعكس عمل التوازنات المختلفة وتحليلها». كما كانت لديه «ميزة العمل والعيش في فترة انتقالية بدأت مع الثورة البلشفية في العام 1917 (...) حين نوقش أفق التغيير الريفي بعيد المدى باستفاضة».
ويلخّص الكاتب المقوّمات الثلاثة التي تقوم عليها خطوط التفكير الكبرى لتشايانوف كما يلي: أولاً، نظرية في الزراعة الفلّاحية تشتمل على أول محاولة للكشف عن ديناميات المزرعة الفلّاحية الفريدة. ثانياً، علم الزراعة الاجتماعي الذي يعدّه الكثير من المؤلّفين نقطة انطلاق الإرشاد الزراعي ودراساته. وثالثاً، نظرية في التعاون الشاقولي (عكس «التعاون الأفقي»)، الذي يشير إلى بناء تعاونيات قوية على كلا جانبي المزرعة الفلّاحية (منبعاً ومصبّاً).2 وقد كان هدف تشايانوف، في سياق الثورة البلشفية، زيادة الإنتاج الزراعي وإنتاجية العمل الزراعي، وتوزيع الدخل الوطني على نحو أكثر إنصافاً.
جذور الخلاف النظري بشأن القضايا الزراعية والفلّاحية
كان تشايانوف على خلاف نظري مع فلاديمير لينين بشأن مستقبل المجتمع الروسي بشكل عام، والمسألة الزراعية ودور الفلّاحين في الانتقال نحو الاشتراكية بشكل خاص، بما في ذلك المشاريع والتعاونيات الزراعية والكومونات الشعبية والتخطيط المركزي وحجم الحيازات الزراعية التي تسمح بالتنمية الزراعية. انخرطا في سجالات حادة في وقت كانت فيه روسيا أمة زراعية بشكل أساسي، وكان الفلّاحون يفوقون العمّال الصناعيين عدداً. لم يقتصر الصراع النظري بينهما على مستقبل الاتحاد السوفياتي، بل شمل جميع قارات العالم، ما يظهر أن الثورة العالمية كانت محورية في ذهن الرجلين. لم يتصوّر تشايانوف ولينين نموذجاً اشتراكياً قابلاً للحياة في دولة واحدة، على الرغم من جوهرية الخلاف بينهما، على عكس ستالين الذي طرح نظريته الخاصة «الاشتراكية في بلد واحد»، وفرض تطبيقها بأدوات الاستبداد والإشراف المباشر على هندسة المجتمع عبر شتى الأساليب القسرية.
بعد ثورة العام 1917، فرض النظام البلشفي استغلالاً صارماً على الفلاحين الروس لتمويل الصناعة الثقيلة، وساهمت الأسعار المنخفضة ومصادرة المحاصيل والضرائب المرتفعة في ذلك. كان تشايانوف مدركاً لتداخل النظام البلشفي مع الاقتصاد الفلّاحي، وكيفية فرض سيطرته عليه واستنزاف موارده لتحقيق «التراكم الأولي». ولعلّ الخلاف الأكبر بين تشايانوف ولينين يتعلق بتأميم الأراضي، إذ طالب لينين بمصادرة وتأميم الملكيات الكبيرة وأراضي الفلّاحين، في حين كان تشايانوف يطالب بتحويل جميع الأراضي إلى مزارع فلّاحية.
لم يكن لينين معادياً للفلاحين، لكنه لم يعتبرهم قوة ثورية قادرة على قيادة الانتقال نحو الاشتراكية. أما تشايانوف فلم يكن معادياً للتحليل الطبقي، كما يُزعَم أحياناً، إذ يدخل التحليل الطبقي ضمن التحليل الاقتصادي السياسي في مقارباته، خصوصاً حين يحلّل عمل وحدات الإنتاج الفلّاحية ضمن السياق المتعلق بها، أو تأثير تشكيل اقتصادي-سياسي معيّن على التنمية الريفية. لكن النقطة المركزية في المقاربة التشايانوفية هي المنتجون المباشرون وقدرتهم على تقويم التوازنات المهمة في وحدات إنتاجهم. كان همّ تشايانوف الأساسي هو تحرّر الفلّاحين من علاقات التبعية، وحرية تطويرهم للمزرعة. في المقابل، تجاوز ستالين الخلافات النظرية، متخذاً موقفاً عنيفاً ضد الفلّاحين. فقد أدى فرضه سياسات الزراعة الجماعية القسرية، إلى مجاعات كبرى، تسبّبت بوفاة مئات الآلاف من الفلاحين السوفييت، خصوصاً في أوكرانيا. وتشير بعض التقديرات إلى أن الخسائر البشرية لهذه المجاعات تجاوزت الملايين.
يبيّن تشايانوف في كتابه «علم الزراعة الاجتماعي» بعض السيرورات التي تشكل أساس إنتاج التغاير في الزراعة: «تعني فرديّة المنتِج المباشر، وطاقته الإبداعية، وخصوصيات مزرعته، وجودة حقوله أن المزرعة الفردية سوف تحيد على الدوام عن النمط المعتاد. يَسِمُ الفضول والبحث عن الحلول المبتكرة المزارعين جميعاً. وهذا ما يجعل المزارع جميعها في حالة حركة؛ تتغير على نحوٍ دائم نظراً إلى الانتشار الواسع للتجارب والبحوث والاختبارات الإبداعية». وربما يأتي رأي تشايانوف هنا في سياق معارضة الكولخوزات3 التابعة للسلطة المركزية.
لم يتصوّر تشايانوف ولينين نموذجاً اشتراكياً قابلاً للحياة في دولة واحدة، عكس ستالين الذي طرح نظريته الخاصة «الاشتراكية في بلد واحد»، وفرض تطبيقها بأدوات الاستبداد
أدى النقاش بين تشايانوف ولينين إلى انقسامات نظرية بين القياديين البلاشفة. فقد أيّد نيكولاي بوخارين تشايانوف في تعزيز موقع الفلاحين في العملية الثورية، بينما دعم يفجيني بريوبراجينسكي لينين المشكّك في قدرة الفلاحين على تجاوز المصالح الفردية والالتحام الكلي مع الطبقة العاملة. انتشر هذا الخلاف عالمياً في القرن العشرين، متجاوزاً القضايا الزراعية ليشمل جميع جوانب الحياة الريفية وعلاقات الإنتاج الاجتماعية، قبل أن يتطوّر إلى نقاش عالمي يقسم العالم إلى جزئين: دول الجنوب العالمي ودول الشمال العالمي.
يتماثل المنطق الذي يحكم تفكير تشايانوف مع تفكير ليون تروتسكي وروزا لوكسمبورغ، إذ يتشاركون في فهم ديناميات الثورة الدائمة، وما يتضمّنها من عملية خلق مستمرة للشقوق في النظام الرأسمالي، ومرونة القوى الاجتماعية في الاستجابة للتغيرات على الرغم من اختلال توازن القوى، وأحياناً كثيرة بسببه، والعلاقة المعقدة بين التوازنات والتفاعلات ضمن الوحدات الإنتاجية من جهة، وبينها وبين محيطها الأوسع من جهة أخرى. وقد تكون روزا لوكسمبورغ من أبرز الماركسيين الذين رفضوا بشدّة التصوّر الماركسي الكلاسيكي القائل بأن الوحدة الفلاحية محكومٌ عليها بالانقراض الحتمي وفقاً لقانون تقسيم العمل المتزايد في المجتمع الرأسمالي وسيرورة تطوّر الزراعة الرأسمالية على حساب الزراعة الفلاحية، إذ كتبت: «إنه لتجريدٌ فارغ أن نطبّق في آن معاً جميع مقولات الإنتاج الرأسمالي على الفلّاحين، وأن نتصوّر الفلّاح كمقاول لدى نفسه، وعامل مأجور، ومالك أرضٍ في شخصٍ واحد. تَكمُن الخصوصية الاقتصادية للفلّاحين... في واقعة أنهم لا ينتمون إلى طبقة المقاولين الرأسماليين ولا إلى طبقة البروليتاريا المأجورة، وأنهم لا يمثلون الإنتاج الرأسمالي، بل الإنتاج السلعي البسيط».
عن مفهومي «التقويم الذاتي» و«الاستغلال الذاتي»
يشير الكاتب إلى أن نصوص تشايانوف تعرّضت للكثير من النقد، لكنه يختار أن يجادل في نقد معيّن مفاده أن نظرية تشايانوف عن المزرعة الفلّاحية ودينامياتها تعتمد في الأساس على «التقويم الذاتي»، وهو نقدٌ يهدف إلى نزع الطابع المادي عنها. فيوافق على أن تقويم التوازنات المختلفة وترجمتها إلى خطة تنظيمية للمزرعة أمرٌ ذاتي بالفعل، لكنه يشير إلى أن التقويم موضوعي أيضاً: «بقدر ما تراعي المداولات واقع الأسرة الزراعية المادي،4 والخلفية البنيوية التي تعمل ضمنها»5. ويعتبر أن التقويم الذاتي مطلوبٌ موضوعياً، لأن لا أجور تُدفع في المزرعة الفلّاحية، ولا علاقة رأس مال-عمل تبني داخلياً وحدة الإنتاج والاستهلاك، ولأن التوازنات المطلوبة ليست مفروضة من الخارج على نحو أحادي، ولا بد أن تقوم هذه التوازنات داخلياً بالتقويم الذاتي للفاعلين المعنيين. وهنا يؤكد الكاتب على قاعدية الزراعة الفلّاحية، وقدرة الفلّاحين في هذه المزارع على بناء تجاربهم بأكبر قدرٍ ممكن من المرونة، وفي الوقت ذاته، اكتساب المناعة لمواجهة الظروف القاهرة الناتجة إما عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية أو عن التغيرات المناخية القاسية.
أما «الاستغلال الذاتي»، فيشير إلى أنه يساوي إنتاجية العمل الفلّاحي. وتعتمد «درجة الاستغلال الذاتي» هذه على عوامل عدة، من خصوبة التربة، وموقع المزرعة بالنسبة إلى السوق، ووضع السوق، وعلاقات الأرض المحلية، والشكل التنظيمي للسوق المحلية، وطابع التجارة، واختراق رأس المال المالي. يفترض مفهوم الاستغلال عموماً علاقة بين شخصين: ينتج أحدهما فائضاً، ويتملك الآخر هذا الفائض. ولا معنى لأن تُنتِج فائضاً ثم تستعيده، وبذلك يكون «الاستغلال الذاتي» مفهوماً متناقضاً، إذ لا يمكن لأحد أن يستغل ذاته. لكن فكرة استغلال الذات تتعارض مع جوهر المقاربة التشايانوفية. وربما تكون عبارة «الاستغلال الذاتي» قد استخدمت للإشارة إلى فلّاحين اختاروا أن يعملوا بكدّ ليساعدوا في إقامة اشتراكية الدولة في روسيا. لكن المصطلح سرعان ما تحوّل إلى شعار لتخلّف اقتصادي مزعوم للفلاحين.
التوازنات التشاينوفية الداخلية في عيون فان دِر بلوخ
يشير الكاتب إلى أن التخصّصات العلمية المتعددة لم تتمكن من معالجة التحديات المتعلقة بالاقتصاد الزراعي، كما أن المؤسسات الدولية لم تولِ الاهتمام الكافي بمساهمات تشايانوف. تتمثل النقطة الأساسية في نهج تشايانوف في أنه على الرغم من أن وحدة الإنتاج الفلّاحية ترتبط بالسياق الرأسمالي الذي تعمل فيه، إلا أنها ليست محكومة به بشكل مباشر، بل تتأثر بمجموعة من التوازنات المختلفة التي تربط عمل الوحدة الفلّاحية وتطورها بالسياق الرأسمالي الأوسع، وبأساليب معقدة ومميزة. هذه التوازنات هي مبادئ ناظمة، إذ تشكل وتعيد تشكيل طرائق زراعة الحقول، وتربية المواشي، وتنفيذ مشاريع الريّ، والكيفية التي تتبلور وتتجسّد بها الهويات والعلاقات المشتركة. التوازنات التشايانوفية المختلفة هي ما يكوّن الزراعة وينظّمها. فهي تحدِّد، في سياقات زمنية ومكانية معيّنة، كيفية إنتاج وإعادة إنتاج المزارع الفلّاحية، وتشكل «الخطة التنظيمية للمزرعة الفلاحية». وغالباً ما يحاول الفلّاحون اختيار التوازنات التي تُبعِد تنظيمهم لمزارعهم عن آليات السوق.
ركّز تشايانوف على توازنين داخليين رئيسيين هما توازن «العمل والاستهلاك»، وتوازن «الكدح والنّفع». لا بد من تحقيق التوافق بينهما في كل مزرعة فلاحية بطريقة فريدة تتناسب مع احتياجات كل من المزرعة والأسرة الفلاحية التي تقيم فيها. واعتبر أن تمايز الآليات الداخلية للمزارع الفلّاحية عن المزارع الرأسمالية جعلها تثبت تاريخياً أنها قادرة على مقاومة المشاريع الرأسمالية واسعة النطاق في الزراعة. توازن العمل-الاستهلاك يتعلق بعدد المستهلكين نسبةً إلى عدد العمال ضمن الأسرة، ويعني العلاقة بين حاجاتها الاستهلاكية والقوة العاملة الموجودة في داخلها. وبحسب تشايانوف، يُعد هذا التوازن القلب النابض لكل وحدة إنتاج فلّاحية. على الرغم أنه من المستحيل في عالم اليوم أن نعيد إنتاج الأسرة والمزرعة من دون اللجوء إلى الأسواق، فالاستقلالية عن دوائر السلع لم تعد موجودة، لكن ارتباط الأسر والمزارع الفلّاحية بهذه الدوائر يختلف ويتنوّع.6 ويناقش الكاتب بأن توازن العمل-الاستهلاك يتّخذ اليوم شكلاً مختلفاً عن ذلك الذي وصفه تشايانوف منذ أكثر من قرن.7
لم يكن لينين معادياً للفلاحين، لكنه لم يعتبرهم قوة ثورية قادرة على قيادة الانتقال نحو الاشتراكية. أما تشايانوف فلم يكن معادياً للتحليل الطبقي
أما توازن الكدح-النّفع، فيتعلق بالعامل الفرد، ولكنه لا يشمل الأسرة كلها، وبالعلاقة بين جهود الفرد الإضافية المطلوبة لزيادة الإنتاج الإجمالي والفوائد الإضافية التي توفّرها الزيادات في الإنتاج، والتي تعود بالنّفع على الأسرة. بالتالي، فإن توازني العمل-الاستهلاك والكدح-النفع ليسا الشيء ذاته، على الرغم من ارتباطهما، والأسرة الفلّاحية تسعى إلى إقامة التوازن بينهما. ويُظهِر حساب المتغيرات، في أكثر من نموذج أرفقه الكاتب، الترابط العميق بين الكدح والنّفع، كما يُظهِر أيضاً أن التوازن بينهما متعلق بالعائدات.8
يتناول الكاتب نسقاً أوسع من التوازنات في محاولة لتطوير مقاربة تشايانوف، بعضها داخليّ، وبعضها الآخر أكثر شمولية ويربط الزراعة الفلّاحية بالديناميات السائدة في البيئة الأوسع. كما يناقش كيفية نشوء الصراعات الاجتماعية نتيجة الحاجة لتحقيق أفضل توازن ممكن، وكيف تساهم الزراعة الفلّاحية في معالجة بعض التحديات الكبيرة التي تواجهها البشرية. تأخذ هذه التوازنات بالاعتبار الوضع الفريد لكل أسرة ومزرعة فلّاحية، ما يجعل تطبيقها يعتمد على الفاعلين المباشرين الذين يستطيعون فهم القواعد المحيطة بهم واتخاذ القرارات الملائمة.
يولي الكاتب أهمية كبيرة لتأثير الهيئات الخارجية9 التي تتدخل بشكل فعال لإعادة تقييم مختلف التوازنات بطرق تتناسب مع مصالحها الخاصة، حتى وإن كان ذلك على حساب المنتجين المباشرين. فيتحدث مثلاً عن التوازن بين الموارد الداخلية والخارجية، وهو يدور برمّته حول الاختيار بين صنع الموارد داخل المزرعة أو شرائها من السوق، وكيف يضمن هذا التوازن ألا تعتمد المزرعة بشكل كامل على الأسواق لكي لا تتعرض للابتلاع وتضمن خلق استقلالٍ نسبي.10
الزراعة عملية إنتاج وإعادة إنتاج مستمرة، وتقتضي إعادة إنتاج الموارد التي تستخدمها، وهنا تبرز ضرورة إقامة توازن آخر بين الإنتاج وإعادة الإنتاج. تُعنى عملية إعادة الإنتاج بجميع الموارد والعناصر المطلوبة لجعل الزراعة تجري بسلاسة. وكثيراً ما أشار تشايانوف إليها بأنها «تجديدٌ لرأس المال». يشير الكاتب إلى أن آلان لاكروا ناقشت التطور التاريخي لتوازن الإنتاج وإعادة الإنتاج باستفاضة، مقسمة إياه إلى مراحل تاريخية: في المرحلة الأولى، استُخدِمَ النظام البيئي لتجديد الموارد، وكانت الحقول المستنفدة تُهجر وتؤخذ حقول جديدة من الطبيعة. وفي المرحلة الثانية، انتقلت إعادة الإنتاج إلى المزرعة نفسها وصارت جزءاً من الزراعة. وفي المرحلة الثالثة، ابتعدت إعادة الإنتاج مجدداً عن المزرعة، وتخارَجَت إلى صناعات زراعية تنتج على نحو متزايد مواضيع العمل والأدوات والكتيّبات الإرشادية التي يجب أن تتّبعها قوة العمل وتوزّعها. وفي هذا الترتيب الجديد، فقدت الجماعة الفلّاحية تحكّمها في الموضوعات والأدوات لصالح الصناعة الزراعية والتصميم العلمي، ليتحوّل الاعتماد إلى مركزية المركّزات الصناعية بدلاً من مركزية المواد المنتجة في المزرعة، ما يجعل التبعية سمة أساسية.
التوازنات الخارجية التي حدّدها فان دِر بلوخ انطلاقاً من توازنات تشايانوف
تتواجد التوازنات الخارجية بين القطاع الزراعي والمجتمع والأسواق، وتتعلق بموقع الزراعة الفلاحية في السياق الأوسع. لا يمكن للمزارعين الأفراد تحديد هذه التوازنات أو التأثير عليها، بل العكس هو الصحيح. يشير الكاتب إلى أن تشايانوف لم يناقش هذه التوازنات مباشرة، لكنه لمّح إليها في عمله عن تأثير الاقتصاد الفلّاحي في سوق العمل، وينطبق الأمر ذاته على سياسات الدولة المؤثرة في الفلّاحين كما أوضح في مناقشته التعاون الأفقي مقابل العمودي في كتابه «نظرية التعاونيات الفلاحية». لكن تشايانوف استطاع في روايته «رحلة أخي أليكسيس إلى أرض الفلّاحين الفاضلة» التعبير عن نفسه أكثر، مستخدماً اسماً حركياً، حيث ناقش بجرأة «التوازن الأمثل يبن المدينة والريف»، وقضايا متنوعة مثل اضمحلال المدن الضخمة، والتكثيف الزراعي، ودور الفلاحين في المجتمع، والديمقراطية المباشرة.
ساهمت النيوليبرالية في تحويل الزراعة من وحدات إنتاج مستقلة نسبياً إلى وحدات تابعة لأسواق المنبع. يعتمد الكثير من الفلاحين اليوم على الأسواق بشكل متزايد، ويواجهون علاقات تبادل غير مواتية مع أسواق المصبّ. وهنا يتحدث الكاتب عن التوازن بين المزارع والأسواق، مؤكداً أنه ليس ثابتاً، إذ يمكن أن تحفّز الأسواق المزارعين على زيادة الإنتاج وتكوين رأس المال، أو أن تكون مناوئة وتعيق صيانة وإعادة إنتاج المزرعة. وقد يستخدم الفلاحون التعاونيات كقوة مضادّة، وعندما تكون هناك اختلالات شديدة، قد يحتشدون في الشوارع مطالبين بتدخل الدولة، ويمكنهم أيضاً تنظيم قنوات تسويق جديدة بأنفسهم.
يؤكد الكاتب على قاعدية الزراعة الفلّاحية، وقدرة الفلّاحين على بناء تجاربهم بأكبر قدرٍ ممكن من المرونة، وفي الوقت ذاته، اكتساب المناعة لمواجهة الظروف القاهرة الناتجة إما عن السياسات الاقتصادية النيوليبرالية أو عن التغيرات المناخية القاسية
ليست الأسواق الآلية الوحيدة التي تربط الزراعة والاقتصاد الحضري، فهجرة الفلاحين إلى المدن تؤدّي دوراً أساسياً في ذلك، إذ تشكل عنصراً مهماً من التوازن بين المدينة والريف. يمكن للهجرة الدائمة مثلاً أن تُضعِف حيوية الريف. بينما تساهم الهجرة المؤقتة في إحيائه، إذ يعود الفلّاحون إلى قراهم مع إمكانات جديدة للاستثمار في الزراعة والمتاجر والمشاريع الصغيرة.
تسيطر اليوم الشركات الكبيرة وسلاسل البيع بالتجزئة على التجارة. يشير الكاتب إلى أن هذه الشركات، إلى جانب الصناعات الزراعية التي تتحكم بتدفقات المُدخلات، تشكل شبكات تعمل كنظم استخراجية. يمتد التفاعل بين المنتجين الأوليين وصناعة الغذاء إلى أكثر من مجرد تبادل السلع بالمال، إذ تصاحب العلاقات السلعية علاقات «تقنية-إدارية»، ما يخلق إطاراً مؤسسياً يحدّد ما يجب أن يفعله المزارعون ومتى وكيف. وهكذا، تُقيّد حرية المقاول الزراعي في اتخاذ قرارات المقاولة، ويَتقيّد بسيناريو تحدّده صناعات الغذاء ونقل المدخلات، والشركات التجارية، وسلاسل البيع بالتجزئة، والبنوك، والهيئات الحكومية. في زمن تشايانوف، كانت التعاونيات تمثل وعداً بالقوة المضادة. أما اليوم، فالتعاونيات السابقة تطوّرت إلى كيانات تعامل الفلّاحين كما تفعل إمبراطوريات الغذاء، ولم يعد يُنظر إلى البنى التعاونية الجديدة على أنها توفّر صلات واعدة بالأسواق السلعية العامة. بدلاً من ذلك، تحاول الحركات الريفية الجديدة إنشاء «مشتَركات» وأسواق جديدة تحمل أطراً معيارية جديدة يتقاسمها المنتجون والمستهلكون، وهي تظهر غالباً عند الشقوق حيث تعجز الأسواق الضخمة عن تلبية الاحتياجات.
توازنٌ خارجي آخر يناقشه الكاتب هو التوازن بين النمو الزراعي والنمو السكاني، والذي يعكس قدرة المزارع الفلّاحية على تحقيق التوازن بين الإنتاج والاستهلاك على المستوى الكلي. يشهد هذا التوازن اليوم حالة من الفوضى في الكثير من مناطق العالم، خصوصاً في أفريقيا، حيث يتناقص إنتاج الغذاء للفرد منذ 50 عاماً على الأقل، ما أدى إلى انقطاع الصلة بين الإنتاج والاستهلاك. تُلخص مقولة بيروفية هذا الاختلال: «أرضٌ بلا يدٍ وأيدٍ بلا أرض»، هذا هو الوضع الاعتيادي لأسرة ريفية تعاني من الفقر والجوع، بينما تبقى الأرض المحيطة بهم غير مزروعة.
تمايز المجتمع الفلّاحي أم تطابقه؟ وتمايزٌ ديموغرافي أم تمايزٌ طبقي أم الاثنين معاً؟
احتدم جدال اليسار الراديكالي بشأن تمايز المجتمع الفلاحي أو تطابقه. فالتغاير في الزراعة له أبعاد متعددة، لكن الفروقات بين المزارع الصغيرة والكبيرة، وبين الأسر الفقيرة والغنية، غالباً ما تُعبِّر عن مفهوم التطابق، الذي يفترض أن المجتمع الفلّاحي يتكوّن من شرائح مختلفة تتباعد وتتطور إلى طبقات اجتماعية متعارضة. وهنا يتعارض رأيان: تركّز وجهة النظر الماركسية-اللينينية على التمايز الطبقي، بينما تعارضها فكرة التمايز الديموغرافي التي طوّرها تشايانوف.
يرى تشايانوف أن الفوارق في حجم المزرعة مؤقتة، تنشأ من تغييرات في نسبة الاستهلاك إلى العمل داخل الأسرة الفلّاحية، ووثّق ذلك في كتابه «نظرية الاقتصاد الفلاحي». لاحقاً، بيّن مؤلّفون مثل في-سياو تونغ أن الدورة الديموغرافية قد تمتد إلى 4 أو 5 أجيال وقد تتضمن تحولات كبيرة في أساليب الزراعة. وقد اعترف تشايانوف بوجود التمايزين الطبقي والديموغرافي وتشابكهما. وأعاد دانييل ليتل تأكيد موقفه، مشيراً إلى أن كلا السيرورتين يمكن أن تحدثا، مع التركيز على إحداهما تارةً والأخرى تارةً أخرى. من جهة أخرى، أشار «اللينينيون» إلى أن التمايز الديموغرافي، إذا وُجد، فلا أهمية له.
اقترب تشايانوف أكثر من المشروع السياسي القائم على الفلّاحين الذي اقترحه كارل ماركس في رسالة مؤرّخة في 8 آذار/مارس 1881، حين أشار إلى أنه ما من نظرية كونية للتطور التاريخي، ورأى أن كومونات الفلّاحين الروس تستطيع التقدم مباشرة نحو الشيوعية، مخالفاً تفكيره السابق في «الثامن عشر من برومير 1963» بأن الفلاحين عاجزين عن تكوين قوة سياسية، وأنهم لا يشكلون طبقة. فحالما يتواصل الفلّاحون ويتقاسمون مشروعاً سياسياً مشتركاً لتغيير الريف، فإنهم يجعلون من أنفسهم طبقة، وهذا ما يحصل حالياً في داخل، وبسبب، الحراكات الفلّاحية الانتقالية الجديدة وأجنداتها الجذرية في التغيير. وفي هذا السياق، يعتبر الكاتب أن «النظرية الجذرية تخطت خلال العقود الماضية كثيراً من المقولات التي ارتبطت على نحو وثيق بنشوء الرأسمالية الصناعية وفترة ازدهارها».
يفترض مفهوم الاستغلال عموماً علاقة بين شخصين: ينتج أحدهما فائضاً، ويتملك الآخر هذا الفائض. ولا معنى لأن تُنتِج فائضاً ثم تستعيده، وبذلك يكون «الاستغلال الذاتي» مفهوماً متناقضاً، إذ لا يمكن لأحد أن يستغل ذاته
يخضع الاقتصاد الزراعي-الريفي لعمليات استخراج فائض القيمة عبر علاقات التبعية. ينغمس تشايانوف في تحليل توازن الاستقلال والتبعية في العلاقات الطبقية ومنظومة استخراج فائض القيمة، موضحاً تفاوت آليات استخراج الفائض مثل الريوع والضرائب والممارسات الضريبية الفاسدة. ويعتمد اتجاه التطور الزراعي إلى حدّ كبير على الحوافز والفرص والقدرات التي توفرها المنظومة الطبقية للأطراف المختلفة، ما يفرض منطق تطور معين.
بحسب الكاتب، إذا أعدنا النظر في جدالات ذلك الوقت مستفيدين من فهم تطور التاريخ، نجد أن الزراعة العالمية، باستثناءات قليلة، لم تشهد تمايزاً طبقياً حاسماً كما تقترح النظرة الماركسية السائدة منذ القرن التاسع عشر. بالعكس، تراجعت الزراعة الرأسمالية أو اختفت في مناطق واسعة، خصوصاً خلال الأزمات الزراعية في ثمانينيات القرن التاسع عشر وثلاثينيات القرن العشرين. وانتقلت المناقشة إلى آليات تمايز جديدة، تنتج تأثيرات مختلفة تماماً، وتشكل تهديدات خطيرة للفلّاحين اليوم: تتعلق الآلية الأولى بظهور الزراعة المقاولة، حيث يستولي المقاولون على الموارد والأسواق، ما يسرّع من سيرورة النمو الكمي. والثانية هي عودة المشاريع الزراعية الرأسمالية الكبيرة، خاصة في الجنوب العالمي، التي ترتبط بإمبراطوريات الغذاء وتقام عبر الاستيلاء على الأرض والمياه.
المزرعة الفلّاحية في سياق الرأسمالية الحديثة: مقاومةٌ مستمرة وخلّاقة
يشير الكاتب إلى 3 مفاهيم رئيسة لفهم وضع الفلّاحين والمزارع الفلّاحية اليوم: أولاً، تنوع الفلّاحين، إذ يعملون كجموع متغايرة تتجاوز تنظيم أعمالهم منطق السوق، ويقاومون تقسيم العمل الذي يفصل مهام سيرورة الإنتاج. ثانياً، وجود المشتَركات (موارد جماعية مشتركة) يقيمها الفلّاحون، كالأراضي المستولى عليها في البرازيل، ومخازن البذور المشتركة في أميركا اللاتينية وأفريقيا، وأعمال الريّ في الصين، وعلاقات المدينة والريف في أوروبا، والأسواق المتداخلة المقامة حديثاً في جميع أنحاء العالم. وهذه المشتَركات عالية الإنتاجية وتقدّم بديلاً مقنعاً عن رأسمال الشركات. ثالثاً، وجود الشقوق في النظام الرأسمالي العالمي، والثغرات البنيوية الناجمة عن سيرورات الإقصاء الهائلة. وهي الفجوات التي تعجز أجهزة الدولة عن تنظيمها. والأسر الفلّاحية تعمل عند تقاطع شقوق عديدة، فعملها ليس عملاً مأجوراً ولا يخضع مباشرة لرأس المال، ما يعزز استقلالها عن منطقه. يخلق الفلّاحون الشقوق بأنفسهم، ويرتبطون بشكلٍ متزايد مع آخرين يخلقون شقوقاً أخرى ويعملون ضمنها، ما يؤدي غالباً إلى نشوء حركات اجتماعية جديدة. والشقوق هي أماكن صراعٍ دائم، وفي بعض الأحيان تُصاغ فيها بدائل متينة للترتيبات الرأسمالية.
تُعتبر المزارع الفلّاحية جزءاً من النظام الرأسمالي، لكنها ليست في حد ذاتها وحدة إنتاج رأسمالية بل هي، بحسب الكاتب (فان دِر بلوخ)، «جزءٌ مزعج يولّد شقوقاً واحتكاكات، وهي مهد المقاومة التي تنتج بدائل تعمل كنقد دائم للأنساق السائدة».
تُواصل المزرعة الفلّاحية، حسب تشايانوف، «الإنتاج حيث تتوقف المزارع الرأسمالية»، ولا تحتاج إلى الربح مثل الشركات، ولا تتحكم السوق الرأسمالية11 في تطورها، بفضل بنيتها الداخلية وأساليبها المختلفة. واستنتج أن القوة التنافسية للأسرة الفلّاحية ضد المزارع الرأسمالية الضخمة أكبر مما توقعه ماركس وكاوتسكي ولينين. مالك الأرض الكبيرة يهتم بالربحية فقط وليس بالإنتاجية. ينقضُ الكاتب النظرة السائدة عن الفلّاحين كظاهرة مقتصرة على الماضي والأطراف بالضرورة، أو القول بأن تحديث الزراعة في الغرب قد قضى على طرائق الزراعة الفلّاحية. ويؤكد استمرارية أساليب الزراعة الفلّاحية التي ازدهرت منذ أوائل تسعينيات القرن الماضي. ويؤكِّد عدم وجود فارق جوهري أو عداء متأصّل بين الفلّاحين في كل العالم.
يعطي الكاتب أهمية استثنائية لنموذج «مخزن الحبوب» في سيرورة إعادة إنتاج المزارع الفلّاحية وإقامة التوازن بين «الكدح والإشباع». ويستند إلى أمثلة من أرض الواقع حيث تُجمَع المحاصيل الوفيرة في مخازن حبوب ضخمة، تُعتبر استراتيجية لناحية تحقيق الأمن الغذائي، ولا يُباع الحصاد السابق إلا حين يؤمّن حصاد جديد. يقدم أيضاً أمثلة على عمليات التبادل بين المجتمعات الريفية في غينيا بيساو التي تتبادل كميات متساوية من الأرزّ والأرزّ الجاف بعد الحصاد. داخل الأسرة الممتدة، يُخصّص جزء من المحصول للاستهلاك المباشر، بينما تُباع أجزاء للحصول على سلع استهلاكية لا يمكن إنتاجها في القرية. وتحتاج العلاقات بين الإنتاج وإعادة الإنتاج إلى تنظيم دقيق للحفاظ على التوازن. وعلى الرغم من أن هذه التدفقات للقيمة محددة اجتماعياً، تتأثر أنساق الإنتاج والتوزيع بالعوامل الخارجية والتاريخية. كما يشير إلى وجود ممارسات وعلاقات محددة أخرى في جميع أنحاء العالم، ففي هولندا وإيطاليا، يرتبط بيع العجول أو الطماطم بالحصول على العلف والكلأ لقطعان الألبان. وبهذه الآلية، يتجنبون أن يصبح السوق المبدأ الناظم للإسطبل، وينأون بإنتاج الألبان عن السوق.
يعرّف الكاتب المزرعة الفلّاحية بأنها «الحصيلة المعقدة والدينامية لمداولات الأسرة الزراعية واعتباراتها الاستراتيجية». ويشير إلى أن المزارع الفلّاحية تعكس فن الزراعة12 من خلال ضبط التوازنات المختلفة وتنسيقها ببراعة. ويُعاد صوغ الحقول والماشية، واختيار وتحسين أصناف النبات، وتحديد مُدخلات العمل، وتكوين رأس المال، وتطوير المعرفة واستكشاف الشبكات. وتُربَط هذه التوازنات الكثيرة معاً في خطة تنظيمية متماسكة للمزرعة. والزراعة الفلّاحية وفق الكاتب مهيئة لإنتاج أكبر قيمة مضافة في الظروف المعطاة، وهي الأكثر استدامة بين أنماط الزراعة في جميع أنحاء العالم. في خلال أزمة كوفيد-19، طالت التبعات الاقتصادية جميع القطاعات الصناعية والتجارية، فالزراعة الرأسمالية تتمحور على إنتاج الأرباح، حتى لو عنى ذلك انخفاضاً في القيمة المضافة الكليّة. ولا تنقسم موارد المزرعة الفلّاحية إلى عناصر متعارضة (كالعمل مقابل رأس المال، أو العمل اليدوي مقابل العمل الذهني)، بل تمثل وحدة عضوية يديرها العاملون فيها. وبالتحديد، هي وحدة ذاتية التنظيم.
في زمن تشايانوف، كانت التعاونيات تمثل وعداً بالقوة المضادة. أما اليوم، فالتعاونيات السابقة تطوّرت إلى كيانات تعامل الفلّاحين كما تفعل إمبراطوريات الغذاء
تواجه الزراعة ضغوطاً متزايدة من الأسواق، إذ يستمر الضغط على الفارق بين الأسعار والتكاليف ويقل دخل العمل. هذه الأسواق عالمية، وحضور إمبراطوريات الغذاء ودينامياتها يعني أن المجموعة ذاتها من المؤشرات والمعايير والإجراءات تُطبّق على نطاق عالمي، وهي تقوم بنقل الإنتاج الزراعي إلى مناطق ذات تكاليف منخفضة. على الرغم من ذلك، تستمر الزراعة الفلّاحية في الصمود، ويعود ملايين الفلاحين إليها. يسعى الكثير منهم لاعتماد أساليب تعاون جديدة، ما يقود إلى عمليات إعادة تخطيط تغير الزراعة مادياً (مثل توسيع التعدد الوظيفي/أو استعادة الاستقلال الذاتي). تساعد هذه المرونة الفلاحين على البقاء والازدهار على الرغم من تجاهل قوى السوق الكبرى لهم. اليوم، يعيد الفلاحون ضبط توازناتهم ويبتكرون طرق زراعية جديدة تتعارض مع آليات النظام القائم واحتياجاته، ما يخلق شقوقاً جديدة تتيح مزيداً من النضالات والردود.
المزرعة الفلّاحية كنموذج تنظيمي، والتكنولوجيا في الزراعة، والريف المُفقر
يشير تشايانوف في كتاب «علم الزراعة الاجتماعي» أن العمل بمخططات أمر مستحيل. وهذا برأي فان دِر بلوخ، يدفع لتفضيل المزرعة الفلّاحية كنموذج تنظيمي لإدارة الإنتاج المشترك (نتاج التفاعل بين البشر والطبيعة). يُستبعد في الإنتاج المشترك التقييس والتخطيط الصارم. وفي كتاب «اقتصاد العمل»، يوضح تشايانوف أن الاقتصاد الفلّاحي لعام 1917 اختلف جذرياً عن العام 1905، إذ تغيرت طرق الحراثة وتربية الماشية، وكثر التعاون بين الفلاحين. اليوم، تتسبب التغيرات التكنولوجية والعلمية في تحول الزراعة الفلّاحية، من خلال استخدام البرمجيات والبيوت المحمية والكائنات المعدلة وراثياً وأنظمة الريّ الذكية وتطوير أصناف جديدة. ومع ذلك، تُهدّد هذه التغيرات نظم بذور الفلاحين والسيادة الغذائية للكثير من الشعوب، خصوصاً في الجنوب العالمي، وتُفاقم من تأثيرات التغير المناخي، خصوصاً بالاعتماد على مصادر الطاقة الأحفورية. لكن، يوضح الكاتب أن موقف تشايانوف ليس معادياً للتكنولوجيا، بل يعارض موقعها ضمن العلاقات الاقتصادية والاجتماعية القائمة التي تتسبب في توسيع الفجوة بين الفقراء والأغنياء.
ترتبط مشكلة الفقر العالمي وتحدّي إنهائه ارتباطاً وثيقاً بأولوية الاهتمام بالتنمية الريفية، وبمقاومة الناس العاملين في الريف للظروف المولّدة للفقر. وهذا لا يعني فصل القضايا الريفية عن القضايا الحضرية، إذ تفرض السياسات النيوليبرالية أشكالاً جديدة من الفقر الحضري. يذكر الكاتب أنه يوجد اليوم نحو 500 مليون أسرة فلّاحية تعمل في الزراعة، والغالبية تعيش في فقر مدقع، ويواصل عدد الفقراء الازدياد باطراد حول العالم، حيث يعيش 70% منهم في الأرياف ويعتمدون على الأنشطة الزراعية، في حين تستمر الشركات في الاستيلاء على الأراضي وتقويض سبل عيش الكثيرين. لكن هذا «الفقر الريفي» لا يقتصر على دول الجنوب العالمي، فالكثير من المزارعين الأوروبيين معرّضون للإفلاس ويتقاضون أقلّ من الحد الأدنى للأجور.
يجب الجمع بين المعضلات الأساسية للحركة الزراعية العالمية اليوم، مثل تخفيف الفقر، وكبح التغير المناخي، وبناء السيادة الغذائية، وتنمية الريف. في هذا السياق، يُذكّر الكاتب بأهمية الجدالات التاريخية بشأن الفلاحين والزراعة الفلّاحية، فهي تعكس السبل المختلفة لبناء وقائع اجتماعية مادية محدَّدة وتطويرها. وهنا تتجلى أهمية الدور السياسي للنظرية الفلّاحية التي أسسها تشايانوف، حيث يؤكد الكاتب أن الجمع بين تشايانوف وكثير من الأعمال التشايانوفية اللاحقة وبين المقاربات السياسية الجديدة يمكن أن يعزز فهمنا للصراعات الريفية، في الوقت الذي تحاول الحركات الريفية الجديدة أن تغيّر العالم.
يحيلنا الكاتب إلى كتابه «الفلّاحون الجدد» الصادر في العام 2008، ويشرح كيف استطاع تشايانوف تطوير تحليلٍ لاقتصاد المزرعة الفلّاحية ووحدات الإنتاج الأسريّة، وبناء نظرية نقدية لفهم المسائل الفلّاحية. ويشير إلى أن الزراعة الفلّاحية تُمارس من دون نظرية. ثم يُظهِر دلائل على سيرورة التحول الكبيرة اليوم نحو العودة إلى الطابع الفلّاحي، إذ تبرز هذه الظاهرة بأشكال متعددة، سواء من خلال انتشار المزارع العائلية الصغيرة في الصين وفيتنام ودول جنوب شرق آسيا، ما أدى إلى ظهور أكثر من 250 مليون مزرعة فلّاحية، أو من خلال الهجرة المعاكسة لمئات آلاف الفقراء في البرازيل، من العشوائيات في المدن باتجاه الريف، حيث شغل هؤلاء مناطق واسعة من الأرض، تحوّلت أخيراً بعد معارك طويلة وقاسية إلى كثير من الوحدات الفلّاحية الجديدة، ونما عدد الحيازات الصغيرة بنحو 400 ألف (زيادة بنسبة 10%) في مزارع ناشئة حديثاً تغطّي مساحة تبلغ 32 مليون هكتار. لكن هذه المزارع الفلّاحية الناشئة حديثاً من الصعب أن تنفصل عن محيطها الأوسع، إذ يمكن للعلاقات السلعية أن تخترقها، ما يجعلها معتمدة على السوق، وخصوصاً من جهة الإمدادات. في المقابل، قد تدعم بعض الظروف الاستقلال النسبي، حيث تميل الزراعة إلى أن تُبنى كزراعة فلّاحية.
التغاير في أساليب الزراعة وفقاً لتوازن الحجم والكثافة
يستعرض الكاتب مثال التغاير الواسع في أساليب الزراعة في شمال غرب أوروبا، حيث يتّسم كل أسلوب بعلاقات منظمة استراتيجياً مع أسواق المنبع التي توفر الموارد الضرورية. على سبيل المثال، نجد «المزارعين الطليعيين» الذين يشترون أحدث الجرارات والآلات، ثم يبيعونها بعد 4 سنوات (الفترة القانونية للاهتلاك) للحصول على المعدات الأحدث. في المقابل، يفضل «المزارعون المقتصدون» شراء الآلات المستعملة من المزارعين الطليعيين، وصيانتها بأنفسهم لتقليل التكاليف. ويشرح: «هكذا تتدفق الآلات بطرائق معينة، وتتبع هذه التدفقات سبلاً محددة عبر «الأسواق المتداخلة» التي تحددها التوازنات المتشابكة التي طورتها أساليب الزراعة المختلفة».
2.33 مليار شخص واجهوا غياب الأمن الغذائي بدرجات متوسطة أو حادة في العام 2024، بينما عانى 900 مليون شخص من غياب الأمن الغذائي الحاد. كما لم يتمكن أكثر من 3.1 مليار شخص من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي
يشير الحجم إلى عدد مواضيع العمل لكل وحدة من قوة العمل، بينما تشير الكثافة إلى الإنتاج لكلّ موضوع عمل. ويتيح التكثيف13 زيادة المداخيل الزراعية. في هذا السياق، نتبيّن أساليب زراعية مختلفة: أسلوب الزراعة المقتصِد الذي يتسم بحجم وكثافة منخفضين نسبياً، حيث تكون التكاليف الإجمالية منخفضة ودخل العمل مرتفعاً، وتُضبط التوازنات على نحو يقلَّلُ فيه الإنفاق على المواد الخارجية إلى الحد الأدنى، في حين تُعطى الأولوية للإنتاج المشترك. وهذا الأمر يحدّ من التبعية والاستغلال، ويجعل هذا الأسلوب شديد المرونة في ظروف الأزمات. في المقابل، يركز أسلوب الزراعة الكثيفة على عائدات مرتفعة، بينما يهدف أسلوب الزراعة الموفِّر للعمل إلى زيادة مواضيع العمل وتقليل مُدخلات العمل. أما الزراعة الكثيفة كبيرة الحجم، فتجمع بين السياسات الزراعية والتطور التكنولوجي واستراتيجية المقاولين الزراعيين، إذ تحفز السياسات إنشاء مزارع كبيرة وتوفر استقرار الأسعار، بينما يسعى المقاولون الزراعيون للاستحواذ على الموارد.
الأهمية البيئية للزراعة الفلّاحية وإعادة إضفاء الطابع الفلّاحي
يستند الكاتب إلى قاعدة التوازنات التشايانوفية لمناقشة التوازن بين البشر والطبيعة، مع التركيز على الأزمة البيئية المتسارعة. يشير إلى أن الزراعة تمثل إنتاجاً مشتركاً يتضمّن تفاعلات جارية وتغيرات متبادلة بين ما هو اجتماعي/بشري وما هو طبيعي، فالبشر يستعملون الطبيعة ويغيّرونها، وذلك يترك بدوره بصمة على المجتمع نفسه. ثم يُبرز صعود «الحركات الزراعية العابرة للقوميات»، مثل حركة لا ڨيا كامپيسينا، والوعي العالمي المتزايد بالزراعة الفلاحية كاستجابة للندرة المتزايدة من المواد الغذائية، والمياه، والطاقة، والعمالة المنتجة. تؤدي الزراعة الفلاحية أيضاً دوراً في التخفيف من آثار تغير المناخ، إذ تتميز بتأثير «مبرّد» بدلاً من تأثير «مسخّن». كما تقدم نموذجاً جديداً للإنتاج الغذائي يتمتع بمناعة قوية ضد الأزمات الاقتصادية والمالية التي تهدد الأمن الغذائي.
يعتبر الكاتب أن التحديث و«الثورة الخضراء» شكلا انقطاعاً عن الزراعة كإنتاج مشترك بين البشر والطبيعة. حلّت الأسمدة الكيميائية محل بيولوجيا التربة والسماد العضوي ومعرفة الفلاحين. وحلَّت المركزات الصناعية محلّ المروج والمراعي والعشب والتبن. واختفى السماد الطبيعي لصالح الإخصاب الاصطناعي ونقل الأجنّة والاختيار المحوسب للفحل الأفضل، وحلّت الإنارة الكهربائية محل ضوء الشمس في كثير من أعمال البستنة، في حين باتت فترة 24 ساعة تكفي لتسريع نمو الدجاج في حظائره بدلاً من يومين بليلتيهما. كما تضاءل دور الطاقة الشمسية لصالح الطاقة الأحفورية. وهذا كله يعكس تناقص دور الطبيعة، خصوصاً مع إعادة هندسة ما تبقى منها عبر التعديل الوراثي. ومع ذلك، يؤكد أن خطوات إيجابية لا تزال ممكنة، مثل الزراعة العضوية والزراعة قليلة المدخلات الخارجية، وأسلوب الزراعة المقتصِدة، والحركات الزراعية البيئية، التي تقترح إعادة ترتيب طويلة المدى بالعودة إلى مفهوم الإنتاج المشترك.
يشير الكاتب إلى أن تاريخ الزراعة الفلّاحية هو تاريخ التكثيف المستمر، إذ تمكن المزارعون عبر القرون من تحقيق زيادات ثابتة في العائدات. تمضي الزراعة الفلّاحية في مناطق لا تصلها المشاريع الرأسمالية، فتفتتح أراضٍ هامشية وتطورها إلى مزارع ومراعٍ، وتحقق مستوى أعلى من تكوين رأس المال لكل وحدة من الأرض باستخدام المزيد من العناصر لزيادة الإنتاج، وتسعى لتعظيم الإنتاج الصافي أو دخل العمل. بينما تسعى المزرعة الرأسمالية إلى تعظيم الربح. لكن الإنتاج لا يبلغ ذروته إلا بتوفّر الفضاء الاقتصادي السياسي المناسب. اعتبر تشايانوف زيادات العائدات ظاهرةً تقدمية وجزءاً من «تطور قوى الإنتاج». وقد تتطلب هذه الزيادات «علاقات إنتاج جديدة». وبالمثل، فإن علاقات إنتاج اجتماعية مناوئة قد تضعف التكثيف.
في النهاية، يعكس التدهور المخيف للأمن الغذائي العالمي إحياءً للأفكار التشايانوفية عن الزراعة الفلّاحية. يشير تقرير «حالة الأمن الغذائي والتغذية في العالم» لعام 2024، الذي تعده منظمات أممية عدة، إلى أن «2.33 مليار شخص واجهوا غياب الأمن الغذائي بدرجات متوسطة أو حادة، بينما عانى 900 مليون شخص من غياب الأمن الغذائي الحاد. كما لم يتمكن أكثر من 3.1 مليار شخص من تحمل تكاليف نظام غذائي صحي. ويعاني الكثير من الأطفال دون سن الخامسة من سوء التغذية». واللافت، وسط التأزم المتزايد للاقتصاد العالمي، أن التكاليف غير المباشرة للزراعة الرأسمالية أكبر بكثير من التكاليف المباشرة للزراعة الفلّاحية، على الرغم من أن الدعم الحكومي والسياسات النيوليبرالية تؤثر سلباً على الزراعة الفلّاحية عموماً. بالإضافة إلى ذلك، يجب النظر في جودة المحاصيل وتنوعها، ومدى كفاءة إدارة المزارع واستخدام الموارد، وحقوق المزارعين، والضرر البيئي، وفقدان التوازن المتزايد بين الأنشطة الاجتماعية/البشرية والطبيعة.
- 1
أُطلِقت هذه المبادرة تلبية لحاجة المدرّسين والباحثين والطلاب ونشطاء الحركات الاجتماعية وممارسي التنمية إلى كتب في الدراسات الفلّاحية تكون صارمة علمياً، وميسّرة، ورخيصة الثمن، ولها أهميتها السياسية وتوجهها السياسي. وكل كتاب في هذه السلسلة يشرح قضية تنموية محدّدة، ويجمع بين النقاش النظري والأمثلة التجريبية.
- 2
تُنتِج التعاونيات على جانب المنبع المدخلات (الأسمدة، الآلات، التسهيلات الائتمانية) وتوصلها إلى المزارع الفلّاحية، فيما تُعالج التعاونيات على جانب المصبّ منتجات المزارع الفلّاحية المختلفة وتسوّقها (المصدر: الفلّاحون وفنّ الزراعة: بيانٌ تشايانوفيّ).
- 3
الكولخوزات، أي المزارع الجماعية التي يشترك فيها جميع الفلّاحين بالإكراه بعد ضمّ أراضيهم إلى ملكية الدولة على الرغم من كونهم المنتجين المباشرين فيها، وعلى الرغم من عدم وجود علاقات عمل مأجور و«رأس مال» بالمعنى الماركسي في المزارع الفلّاحية.
- 4
واقع الأسرة الزراعية المادي، أي الأرض المتوفرة، والقوة العاملة، والحاجات الاستهلاكية، والحاجة إلى تكوين رأس المال، إلخ.
- 5
الخلفية البنيوية التي تعمل ضمنها الأسرة الزراعية، أي وضع السوق، وتوفّر الحِرف والمهن، ومستويات الأسعار، و«تأثير الثقافة الحضرية»، إلخ.
- 6
لكي يتحقق هذا التوازن، تحتاج الأسرة الفلّاحية إلى حصة عادلة من القيمة الإنتاجية تكفي لتلبية حاجاتها. ويجب للعلاقات التي تحكم سيرورة العمل أن تتيح الاستقلال والحرية في مكان العمل للأسرة الفلّاحية، لأنها الوحيدة التي تعرف الظروف الدقيقة في المزرعة وتقيّم التوازن المطلوب. بالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تُبنى سيرورة العمل على وحدة عضوية بين العمل العقلي واليدوي، فالعاملون هم الذين يتخذون القرارات الرئيسية. (المصدر نفسه)
- 7
يشمل الاستهلاك اليوم عناصر لا يمكن توفيرها داخل المزرعة، وتتطلب إدارة المزارع آلات ومعدات غير قابلة للإنتاج داخلها.
- 8
أحد نماذج حساب المتغيرات الذي عرضه فان دِر بلوخ هو نموذج يستخدمه مزارعون من شمال إيطاليا يعتمد على مهارات الفلّاحين الحرفية التي تشمل الاكتفاء الذاتي، ومُدخلات العمل المرتفعة، والشغف، والمعرفة. تحسن هذه المهارات يقابله عائدات أكبر، ما يؤدي إلى دخل أعلى ومزرعة أجمل وأكثر تنظيماً.
- 9
الهيئات الخارجية كالصناعات الزراعية، والمصارف، والشركات التجارية، ومتاجر البيع بالتجزئة، والتقنيين، والمرشدين الزراعيين.
- 10
يمكن قياس هذا الاستقلال النسبي (أو العكس، الاعتماد على السوق) باعتباره «درجة التسليع» (السيرورة التي تنتهي إلى كون عناصر الإنتاج وإعادة الإنتاج مُنتَجة من أجل التبادل في السوق ومُستحصَل عليها منه، ما يجعلها خاضعة لمنطقه).
- 11
ليس هناك في المزرعة الفلّاحية من حاجة جوهرية لإنتاج معدلٍ للعائد يساوي متوسط معدل الربح. فحتى لو كان معدل العائد (المفترض) سلبياً، يمكن للمزرعة الفلّاحية أن تواصل عملها وأن تزيد إرثها.
- 12
فنّ الزراعة: البناء المدروس والاستراتيجي لمزرعة من المزارع والعناصر الكثيرة التي تشكِّلها. وهذا الفن لا ينفصل عن البيئة الاقتصادية السياسية للمزرعة. وهو متشابك جوهرياً مع إعادة إنتاج التغاير.
- 13
التكثيف هو العملية التي تُنتِج زيادات في العائد. يُمكن أن يُدفع إما بالعمل أو بالتكنولوجيا. تتميّز الزراعة الفلّاحية بالتكثيف المدفوع بالعمل. والمسار المعاكس هو التكثيف المدفوع بالتكنولوجيا، حيث تكون زيادات العائد ناجمة في الأساس عن تطبيق تكنولوجيات جديدة ومُدخلات مقترنة بها. ويمكن القول نظرياً إن الاثنين ليسا متعارضين ويمكن جمعهما معاً. لكنهما يميلان، في الحياة الواقعية وضمن العلاقات الاقتصادية الاجتماعية القائمة، إلى إقصاء واحدهما الآخر. لا يعني هذا أنه ما من تكنولوجيا في التكثيف المدفوع بالعمل وأنه ما من عمل في التكثيف المدفوع بالتكنولوجيا. بل يعني أن الاثنين يشتملان على تقنيات شديدة الاختلاف في التصميم والتطبيق. (المصدر نفسه)