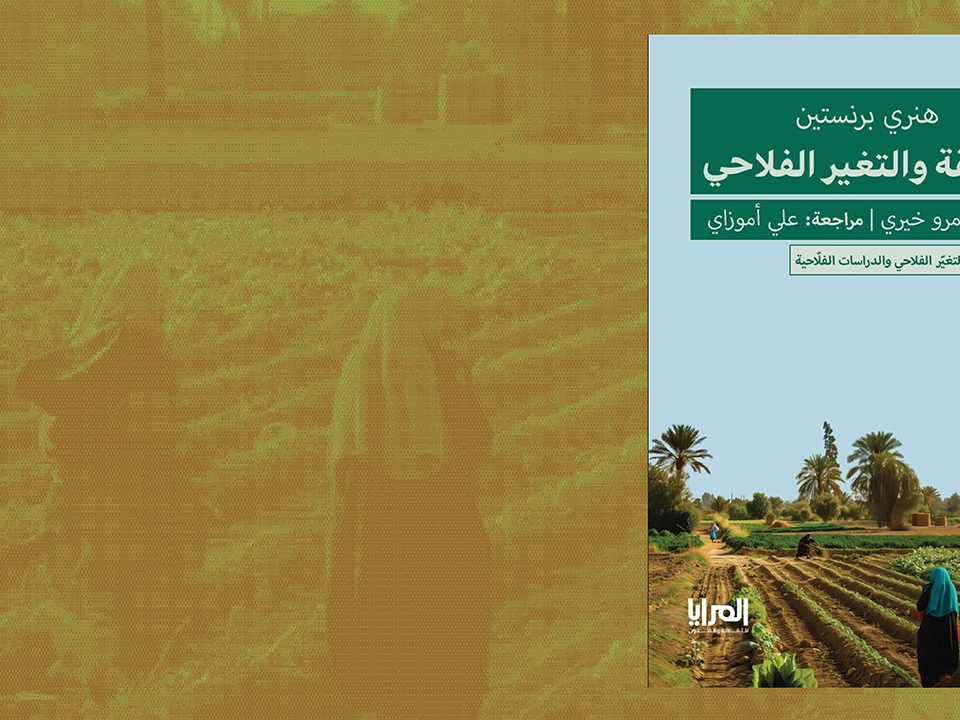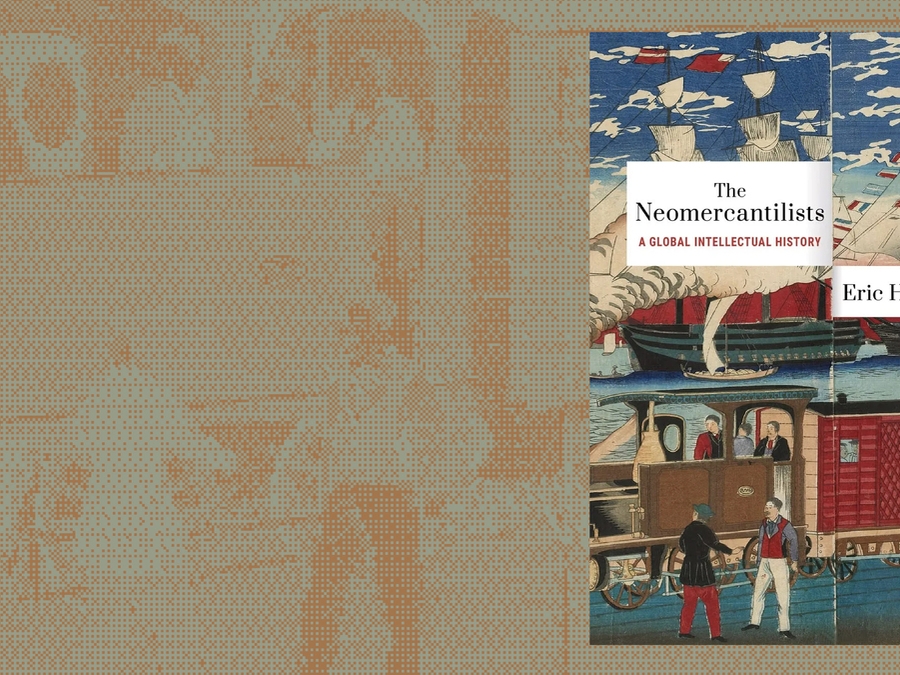كيف أدّى صعود اقتصاد السوق إلى تغيير العالم؟
مقتطف من مُقدِّمة كتاب باري بوزان وروبرت فالكنر «السوق في المجتمع الدولي العالمي: مقاربة على خُطى المدرسة الإنكليزية للاقتصاد السياسي الدولي». يتناول الكتاب تطور مفهوم السوق من مجرد فكرة اقتصادية إلى مبدأ حاكم وأيديولوجيا سياسية لها تأثير عميق في السياسة والمجتمع والعلاقات الدولية. ويجادل بأن التركيز على السوق – وليس التجارة أو الرأسمالية – هو الأفضل لفهم تحولات الاقتصاد العالمي، خصوصاً مع تعمق العولمة.
تُعَدّ السوق من أكثر المفاهيم تأثيراً في المجتمع الحديث. وتنبع قوتها من تداعياتها التي تمتدّ عميقاً إلى السياسة والمجتمع على الرغم من أنها تقدِّم نفسها في المقام الأول كفكرة اقتصادية قوية. وللسوق جذور في الفلسفة والممارسة القديمتين، إلا أن فكرة أن تكون آلية التنسيق المركزية في الاقتصاد السياسي العالمي لم تبرز إلا مع ظهور الفكر الاقتصادي الليبرالي كمنافس للمركنتيلية (المذهب التجاري) في أواخر القرنين 18 و19. ومنذ ذلك الحين، حدّدت الأيديولوجيات السياسية المتعارضة المواقف تجاه السوق. ولا تزال التساؤلات عن ما إذا كان ينبغي ترك السوق وشأنها أو تنظيمها من الدولة، وما إذا كان ينبغي تطبيقها بشكل ضيّق على المجال الاقتصادي أو على جوانب أخرى من المجتمع والسياسة، تتردّد في النقاشات السياسية المعاصرة.
ومع تعمّق العولمة الاقتصادية، ارتبطت هذه النقاشات بشكل متزايد بمسائل العلاقات الدولية، خصوصاً الدور الذي ينبغي أن تؤدّيه السوق في النظام الدولي. ولم يُولِ تخصّص العلاقات الدولية دائماً اهتماماً كافياً لهذه المسائل. فباستثناء فرع الاقتصاد السياسي الدولي، الذي جعل من العلاقات بين السياسة والاقتصاد الدوليين، وبين الدول والسوق العالمية، موضوعه الأساسي، لم تسعَ سوى مقاربات قليلة في العلاقات الدولية (باستثناء الماركسية) إلى تنظير السوق كمبدأ وآلية حوكمة في الشؤون الدولية. ويشمل هذا الإهمال أيضاً «المدرسة الإنكليزية»، التي تُقدّم الإطار النظري لهذه الدراسة.
قلّة من أتباع «المدرسة الإنكليزية» يمتلكون الخبرة اللازمة للتفكير بعمق في القطاع الاقتصادي كجزء من مخطّطهم للمجتمع الدولي والعالمي
إن ألطف وصف للعلاقة بين «المدرسة الإنكليزية» وموضوع الاقتصاد السياسي الدولي هو «نقص النمو»، مع أن مصطلحات أقوى مثل الإهمال واللامبالاة قد تبدو مُنصِفة أيضاً. ندرس هذه العلاقة بتفصيل، ونجد أن السبب الرئيس المُرجّح لها ليس مسألة مبدأ، بل حقيقة أن قلّة من أتباع «المدرسة الإنكليزية» يمتلكون الخبرة اللازمة للتفكير بعمق في القطاع الاقتصادي كجزء من مخطّطهم للمجتمع الدولي والعالمي. من ناحية أخرى، لا يبدو أن أياً من العاملين في الاقتصاد السياسي الدولي قد انجذب إلى التفكير في الموضوع من حيث مكانته في مجموعة المؤسسات الأساسية للمجتمع الدولي العالمي. ونرى أن هذا الإهمال المتبادل أضرّ بالطرفين، ونأمل أن يُنهيه هذا الكتاب.
ما نعنيه بـ«السوق»، كعنصر من عناصر البنية المعيارية للمجتمع الدولي، هو ما أسماه آخرون «السوق الحرة» أو «أيديولوجيا السوق» أو «أصولية السوق». تُبرز هذه المصطلحات استخدام مفهوم السوق ليس فقط كنظرية اقتصادية، بل كأيديولوجيا «سياسية» أيضاً. وتعزز أيديولوجيا السوق الكفاءة المزعومة للسوق لأغراض اقتصادية وسياسية. وهي مدعومة ليس فقط كنظام للتنظيم الاقتصادي، وكمنطق موجّه للابتكار والاستثمار، بل أيضاً لتعزيز وحماية الحرية الفردية، كنظام حوكمة. وهي تستند أيديولوجيا السوق إلى شرعية النظرية الاقتصادية كعلم لعزل السياسيين والمصرفيين والشركات عن مسؤولية تحديد توزيع الدخل والثروة. وتُستخدم، كما يُشير واتسون، «في محاولة لتطبيع مؤسسات السوق، وبالتالي سد الفجوة أمام مناقشة التسويات التوزيعية غير السوقية».
تستند أيديولوجيا السوق إلى شرعية النظرية الاقتصادية كعلم لعزل السياسيين والمصرفيين والشركات عن مسؤولية تحديد توزيع الدخل والثروة
وفي هذا الشكل - كمبدأ حاكم متجذّر في الأيديولوجيا السياسية - تتناسب السوق على نحو وثيق مع المؤسسات الأساسية الأخرى في المجتمع الدولي، على سبيل المثال: القومية كاعتقاد بأن الأمة هي مصدر الشرعية الأساسية للدولة، والإدارة البيئية كاعتقاد بأن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية إدارة المحيط البيئي الكوكبي، وتوازن القوى كاعتقاد بأن الدول بحاجة إلى إدارة توزيع السلطة فيما بينها إذا أرادت الحفاظ على الاستقرار، والسيادة كاعتقاد بأن لكل دولة الحق الأسمى في تقرير شؤونها الخاصة، والإقليمية كاعتقاد بأن الممارسة السياسية للسيادة يجب أن تُنظَّم ضمن مساحات إقليمية محدودة.
لماذا نُركِّز على السوق، بدلاً من التجارة أو الرأسمالية، كمفتاح للجمع بين الاقتصاد السياسي الدولي و«المدرسة الإنكليزية»؟ كما نوضِّح، اقترح بعض مفكّري «المدرسة الإنكليزية» التجارة، واقترح مايال «الليبرالية الاقتصادية». وفي الواقع، كما نُحاجج، ربما كانت التجارة خياراً مناسباً في عصور ما قبل الحداثة، عندما كانت غالباً ما تحكمها مبادئ غير سوقية. لكن منذ القرن 19، بدأ شيء أكبر بكثير يلوح في الأفق، على الرغم من أن الدعوة إلى «التجارة الحرة» كانت سمة بارزة لليبرالية الاقتصادية. ومع تقدّم التكامل الاقتصادي العالمي في خلال القرنين 19 و20، ازداد ترابط الاقتصادات الوطنية، ليس من خلال الروابط التجارية فحسب، ولكن أيضاً من خلال زيادة تدفقات الاستثمار والعولمة المالية. وبالتالي، فإن يفشل التركيز على التجارة في استيعاب التحول الأكثر شمولاً للاقتصاد العالمي، وللمجتمع الدولي العالم، الذي أحدثه صعود السوق.
يشير الكثير من مفكري الاقتصاد السياسي الدولي، خصوصاً أولئك الذين يعملون ضمن إطار التقليد البنيوي أو الماركسي، إلى الرأسمالية باعتبارها المحور الطبيعي لدراستنا. وعلى عكس التجارة، تشير «الرأسمالية» إلى نظام أكثر شمولاً للتنظيم الاقتصادي، قائم على مبدأ تراكم رأس المال والملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. وحتى خارج نطاق المقاربات البنيوية، يُشار إلى الرأسمالية على نطاق واسع بأنها النظام الاقتصادي الذي ارتقى إلى الصدارة العالمية جنباً إلى جنب مع النزعة التصنيعية والحداثة. لكننا نتفق مع هؤلاء المفكّرين الاقتصاديين السياسيين الذين يعتبرون صعود اقتصاد السوق - ما يصفه بولاني بأنه «المسعى الطوباوي لليبرالية الاقتصادية لإقامة نظام سوق مُنظَّم ذاتياً» - الحدث المركزي الذي يحدّد «التحوّل العظيم»، أولاً في أوروبا ثم في العالم.
نُشِر هذا النص في LSE Review of Books في 3 آذار/مارس 2025 بموجب رخصة المشاع الإبداعي.