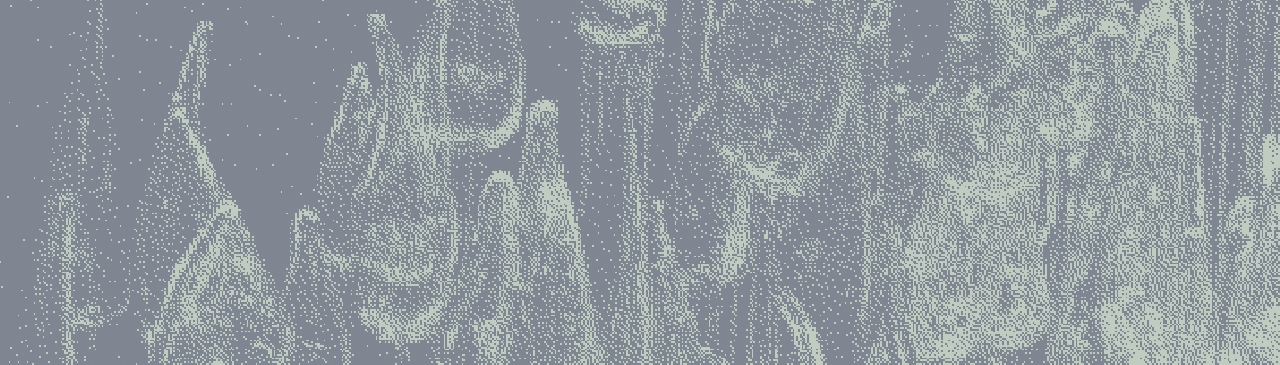
ما معنى الشهادة في زمن الذكاء الاصطناعي؟
مراجعة لكتاب مايكل ريتشاردسون «الشهادة غير البشرية: الحرب والبيانات والبيئة بعد نهاية العالم»، الذي يعيد التفكير في مفهومي الشهادة والإدراك ضمن عالم يتزايد فيه الاعتماد على الذكاء الاصطناعي، ليكشف كيف تُنتج التكنولوجيا والبيئة معاً معرفة سياسية وأخلاقية قائمة على التحيز الخوارزمي.
في ظل تصاعد التعقيد والانسيابية في أنماط التواصل بين الكيانات البشرية وغير البشرية، وبدء دول مثل ألمانيا باستخدام الذكاء الاصطناعي في إجراءات اللجوء، تصبح الحاجة إلى أبحاث تستكشف هذه التحوّلات أمراً ملحاً. يقدّم مايكل ريتشاردسون في كتابه «الشهادة غير البشرية: الحرب والبيانات والبيئة بعد نهاية العالم» قراءة نقدية راهنة تُسهم في إعادة صياغة الفهم المهيمن لمفهومي الشهادة والإدراك.
يكشف الكتاب حدود الأطر التقليدية ويواجه مفارقة إنتاج المعرفة ضمن الفكر الأوروبي السائد، مشككاً في اختزال أشكال الشهادة غير البشرية إلى مجرد «أدلة» وفي تبعيتها للتأويل البشري. في المقابل، يعيد ريتشاردسون تطوير مفهوم الشهادة بوصفه تشابكاً بين الكيانات البشرية وغير البشرية في سياقات الحرب التقنية-العلمية والأزمات البيئية والتحكم الخوارزمي. ومن خلال ملاحظته أن «الشهادة هي، ودائماً ما كانت، غير بشرية»، يدعو إلى إعادة تشكيل الشهادة كممارسة معرفية مشتركة بين البشر وغير البشر، ويقترح بذلك مفهوم «الشهادة غير البشرية» كمصطلح تحليلي يُستخدم لاستكشاف «علاقات تقنية وإعلامية وموضعية متنوعة تُنتج معرفة أخلاقية–سياسية من دون أن تُعطي الأفضلية للفاعل البشري».
يتتبّع ريتشاردسون التشابكات بين الأنظمة التقنية والبيئية والبُنى التحتية التي تتوسّط الأزمات، مبرزاً دورها في إنتاج المعرفة وتحديد معايير العدالة وتشكيل الذاتية السياسية. ويطوّر مفاهيم مثل «الوساطة العنيفة» و«التأثير الآلي» و«الصدمة البيئية» و«الغياب الجذري» لفهم الفاعلية غير البشرية بكل تعقيداتها. بالاستناد إلى بنية تقوم على «تثنيات مفهومية»، يعيد الكتاب تعريف الشهادة كعملية علاقية تولي أهمية لتوتراتها المعاصرة ومسؤولياتها الأخلاقية. يبدأ النص من حادثة الهجوم الجوي الذي شنّته القوات الأميركية في 21 شباط/فبراير 2010 على ولاية أوروزغان، الذي أودى بحياة 20 مدنياً أفغانياً، ليطرح سؤالاً جوهرياً: «من، أو ما، يمكنه أن يشهد؟». ويقوده هذا الانطلاق إلى كشف أشكال الفاعلية غير البشرية المتداخلة في الحدث وتوثيقه، مثل البُنى التقنية المتشابكة مع العنف والطائرات المسيّرة وأدواتها الحسية وآليات المراقبة الحسابية.
يبرز عبر تحليله لتقنيتي الديب فايك وتريبل تشايسر كيف تُعيد هذه الخوارزميات رسم الواقع، وتعيد تشكيل الإحساس والإدراك ما يمنحها سلطة شكلية تتخفى خلف غموضها البنيوي
يعتمد الفصل الأول على تنظير أنطوان بوسكيه (2018) لـ«النظرة العسكرية» – وهي نمط من الإدراك والتدمير يتوسّط عبر «طيف من القدرات الحسيّة» والتصوير والرسم الخرائطي «المرتبطة بإدارة الحرب» – لتطوير مفهوم «الوساطة العنيفة». تُجسّد هذه الوساطات الطابع غير المرئي والمتعدد الأوجه لأنظمة الاستهداف، التي تتّسم بـ«طبقات من المحاكاة والبيانات والنمذجة والخوارزميات». ومن خلال التركيز على الترابط بين التكنولوجيا والأجساد والبيئات، يُظهر الفصل كيف تُضيء هذه التقنيات تحوّلاً في الفاعلية، من الإنسان إلى العلاقات الشبكية.
يستعرض الفصل الثاني قدرة الخوارزميات التعلمية على تشييد عوالم رقمية، حيث يستخدم محاكي الطيران (2020) من مايكروسوفت كنموذج يكشف كيف تُنتج الخوارزميات مشاهد ثلاثية الأبعاد تتسم بالواقعية. ومن خلال ذلك، يعرض ريتشاردسون مفهوم «البيئات التكنولوجية-الوجدانية للشهادة» بوصفها تأثيرات آلية تفتح إمكانات للعلاقات بين الأجسام والتقنيات والأنظمة البيئية. ويبرز عبر تحليله لتقنيتي الديب فايك وتريبل تشايسر كيف تُعيد هذه الخوارزميات رسم الواقع، وتعيد تشكيل الإحساس والإدراك في مجالات مثل الجماليات الرقمية والتحقيق العدلي (93-95)، ما يمنحها سلطة شكلية تتخفى خلف غموضها البنيوي.
يركّز الفصل الثالث على كيفية تفاعل الكائنات غير البشرية مع الصدمة البيئية في ظل الكوارث المناخية والمخاطر النووية. ويستعين المؤلف بمفهوم ماسومي (2021) عن الأثر الشعوري بوصفه تداخلاً بين الواقعي والافتراضي، لشرح الطابع الشعوري العميق الذي يرافق الصدمة البيئية، كما يستند إلى أعمال دولوز (2001) في مناقشة «بيئات الشهادة». ويواصل الفصل الرابع هذا التحليل، متناولاً فيديو «رسالة إلى أميركا» الذي بثّه تنظيم داعش في العام 2014، واختفاء طائرة ماليزية في العام نفسه، بهدف دراسة حدة الغياب كما يظهر عبر الوسائط الرقمية – ما يسميه بـ«القطيعة الشعورية». ويعود ريتشاردسون إلى ماسومي مجدداً، مبيّناً كيف تُعيد الوساطة الرقمية تشكيل الصدمة، كما تؤثر في الذاكرة الجماعية والهوية المتبدّلة.
في ظل هذا التشابك بين الجمالية والتأثر وبين الصدمة والوساطة، يحدّد ريتشاردسون فعل الشهادة على ما يتعذّر إدراكه – أي أحداث لم تتجسّد فعلياً، لكنها تظلّ مشحونة وجدانياً بفعل وساطات تتجاوز الإنسان. ويشدّد الفصل على الطبيعة غير البشرية لما يسميه «الغيابات الجذرية»، بوصفها مصدراً للصدمة وفي الآن ذاته وسيلةً للتعبير عنها، بما يشكّل فعلاً مزدوجاً: الشهادة على الغياب وغياب الشهادة.
يختم الكتاب بتأمل في جائحة كوفيد-19 بوصفها لحظة كاشفة لتغلغل العوامل غير البشرية في وجودنا وتحويلها لطرق عيشنا بطرائق عميقة ولا تقاس. ومن خلال هذا الفصل كما عبر صفحات الكتاب، يبرهن ريتشاردسون أن الأنظمة الخوارزمية لا تعمل بشكل حيادي، بل تُعيد إنتاج أنماط الهيمنة التاريخية وتُكرّس بنى الإقصاء والسيطرة. ويستند في نقده إلى أطروحة س. وينتر بشأن المعرفة الاستعمارية والتصور الأوروبي للإنسان، وإلى تحليل س. نوبل لتحيّز الخوارزميات ومحركات البحث، لصياغة نقد جذري لمزاعم الحياد الخوارزمي. وإزاء هذا التشابك بين الإنساني واللامرئي غير البشري، يُعيد الكتاب التفكير في الشهادة غير البشرية كصيغة تواصلية مغايرة تتحدى البنى السياسية السائدة من خلال توسيع مفهوم الفاعلية لما يتجاوز الفاعل الإنساني.
يبرهن ريتشاردسون أن الأنظمة الخوارزمية لا تعمل بشكل حيادي، بل تُعيد إنتاج أنماط الهيمنة التاريخية وتُكرّس بنى الإقصاء والسيطرة
يُبني الكتاب أطروحته المفاهيمية على عرض دقيق وعميق يُقنع بضرورة تجاوز المقاربات السيميائية الضيّقة في فهم عمليات إنتاج المعرفة وتأويلها وترجمتها. ويطرح ريتشاردسون مفهوم الشهادة كترجمة في ذاتها، باعتبارها فعل تحويل لأنماط متعددة من المعلومات، من خلال التعرّف والتمرير وإعادة التشكيل. ويبدو جديراً بالاهتمام التساؤل ما إذا كان هذا التصوّر قابلاً للامتداد ليشمل مقاربات الترجمة والتفسير بمعناها الواسع. هذا الطرح يمكن أن يفتح مجالاً لنقاش خلّاق مع نظرية دوغلاس روبنسون (2024) حول "قابلية الترجمة (الآلية)"، والتي تضع اللغة في موقعٍ أدائي قادر على إعادة تكوين الواقع بدلاً من تمثيله بصورة سلبية.
ينطلق هذا الكتاب من نقد التصوّرات المتمركزة حول الإنسان والغرب، ويدعو القارئ إلى إعادة التفكير في مفهوم الشهادة. يُطلب منّا النظر إلى ما تؤديه الشهادة من علاقات ضمن عملية إنتاج المعرفة. يجمع الكتاب بين أطروحات مركزية من أدبيات الأثر الوجداني ودراسات الذاكرة والصدمة مع تحليل معمّق لرؤية الحاسوب والتعلّم الآلي وآليات عمل الخوارزميات. وبهذا، يشكّل الكتاب تدخلاً نقدياً وأصيلاً في الفهم السائد لمفهوم الشهادة. ومع تنوّع الحالات المدروسة تجريبياً، يتميّز بعمق تحليلي يضع الكائنات غير البشرية في صلب التحليل. يقدم الشهادة غير البشرية مرجعاً ابتكارياً من الناحية المفاهيمية، موجّهاً إلى طلاب وباحثين وممارسين في دراسات الإعلام والعلوم الإنسانية البيئية والفلسفة (خصوصاً الأخلاقيات التطبيقية) ودراسات الأمن، في سعيهم لفهم دور الكيانات غير البشرية – مثل الآلات وأنظمة البيانات والعمليات البيئية – في أداء الشهادة. كما يفتح الكتاب المجال لتفاعلٍ متعدد التخصصات، ويدعو إلى المزيد من البحث حول التحولات المعاصرة في التواصل وإنتاج المعرفة وبُنى التسجيل والبيانات وتداولها.
نُشِرت هذه المراجعة في LSE في 1 نيسان/أبريل 2025 بموجب رخصة المشاع الإبداعي.


