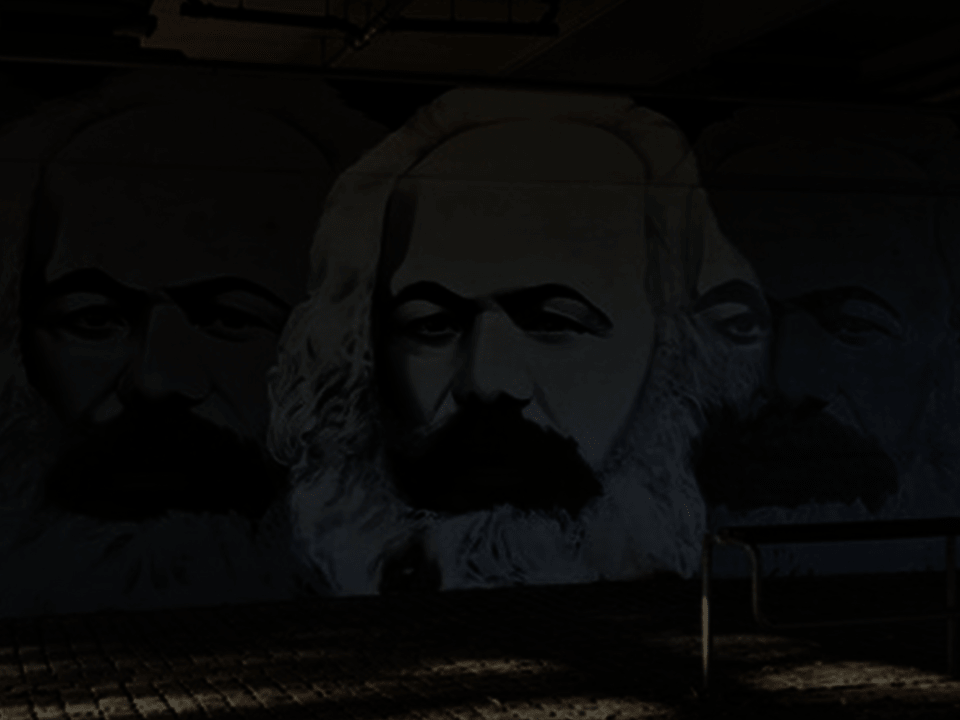تطور الرأسمالية في مصر
- كان نظام العزبة نتاج تدويل رأس المال، حيث نشأ كاستجابة مباشرة لإرتفاع الطلب الأجنبي على القطن المصري. وأما تلبية الطلب على القطن، عن طريق نظام استعباد الدين، فكان نتيجة لتوفر رأس المال الضروري لتمويل الديون.
- إن تاريخ مقاومة غزو رأس المال ضروري لفهم المجتمع المصري. لكن، يتعين علينا أن ندرك أن المقاومة لم تستطع إحراز الغلبة، لأن الرأسمالية ما زالت تحكم مصر. لذلك، فإن تاريخ الاقتصاد المصري، قبل كل شيء، هو تاريخ تَقدُّم رأس المال.
شهد الاقتصاد المصري، خلال القرنين المنصرمين، عدداً من التغيرات الهيكلية النوعية، فاقت في عمقها كل زيادة كمية في الإنتاج. ففي عام 1800، كان المجتمع المصري يتألف بالأساس من فلاحين ينتجون لاستهلاكهم الخاص ودفع الجباية، وهي نوعٌ من الضرائب كان يؤدَّى إلى سادة الريف. أما اليوم، فإن مصر تتمتع باقتصادٍ رأسمالي، حيث تقوم الشركات بتنظيم الإنتاج، وحيث تضطر الغالبية العظمى من السكان للعمل بأجر، وحيث السوق وليس المنزل هو مَصدر السلع الاستهلاكية ووجهة الإنتاج، وحيث الربح وليس إشباع الحاجات هو الهدف من الإنتاج.
تتلخص الفرضية المركزية في المقال الحالي، في أن تلك التغيرات التي طرأت على الاقتصاد المصري قد نتجت، أولاً وقبل كل شيء، عن المتطلبات المتغيرة للاقتصادات الرأسمالية المتقدمة. ومفاد نظريتنا أن بحث الصناعة الرأسمالية الأوربية عن المواد الخام، في القرن التاسع عشر، قد أدى إلى توجيه الإنتاج الزراعي المصري صوب السوق، عوضاً عن الاستهلاك المنزلي. لقد حَدّ سعي الرأسماليين الصناعيين الأوروبيين وراء الأسواق وليس المنافسين مِن تطور الصناعة المصرية. إلا أن الرأسمال الصناعي قد أفسح المجال أمام الرأسمال المالي في أوروبا أوائل القرن العشرين. وباعتماده على الشركات الكبرى التي تتمتع بالتمويل اللازم للتوسع، القادرة على نشر المخاطر، والتي لا ترتبط بموقعٍ جغرافي محدد أو صناعة واحدة؛ ينظر الرأسمال المالي إلى العالم بأسره بإعتباره مجموعة من المواقع الممكنة للاستثمار في صناعة مربحة. لقد حفز الرأسمال المالي الإنتاج الصناعي في مصر منذ عشرينيات القرن الماضي.
والنظرية التي نصدر عنها هنا، تتناقض تماماً مع النظرية القائلة بأن التنمية في مصر كانت موازية للتجربة الأوروبية، وإن كانت تاليةً لها وأبطأ وتيرة منها[1]. تُعيد النظرية الأخيرة محدودية النمو الاقتصادي إلى نقص المدخرات ونقص فرص الاستثمار (بفعل الأسواق المقيدة)، كما تفترض هذه النظرية أنه كلما زاد الدخل والمدخرات، كلما زادت فرص التنمية الشاملة، بما في ذلك التصنيع. وأما النظرية التي نصدر عنها، فتشير إلى أن ارتفاع الدخول في الفترة المبكرة من تدويل الرأسمال (فترة صادرات المواد الخام) سوف يقود إلى زيادة الواردات من السلع المُصنَّعة، وستُحْظَر الصناعة المحلية في خضم المنافسة مع مُنتِجِي البلدان المتقدمة. وستتطور الصناعة المحلية والبنية التحتية الاقتصادية بمعزلٍ عن التغيرات في الدخل في فترةٍ لاحقة، وذلك بفضل الرأسمال الأجنبي. وسيُدفع بأن هذه النظرية تتسق تماماً مع التجربة المصرية. في مصر القرن التاسع عشر، أدى ارتفاع الدخل إلى زيادة الواردات، مع انصراف المدخرات إلى الخارج أو في استملاك الأراضي. بعد الحرب العالمية الأولى، توسعت الصناعة والبنية التحتية المحلية، واستمرت في التوسع حتى في الثلاثينيات عندما انهارت الدخول والمدخرات.
وتذهب نظرية الاقتصاديين المبتذلين، المتعلقة بالتنمية والتجارة، إلى أن الرأسمال يتدفق صوب المناطق الغنية بالموارد الطبيعية والعمالة، لكن المفتقرة إلى الرأسمال. أما نظريتنا فتبيّن أن الرأسمال الأجنبي لم يستثمر كثيراً في مصر (وسيقتصر لاحقاً على الاستثمار في إنتاج القطن ولا غير) خلال الفترة الباكرة من تدويل الرأسمال، في وقتٍ شُغل فيه رأسماليو البلدان المتقدمة بالسعي من أجل الحصول على المواد الخام والأسواق اللازمة لصناعتهم. فيما تلى ذلك، غدت الشركات أكبر من ذي قبل وأكثر قدرة، بالتالي، على تحمل المخاطر، وتكاليف الرأسمال الضخم الضروري من أجل الاستثمار الأجنبي في الصناعة العامة.
تتناول المقالة الحالية فرضية أخرى، تتلخص في أن التنمية الاقتصادية المصرية قد مرّت بمراحل متميزة، لكلٍ منها ديناميكياتها الخاصة. في المرحلة الأولى، حل إنتاج السلع محل الإنتاج للاستهلاك المنزلي أو المحلي؛ في المرحلة الثانية، حل الإنتاج الرأسمالي محل الإنتاج السلعي غير الرأسمالي. وتتناقض وجهة النظر هذه مع نظريتين شائعتين. فطبقاً لأتباع والرشتاين، كانت مصر أساساً دولة رأسمالية منذ أوائل القرن التاسع عشر، عندما كان الإنتاج الزراعي يتوجّه، أكثر فأكثر، صوب السوق العالمية. في المقابل، ستكشف الدراسة الحالية عن أن مصر، قبل الحرب العالمية الأولى، لم تكن رأسمالية قَطّ، وذلك من ناحيتين مهمتين: الأولى، عدم اعتماد العملية الإنتاجية على العمل المأجور، وأما الثانية، فهي أن الإنتاج لم يكن موجهاً نحو تعظيم الربح (وانما إلى إشباع الحاجات الاعتيادية). إن الاندماج في السوق العالمية لا يقود تلقائياً إلى قيام الرأسمالية.
يُعرّف مصطلح الإمبريالية بمجموعة العلائق التي أنتجتها عملية التراكم الرأسمالي، ولا يُعرّف بالغزو الاستعماري والنهب القسري
أما النظرية الثانية، التي خضعت هنا للنقاش الموسع، فتذهب إلى أن مصر قد ظلت حتى عهد قريب، أو حتى أنها لا تزال إلى يومنا هذا مجتمعا لا رأسمالي، يمثل شكلاً من أشكال الاقطاعية الجديدة. مِن اليسار (سمير أمين، مثلاً)، مَن يجادل بأن الرأسمال الأجنبي قد حال دون تطور مصر، وأدى إلى استبقاء عناصر ما قبل الرأسمالية وتعزيز التخلف الاقتصادي. سوف تسلط الفقرات التالية الضوء على نمو الزراعة والصناعة الرأسمالية في مصر منذ الحرب العالمية الأولى، والدور المحوري الذي لعبه الرأسمال الأجنبي في هذا النمو.
خلال السنوات الستين الماضية، شدّد الكتاب الراديكاليون على الأثر السلبي العميق الذي تركته الرأسمالية الأوروبية (والأمريكية) على اقتصادات العالم الثالث. لسوء الطالع، يفترض المؤلفون الراديكاليون، في أغلب الأحيان، أن الأهداف التي سعى اليها رأسماليو البلدان المتقدمة في العالم الثالث، قد ظلت خلال القرون القليلة المنصرمة هي نفسها دون تغير. وعلى الرغم من إشادتهم بنظرية لينين عن الإمبريالية، ما لبث الكثيرون أن تخلوا عن مفهومه عن الإمبريالية كمرحلة من التطور الرأسمالي، محبذين النظريات التي تربط الإمبريالية بالبحث المستمر عن المواد الخام والأسواق. قِلةٌ هُمُ المؤلفون الذين سعوا إلى فهم كيف أدى ظهور الاحتكارات في الدول المتقدمة إلى تغيير طبيعة العلائق بين الدولة المتقدمة وبلدان العالم الثالث. يُعرّف مصطلح الإمبريالية بمجموعة العلائق التي أنتجتها عملية التراكم الرأسمالي، ولا يُعرّف بالغزو الاستعماري والنهب القسري. تنطوي الدراسة الراهنة على أطروحة رئيسية، مفادها أن تراكم الرأسمال في الدول المتقدمة قد مر بمراحل متمايزة، استناداً على تركيز ومركزة الرأسمال. أماط ماركس اللثام عن الديناميكيات التي بواسطتها تنتصر الوحدات الكبيرة من الرأسمال على الوحدات الصغيرة. شكلت رأسمالية ريادة الأعمال (أو ما يدعى بالمنافسة) المرحلة الأولى من الرأسمالية الصناعية، تلك التي حللها ماركس. أما الرأسمالية الاحتكارية، فقد تبلورت حين أحرزت الشركات الغلبة على رواد الأعمال. وتُواصل الشركات متعددة الجنسيات ورأسمالية الدولة، في يومنا هذا، عملية تركيز ومركزة الرأسمال.
تميزت كل مرحلة من مراحل الرأسمالية بآلياتها المقابلة لعلائق الدول المتقدمة بالعالم الثالث. وفي كتاب كريستيان بالويكس "الإقتصاد الرأسمالي العالمي والشركات متعددة الجنسيات"، تخضع تلك المراحل المتمايزة لنقاشٍ مثير للفكر، وإن كان يفتقر الى المنهجية. يحدد بالويكس تلك المراحل بدوائر الرأسمال التي حللها ماركس في المجلد الثاني من كتابه. كتب ماركس: يمر كل رأسمال فردي في دائرة: إنتاج مال البيع شراء العمل وعناصر الإنتاج إنتاج. نظر ماركس إلى هذه الدائرة من ثلاث نواحٍ: أولاً، بوصفها دائرة لبيع وشراء السلع؛ ثانياً، بوصفها دائرة لإنفاق الأموال واستردادها؛ وثالثاً، بوصفها دائرة لاستخدام المواد لإنتاج منتجٍ من أجل الحصول على المزيد من مواد الانتاج. جادل ماركس بأن كل دائرة من هذه الدوائر الثلاث تصبح ميداناً لجزءٍ خاص من الرأسمال: الرأسمال السلعي (التجار) والرأسمال النقدي (المصرفيون) والرأسمال المنتج (الصناعيون). ويقول بالويكس أن تلك الدوائر قد خضعت للتدويل عبر مراحل التراكم المختلفة في البلدان المتقدمة. أي أن قيام السوق العالمية كان مجرد لحظة واحدة في العملية المتصلة التي تربط الرأسمالية بالاقتصاد العالمي. ففي أعقاب ظهور السوق العالمية، ظهر الاستثمار على نطاقٍ عالمي، وفي أعقاب هذا الأخير برز الآن الإنتاج على نطاقٍ عالمي.
نمو السوق
كان هناك جانبان لنمو السوق في مصر خلال القرن التاسع عشر: زيادة الاستهلاك للسلع المشتراة من السوق، وزيادة الإنتاج للأسواق. وقد نشأ نمو الطلب، جزئياً، عن حاجةٍ إلى السلع الاستهلاكية البسيطة مما لا يمكن تصنيعه بالمنزل، كالثقاب على سبيل المثال. تَمَثل العنصر الحاسم، باديء الأمر، في عزم محمد علي، خلال العقد الأول من القرن التاسع عشر، على تعزيز قوته العسكرية. فنتيجة لمعاناة تجربة الغزو الفرنسي بقيادة نابليون، أحسّ محمد علي بأن الحفاظ على قوة الدولة المصرية إنما يقتضي تحديث الاقتصاد (بهدف إنتاج أسلحة على الطراز الأوروبي). لم يكن الإقبال المصري على البضائع الأوروبية هو العنصر الحاسم في نمو علائق السوق في مصر خلال القرن التاسع عشر، بل إن زيادة الطلب الأوروبي على المواد الخام الصناعية والمواد الغذائية، كان هو العامل الحاسم. قبل بزوغ الرأسمالية الصناعية الأوروبية مباشرة، كانت مصر تنعم بتجارة موسعة، بيد أن هذه التجارة لم تكن أكثر من مجرد مُناقلة (إعادة شحن) للسلع الكمالية [2]، ولم تؤثر كثيرا في الإنتاج المحلي. أخذ طلب الصناعات الأوروبية الجديدة في أوروبا يزداد، أكثر فأكثر، على المواد الخام، كما على المواد الغذائية لسكان المدن. أما قبل العام 1800، فقد كان الطلب الأوروبي ينحصر تقريباً في حاجة فرنسا المتزايدة إلى القمح اللازم لإطعام سكان مدنها الآخذين في الازدياد. وإن المحرك الرئيسي لحملة نابليون على مصر، انما يكمن في تطلعه إلى تأمين مخزن الغلال، الذي كان قد بدأ يزود الجنوب الفرنسي بالفعل[3]. إلا أن الصادرات المصرية من القمح لم ترتفع قَطّ إلى نسبٍ كبيرة. كانت المنافسة مع فرنسا جد عنيفة، لا من جانب روسيا والولايات المتحدة فحسب، بل ومن الفلاحين المصريين أيضا، حيث كان تناول القمح ضمن عاداتهم الغذائية الراسخة.
كان تدويل الرأسمال، وليس الشروط الداخلية في مصر، العامل الحاسم وراء نمو إنتاج القطن، وبالتالي، نمو السوق في مصر
وتبيَّن أن القطن هو المحصول الأكثر ملائمة للتربة والمناخ في مصر، حيث ينتج غلات عالية من أكثر أنواع القطن جودةً (القطن طويل التيلة). وكشأن جُل المجتمعات المتخلفة، تخصصت مصر في إنتاج مادة خام واحدة لا سبيل إلى إنتاجها في أوروبا. أما القصة التي تحكي عن دور القطن في تغيير مصر، فقد رُويتْ مِراراً [4]. كانت الحرب الأهلية الأميركية سبباً في ازدهار كبير: فقد قفزت زراعة القطن من 150.000 فدان في عام 1861، إلى 1.250.000 فدان في عام 1865. وبحلول القرن العشرين، غطت زراعة القطن نحواً من ثلث الأرض الزراعية، وهو الحد الطبيعي الأقصى، بالنظر إلى نظام التناوب المعمول به آنذاك.
كان تدويل الرأسمال، وليس الشروط الداخلية في مصر، العامل الحاسم وراء نمو إنتاج القطن، وبالتالي، نمو السوق في مصر. أما أطروحة عيسوي، التي ترى أن العامل الأساسي وراء التنمية انما يكمن في شخصية المؤسسات المصرية، بزعم أنها هي التي تحدد القدرة على الاستفادة من زيادة الصادرات، فما من دليل يعززها. خلال الفترة التي سبقت الحرب العالمية الأولى، تغيّرت المؤسسات المصرية من حيث طبيعتها تغيراً عميقاً، في حين بقي طابع التنمية على ما هو عليه؛ المزيد من صادرات القطن، والمزيد من واردات السلع المصنعة. تعود بداية الزراعة الأحادية في مصر إلى عهد محمد علي، الذي حاول إخضاع الإنتاج الزراعي لاحتكار الدولة. لكن جهوده باءت بالفشل على إثر أزمة مالية. ويرجع ذلك، من جهة، إلى أن الإنفاق الحكومي الضخم على أعمال الري، الهادفة إلى زيادة إنتاج القطن، لم يُدرّ دخلاً يُذكر (فقد كانت مياه الري في مصر مجانية على الدوام)، ومن جهة أخرى، لم تكن بيروقراطية الدولة على مستوى المهمة المنوطة بها والمتعلقة بتنظيم الإنتاج. عجز محمد علي عن تعظيم ربحه على حساب التجار الأوروبيين، نظراً لمواردهم المالية الكبيرة، ونظراً للضغط الذي مورس عليه من جانب الدول الأوروبية في اتجاه التشديد على حرية النشاط بالنسبة للتجار الأجانب. وهكذا، نَمَتْ زراعة القطن الأحادية في كل الأحوال، بقطع النظر عما إذا كانت مملوكة للدولة أو مملوكة للقطاع الخاص، وسواء أكانت تحت سيطرة الخديويين المصريين الفاسدة أم تحت سيطرة الاحتلال البريطاني بعد العام 1882. فما كان للهيكل المؤسسي أدنى صلة بالأمر.
التغيرات في حيازة الأرض: الملكية الخاصة وعبء الديون
شهد القرن التاسع عشر، فضلاً عن تعاظم إنتاج القطن، قيام الملكية الخاصة للأرض في مصر. وعلى غرار العديد من المجتمعات السابقة للرأسمالية، كانت الأرض في مصر تخضع لعددٍ من القيود: فكان حق الانتفاع يقتصر على فلاح واحد لا أكثر، بخلاف الإلتزام بأداء جزية معينة (ليست إيجاراً منتظماً، وإنما شيء أكثر مرونة) لسيد الأرض، وربما للسادة الآخرين أو الدولة. لا أحد "يتملك" ملكية يستطيع التصرف فيها، لكن يجوز للشخص نقل إلتزامه بشكل مستقل، وبناء على قواعد صارمة. وبقدر ما كان استبدال هذا النظام بالملكية الخاصة نتاجاً لاقتصاد القطن، بقدر ما كان إنتاج القطن المتزايد للسوق العالمية عاملاً حاسماً للتغيير الجذري في ملكية الأرض في مصر.
قبل عشرينيات القرن التاسع عشر، كان المجتمع المصري "إقطاعياً جديداً"، وهو اصطلاح مبهم وقع عليه الاختيار للتهرب من الجدل حول طبيعة مصر المملوكية. خضعت المدن لسيطرة التجارة، وتحكمت النقابات تماماً في الإنتاج [5]. قُيد المنتجين المباشرين (الفلاحين) إلى الأرض، فيما ظلوا أحراراً في تحديد المحاصيل التي يتعين تربيتها. كانت الأرض في حيازة المشاعات القروية، في صعيد مصر بصورةٍ أخص، وكان يعاد توزيعها دورياً، حيث تتصدى القرية ككل للقيام بعبء الضرائب، والسخرة في الأشغال العامة (قنوات الري بصفةٍ أساسية). وخلال القرن الثامن عشر، في مصر السفلى، كانت الضرائب تُقدّر فردياً، وكان بمستطاع أولئك الذين يؤدون الضرائب بانتظام أن ينقلوا أراضيهم إلى الورثة. وفضلاً عن هذا، تتوفر لدينا الأدلة على أن فلاحي مصر السفلى كانوا يعملون على هامش اقتصاد السوق، حيث كانت الضرائب تُجمع نقدا في الغالب الأعم، كما زُرعت بعض المحاصيل النقدية، التي غلب عليها القمح.
حاول محمد علي إخضاع الأرض لسيطرة الدولة المباشرة، كبديل للنظام اللامركزي القديم. إلا أن السيطرة المباشرة للحكومة المركزية قد بدأت في الاضمحلال، منذ أواخر ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وذلك عبر انبثاق أشكال جديدة من السيطرة على الأرض [6]. تلك الأشكال الجديدة لم ترتد ثانية إلى الترتيبات "الإقطاعية الجديدة"، التي اتسم بها النمط القديم الذي كانت تسيطر فيه الدولة ومالك الأرض بالتناوب. وعوضاً عن ذلك، اتخذت حيازة الأراضي شكلاً جديداً، وهو الملكية الخاصة للأرض. لا سبيل إلى تفسير ظهور الملكية الخاصة سوى بالإشارة إلى تطور إنتاج السلع. دَفَع الطلب على الريع لشراء السلع بالبعض، ولاسيما الدولة، إلى التنازل عن الحقوق مقابل النقد الجاهز، بينما حفز عند الآخرين الرغبة في السيطرة الكاملة على الأرض. كانت وفرة السلع المصنعة تعني طلباً أكبر مما كان عليه حين كانت الحاجات مقتصرة على المنتجات المنزلية، بحيث أصبحت مشاركة الإنتاج مع الملتزمين بالأرض، تشكل عبئاً أكبر. وعمل الوجهاء المحليون على إلغاء حقوق الفلاحين، لا سيما حقوق الانتفاع القديمة (أما الملكية الاسمية فقد ظلت دائماً بيد الدولة).
بقيت قروض الرهن العقاري تمثل ما يقرب من نصف الرأسمال الأجنبي في الشركات المصرية طوال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى
شهدت ملكية الأرض الخاصة تطورا سريعاً بين أصحاب العقارات الكبيرة، الذين حرصوا على تشديد سيطرتهم على أراضي الإلتزام على حساب الدولة والفلاحين. تمكن "المتحدين" (أصحاب العقارات الذين كانوا اسمياً من مزارعي الضرائب) من الإنتقال في وقت مبكر إلى وضع مُلاك الأراضي، مما أدى إلى تحويل المزارعين إلى مؤاكرين. كان أصحاب العقارات أكثر مَن أفاد مِن القوانين التي قضت ببيع الأراضي المملوكة للدولة (إسمياً في بعض الأحيان) بسعر منخفض. وبيعت الأرض لقاء ضريبة تؤدى لستة أعوام، بموجب قانون الخديوي إسماعيل لعام 1871. كما سمح قانون الأراضي، الصادر في 5 أغسطس 1858، على عهد الخديوي سعيد، بالاستحواذ على الملكية الكاملة لبعض الأراضي لقاء ضرائب تؤدى لمدة خمس سنوات متتالية، إضافة إلى القيام بحراثة الأرض. (وليس بالإمكان تحديد مدى اتساع مفعول هذا القانون). كما أنه أجاز بيع الأراضي ورهنها.
تمثلت السمة الرئيسية للفترة ما بين 1820-1882 في اضمحلال العلاقات ما قبل الرأسمالية، مثل المشاعة القروية، وظهور العلائق شبه الرأسمالية، كالإنتاج السلعي وملكية الأرض الخاصة. وهي علائق شبه رأسمالية من وجوهٍ عديدة. لم يكن العمل عملاً رأسمالياً مأجوراً. وبقي للمنتجين بعض السيطرة على وسائل الإنتاج (بعض الحقوق في الأرض؛ ملكية المزارعين للأدوات)، على الرغم من أنهم قد فقدوا بصورةٍ عامة السيطرة السابقة على الأرض. كان الفائض يستخرج لا من خلال الربح، بل من خلال الجباية، كما كانت الحال في السخرة التي كانت شائعة في هذا القرن. تعني علائق الإنتاج الرأسمالية الإنتاج من أجل التراكم، وليس لسد الحاجات. كان الإنتاج في مصر يتمحور، إلى حد بعيد، حول تلبية الاحتياجات التي راحت تتوسع بتأثير ما كانت تقدمه الصناعة الرأسمالية من منتجات جديدة. مما لا شك فيه أن ديناميكية تلك الفترة كانت تسير في اتجاه تدمير العلائق "النيو-إقطاعية" القديمة، لكنها لم تستبدلها بـ علاقات رأسمالية كاملة [7]. وأما هؤلاء الذين خلطوا بين إنتاج السلع وبين الرأسمالية، و"أندريه غوندر فرانك" في عدادهم، فيعجزون عن تفسير لماذا لم ينجم عن نمو تجارة السلع في مصر تراكماً عاماً للرأسمال؛ كالتصنيع مثلاً. وكما سيتكشف في البند التالي، فإن العوامل نفسها التي قادت إلى الإنتاج السلعي (قيام الصناعة الرأسمالية، والبحث عن المواد الخام والأسواق) قد حالت، في الوقت عينه، دون تطور الإنتاج الرأسمالي في مصر، الذي تعيّن عليه أن ينافس الصناعة الرأسمالية في البلدان المتقدمة.
منذ أواخر القرن التاسع عشر وحتى ما بعد الحرب العالمية الثانية، خضعت الزراعة المصرية لنظام استعباد الدين. نشأ هذا النظام نتيجة للطلب المتزايد على القطن، الذي استلزم التوسع في إنتاجه رأسمالاً يتجاوز قدرات صغار المزارعين. حصل هذا النظام على الكثير من الأموال من الخارج. يتعين علينا القول أن نظام العزبة يشكل طورا انتقالياً من مرحلة لتدويل الرأسمال إلى أخرى. فكما كان التركيز ينصب على التوسع في إنتاج المواد الخام في المرحلة السابقة، كان الرأسمال الأجنبي يستثمر في مصر لتوسيع الإنتاج في المرحلة اللاحقة. ويشكل نظام استعباد الدين، فضلاً عما تقدم ذكره، انتقالاً من مرحلة إنتاج السلع غير الرأسمالي السابقة، إلى مرحلة النظام الرأسمالي اللاحقة.
وتعاظمت الديون بقدر تعاظم إنتاج السلع في الريف المصري. أول الأمر أُجبر الفلاحون على السعي للحصول على قرضٍ موسمي يتم سداده عند حصاد القطن، من أجل البقاء على قيد الحياة أثناء نمو القطن، ومن أجل توسيع إنتاجه، الأمر الذي استلزم الإنفاق على أنظمة الري.
وما لبثت القروض الموسمية أن امتدت فصارت قروضاً طويلة الأجل بضمان الأرض. باديء الأمر، تردد تجار القطن، وهم المَصدر المبكر للتمويل، حيال منح قروض الرهن العقاري، نظراً لأن القانون الإسلامي والعثماني يمنع الرهن ويحظر استملاك الأجانب للأرض. مع إنشاء المحاكم المختلطة في عام 1875، أتى قانون الأراضي الأجنبي(الفرنسي في الغالب) ليقنن التعامل مع الأجانب.
أسفر الجمع بين الإقراض الأجنبي واستعباد الديون عن تعزيز اقتصاد القطن الذي يرتكز على الإنتاج غير الرأسمالي، وليس عن حفز التطور الرأسمالي
بعدها ارتفع اقراض الرهن العقاري: من أقل من مليون جنيه إسترليني في عام 1876 إلى مليون جنيه إسترليني في عام 1883، ثم إلى أكثر من 30 مليون جنيه إسترليني في عام 1905، وإلى حوالي 60 مليون جنيه إسترليني في عام 1914[8]. لم تكن الرهون العقارية مكرسة للديون المستحقة فحسب؛ بل إن العديد من الرهون خصص لشراء الأراضي. وعلى حين أن النسبة المئوية للأرض في العقارات الكبيرة ظلت ثابتة تقريباً، تعرض العديد من العقارات الفردية للتجزئة من خلال الميراث، وأدى شراء أراضٍ جديدة، بتمويل من الرهن العقاري، إلى تشكيل عقارات جديدة.
وفيما كانت عقارات الملاك تتوسع، كان الفلاحون يتحولون إلى معدمين بأعداد هائلة. وغني عن القول، أن تجريد الفلاحين من وسائل الإنتاج كان نتيجة إبتزاز الطبقة الحاكمة المتفاقم (الضرائب، مدفوعات الجباية بكافة أنواعها…إلخ). في السابق، كانت متطلبات الطبقة الحاكمة من الفلاحين تقتصر على الفائض عن الاستهلاك الضروري. أما الآن، وقد أمست وسائل الإنتاج (الأرض) سلعة، بات في استطاعة الطبقة الحاكمة أن تفرض على الفلاحين إلتزامات أكبر، ما كان هناك سبيلا للوفاء بها إلا عن طريق بيع أراضيهم. في ظل الاحتلال البريطاني، تجمعت البيانات المتعلقة بملكية الأرض. إن دمج هذه البيانات مع تعداد السكان يتيح لنا استنتاج عدد المعدمين (الخروج بتقديرات معقولة بصدد حجم الأُسر) [9]. وفي كتابه "القطن في مصر"، يقدر أوين أن ربع الأسر الريفية في العام 1907 كانت معدمة. وهو يقتبس عن تقريرٍ بريطاني، يفيد بأن 53% من سكان صعيد مصر، و 40% من سكان مصر الوسطى، و 36% من سكان الدلتا، كانوا بلا أرض في عام 1917. كما يظهر أن حجم الحيازات الخاصة بصغار الملاك كان في انخفاض.
كان نظام العزبة، الذي يبدو أنه أحرز السيطرة بحلول مطلع القرن، قائماً على ملكية الغائب، بالإضافة إلى مراقبٍ مأجور، وعمال مياومين يُطلق عليهم اسم التراحيل (مهاجرون غالبا)، وعمال سنويون [10]، جرى الدفع لهم نقدياً وعينياً، وكان الجزاء العيني يتكون من القسم غير القطني من الإنتاج، أو من قطع الأراضي التي لم تُستخدم في ذلك العام للقطن طبقاً لنظام التناوب. غالبًا ما كان المالك يوفر الرأسمال العامل لهؤلاء العمال، الذين كانوا كثيرا ما يقعون في ربقة الديون التي كانت تبتلع أجورهم. وعليه، فقد كان العمل في حقول القطن تسخيراً لم يدفع نظيره أجر. يقترب هذا النظام، في بعض الأحيان، من نظام الإيجار العيني أو النظام الإقطاعي-الجديد. لكن على خلاف الإقطاع، لم يكن للفلاحين أدنى حق في الانتفاع بالأرض، كما لم يكونوا مرتبطين بالأرض. على حين أنه في أوقات وأماكن أخرى، يمكن لهذا النظام أن يقترب من الرأسمالية، لا سيما حين ينهض عمال التراحيل بالكثير من العمل، وعندما يهتم المالك بتعظيم الأرباح (عوضا عن اهتمامه بتأمين وتعزيز الملكية).
أحد الاختلافات الكبرى بين نظام العزبة والنظام الرأسمالي، يتمثل في أن المالك أو من يمثله يتحكم في السلطةِ السياسية والقضائية، بحيث تنعدم تقريباً كل إمكانية لوجود علاقات تعاقدية منظمة، أو عقوبات لعدم الوفاء بالتعاقد.
كان نظام العزبة نتاج تدويل الرأسمال إلى حد كبير، حيث نشأ كاستجابة مباشرة لإرتفاع الطلب الأجنبي على القطن المصري. وأما تلبية الطلب على القطن، عن طريق نظام استعباد الدين، فكان نتيجة لتوفر الرأسمال الضروري لتمويل الديون، حيث كان حرص الفلاحين منصباً على توسيع إنتاجهم مع الحفاظ على دخلهم الحالي، وهو ما لا يمكن أن يتحقق عن طريقٍ بخلاف طريق الديون. جاء الإنتاج إلى حد كبير من الخارج. شكّل تجار القطن الأجانب المصدر الرئيسي للقرض الموسمي، والذي لعب دورا حاسماً في تسهيل التحول صوب المحاصيل النقدية. كانت الأموال تتدفق من أسواق المال الأوروبية، عبر البنوك التجارية الدولية (التي بدأت كبيوت تجارية)، وصولاً إلى كبار مالكي العقارات ومقرضي الأموال المحليين (جلهم من "المشرقيين" - اليونانيون واليهود والأقباط…، إلخ). في خضم هذه النشاطات، نشأ التجار الذين صاروا مصرفيين يمنحون قروضاً طويلة الأجل. وفّر الرأسمال الأجنبي كل الرهون العقارية تقريباً (80% منها على الأقل في عام 1914). مثّلتْ قروض الرهن العقاري الشكل الرئيسي للاستثمار الأجنبي في الشركات المصرية منذ عام 1883، وهو التاريخ الأقرب الذي تتوفر بيانات بصدده[11]. بقيت قروض الرهن العقاري تمثل ما يقرب من نصف الرأسمال الأجنبي في الشركات المصرية طوال فترة ما قبل الحرب العالمية الأولى. جزء من الرهون العقارية الممولة أجنبياً كان مصدره شركات الأراضي، التي توسعت على نحو ملحوظ في سنوات الازدهار قبل عام 1907. ابتاعت هذه الشركات الأرض لبيعها إلى المصريين بالقطعة، وبوجهٍ عام قامت بتمويل المبيعات ذاتياً. عقب انهيار عام 1907، احتفظت الشركات العقارية بأغلب أراضيها؛ حيث قامت بتأجيرها للفلاحين من أجل زراعة القطن [12]. بلغت الملكية العقارية للأجانب (وهي التي تمنعها الشريعة الإسلامية منعاً باتاً) 11.5% من مجموع الأراضي (550 ألف فدان) بحلول عام 1896، وهو أول عام تتوفر لدينا بيانات عنه. حاز الأجانب 23% من الأراضي التي تزيد مساحتها عن 50 فدان (503000 من مجمل 2.19 مليون فدان). مع اندلاع الحرب العالمية الأولى، ارتفعت الملكية الأجنبية إلى 13% (711 ألف فدان).
أسفر الجمع بين الإقراض الأجنبي واستعباد الديون عن تعزيز اقتصاد القطن الذي يرتكز على الإنتاج غير الرأسمالي، وليس عن حفز التطور الرأسمالي. مما لا جدال فيه أن نظام استعباد الدين قد خلق شريحة محدودة من العمال المأجورين يمكن الاستعانة بهم في الإنتاج الصناعي، أعني عمال التراحيل. ومع ذلك، فقد كان للقروض دوراً في تخفيف الضغوط، التي كان من شأنها أن تضطر جماهير الفلاحين إلى الإنصراف النهائي عن مواصلة الإنتاج على نطاق صغير. وعليه، فقد حالت القروض، التي عززت الإنتاج الصغير، دون تطور البروليتاريا الناضجة. وفضلاً عن كبحها لتبلور القوى العاملة، عملت القروض على لجم الإنتاج الصناعي المحلي (وهو شرط أساسي للتطور الرأسمالي)، وذلك عبر تعزيزها لزراعة القطن. كان الرأسمال الأجنبي مرتبطاً باقتصاد القطن، حيث وُضع المال الأجنبي حصرياً في خدمة تلك المشاريع التي وسعت من إنتاج القطن، وليس التي تتوسع على أساس أعلى ربحية، ناهيك بالصناعة. وإذا التجأنا إلى المفاهيم الماركسية، فقد كان المال المُقرض في مصر خلال هذه الحقبة هو الرأسمال الربوي ، وليس الإئتمان الرأسمالي. فبينما يُستخدم الثاني في تعزيز الإنتاج الرأسمالي ويمتد حيثما وُجدت معدلات ربح عالية، يعمل الرأسمال الربوي على تعزيز نظام الإنتاج اللارأسمالي المقترن به. يُضاعف الرأسمال الربوي من بؤس المنتجين في ظل النظام القديم عبر اغراقهم في الديون، من دون أن يحول علائق الإنتاج إلى نظامٍ جديدٍ يدشن لإنتاجية أعلى.
عرقلة الإنتاج الصناعي 1800-1919
شهد القرن التاسع عشر، الذي عرف هذا الانفجار في إنتاج القطن، انحساراً حقيقياً في الإنتاج الصناعي المصري. هذا التراجع في الإنتاج الصناعي لم يكن ناجماً عن الفقر، فلقد كانت مصر غنية وفقاً للمعايير المعاصرة [13]. كما لم يكن ناجماً عن السياسات الحكومية الخاطئة، سيلقي هذا البند الضوء على الدعم الحكومي الكبير للصناعة. سيحاجج هذا البند بأن الضغط الاقتصادي والسياسي الذي مارسه الإنتاج الصناعي القائم فعلا في أوروبا، أو بعبارة أخرى تدويل الرأسمال السلعي، كان العامل الرئيسي في كبح التنمية الصناعية.
اشتملت مجهودات محمد علي للنهوض بالاقتصاد المصري على إنشاء العديد من المصانع المحلية، إلا أنها جوبهت بمعوقاتٍ كبيرة. لم يقتصر دور التجار الأوروبيين على تصدير القطن من مصر؛ بل انهم استوردوا إليها البضائع المصنعة من أوروبا. اتسم الكثير من المصانع التي أنشأها محمد علي بتكاليف انتاجية أعلى وجودة أقل مقارنة بالمنتجات الأوروبية. ومع ذلك، شكّلت صناعة النسيج المحلية المصدر الرئيسي للأقمشة الرخيصة بحلول أوائل ثلاثينيات القرن التاسع عشر، وكانت توظف 30-40 ألف عامل، أو ما يقارب نصف مجموع القوى العاملة في مصانع علي. أما استمرار المصانع فمرده، جزئياً، إلى وضعها كاحتكارات حكومية، كما يعود إلى سوقها المضمون في الجيش. في أواخر أربعينيات القرن التاسع عشر، أغلقت جميع المصانع التي أقامها عليِّ علىَ وجه التقريب، لتحل محلها الواردات الأوروبية. لم يكن إخفاق علي في إنشاء صناعة حديثة في مصر قدراً محتوماً. حقّاً لقد جُوبِه بعقبةِ التنمية غير المتكافئة في مواجهته مع أوروبا، إلا أن التفاوت لم يكن قد أصبح بعد من الإتساع بحيث يستحيل تجاوزه. ربما كان في استطاعة علي تحقيق النجاح، على نحو ما فعلت اليابان بعد عدة عقود عندما غدتْ الفجوة أكثر اتساعاً. لكن الفشل الذي منيت به مصانع علي لا يرتد إلى قوى السوق (الإنتاج الأرخص في أوروبا) فحسب، بل وإلى القوى الأوروبية، التي فرضت التجارة الحرة على مصر، عن طريق الضغط على الباب العالي العثماني بهدف حظر الاحتكارات وتقليص الرسوم الجمركية إلى 8٪. أُجبر علي على تنفيذ هذه الإجراءات في أربعينيات القرن التاسع عشر. تلاشت الصناعة، ولم تطل برأسها حتى عشرينيات القرن الماضي. إن هيمنة الصناعة الرأسمالية الأوروبية لا تعني شيئاً أكثر من تدويل الرأسمال السلعي. كانت الصناعة الأوروبية تجهر بالعداء لأي منافس صناعي محتمل.
وعلى خطى علي، حاول الحكام لاحقاً تعزيز زيادة الإنتاج والاستقلال (الاقتصادي والسياسي)عن أوروبا. غير أن هذه الأهداف كانت معاكسة لبعضها البعض إلى حد كبير. لقد زادت صناعة النسيج الأوروبية من طلب السوق الخارجية على القطن. أصبح التوسع في إنتاج القطن مربحاً؛ غير أن التوسع في صادرات القطن جعل الاقتصاد المصري أقرب إلى أوروبا. وجدت الطبقة المصرية الناشئة من ملاك الأراضي سبيلها إلى تقليص الإنفاق الحكومي الهائل على أعمال الري والسكك الحديدية، عمل هذا على زيادة الدخل المصري، لكن القروض اللازمة لتمويلها قيدت مصر إلى دائنيها الأوروبيين. تجلى هذا بصورة بارزة في إنشاء المحاكم المختلطة عام 1875 للبت في القضايا بين الأجانب والمصريين، حيث كان بمقدور الأجانب فرض شروط مذلة على الحكومة، اضطرت إلى قبولها في نهاية المطاف تحت ضغوط القناصل. فكلما كانت الأرباح التي يجنيها الأجانب تتسع، كلما كانت فرص الحكومة المصرية لفرض الضرائب تضيق، ما كان يضطرها بالتالي إلى الإقتراض. والنتيجة: راح نفوذ الدائنين الأوروبيين المرتبطين بتجار القطن بأوثق وشيجة، يتعاظم أكثر فأكثر. قام الأوروبيون بفرض القيود على رسوم الاستيراد، بغرض خفض التعريفات الجمركية على تجارتهم. وبالنظر إلى الصناعة الأوروبية الوطيدة، أدت التجارة الحرة إلى الحد من تطور الصناعة المصرية، رغم المحاولات المتكررة لتأسيس الصناعة بأموال الدولة.
التراجع في الإنتاج الصناعي لم يكن ناجماً عن الفقر، فلقد كانت مصر غنية وفقاً للمعايير المعاصرة
هناك أسطورة شائعة مفادها أن إسراف الطبقة الحاكمة المصرية هو الذي قاد إلى تراكم الديون الخارجية على مصر. لقد عاش الخديويون حياة منحلة ولا مراء، إلا أن قروضهم الخارجية كانت ترمي، وإن جزئياً، إلى التوسع في إنتاج القطن، بل وإلى التراكم العام للرأسمال. فإن القروض، التي بلغ مجموعها في عام 1880 ما يقرب من 100 مليون جنيه إسترليني، إنما كانت مكرسة بالأساس للسكك الحديدية وأعمال الري وقناة السويس [14]. لقد كانت الفائدة على القروض تلتهم مبالغ هائلة.
بينما كانت الفائدة الإسمية حوالي 4%، تضخم سعر الفائدة الفعلي عبر تطبيق حسم القروض، بحيث تلقت الخزانة ما يقرب من ثُلثيْ القيمة الإسمية. ووقع الخديويون في شِباك أهدافهم المتضاربة. أرادوا التعجيل بالتراكم وتحقيق الاستقلال عن أوروبا (وتركيا). فكروا في استخدام القروض في تمويل التراكم بهدف التحرر من الهيمنة الأوروبية، فكانت النتيجة تعزيز تلك الهيمنة. تحت ضغط الدين العام الضخم المملوك للأجانب، اضطر الخديويين إلى تشجيع إنتاج سلعة القطن، وإلى المزيد من التخصص في إنتاج المواد الخام للتصدير.
اشتدت السيطرة الأوروبية بالتزامن مع تدهور الوضع المالي للحكومة. كشف تقرير لجنة التحقيق لعام 1878 عن توظيف 1300 أوروبي في الخدمة الحكومية. حاول إسماعيل مقاومة التعديات على سلطاته، فأثارت محاولاته السخط، وأُرغم على التنحي في عام 1879، ليحل محله توفيق الأكثر مرونة.
وما لبث توفيق أن فقد السيطرة على الوضع. وضَربت دعوة جمال الدين الأفغاني للقومية الأصلية (المرتبطة بخطاب النهضة الإسلامية) على وترٍ حساسٍ بين صفوف ملاك الأراضي الصغار، المهددين بقانون مصادرة الأراضي لعام 1876.
انضم المتمردون في الجيش بقيادة عرابي إلى أنصار الأفغاني، فجوبهت السيطرة الأوروبية بخطر الثورة، فقام البريطانيون بغزو مصر، وكانوا المسيطر الفعلي لأكثر من ستين عاماً. أما من الناحية القانونية فما كانوا يتمتعون سوى بسلطات محدودة خلال تلك المدة، حيث كانت مصر إحدى ولايات الإمبراطورية العثمانية حتى عام 1914، وأحرزت الاستقلال بعد عام 1936.
قام اللورد كرومر، القنصل العام، بالتلخيص الدقيق للسياسة البريطانية من عام 1882 إلى عام 1907. كانت الأولوية الأولى لموازنة الميزانية ومن ثم خفض الضرائب. على مدار العشرين عاما الأولى من الاحتلال، تم تخفيض الضرائب بما مجموعه 6 ملايين جنيه إسترليني سنوياً، وهو ما زعم كرومر أنه يعني انخفاضاً في نصيب الفرد من الضرائب من 1.030 جنيه إسترليني إلى 0.78715 (كان الجنيه المصري يعادل الجنيه الإسترليني حتى عام 1945) [15]. تضمن هذا التخفيض الضريبي تقليصاً هائلاً في نفقات الدولة، لا سيما وأن 79.5 مليون جنيه إسترليني (من إجمالي 241 مليون جنيهاً إسترلينياً أُنفقت خلال العشرين عاماً الأولى من الاحتلال) قد ذهبت للفائدة على الدين.
أما الأولوية الثانية لكرومر فكانت "... تُكرَّس كل المبالغ الكبيرة التي يمكن للحكومة أن توفرها للأشغال العامة المربحة". لم يتوفر للبريطانيين شيئا من المال إلا أنفقوه على توسيع نظام الري. صمم المهندسون البريطانيون العديد من القنوات وشبكات الصرف الجديدة؛ وشُيّد أول سد في أسوان (1898-1902) بتكلفة 3.5 مليون جنيه إسترليني. وجرى توسيع أنظمة السكك الحديدية والتلغراف وخُفّضت الأسعار بنسبة تصل إلى 50%. بحلول عام 1913، بلغت النفقات على نظام الري والسكك الحديدية والتلغراف 6 ملايين جنيه إسترليني من ميزانية تقدر ب 13 مليون جنيه إسترليني.
تحت ضغط الدين العام الضخم المملوك للأجانب، اضطر الخديويين إلى تشجيع إنتاج سلعة القطن، وإلى المزيد من التخصص في إنتاج المواد الخام للتصدير
عبّرت نفقات الأشغال العامة عن الافتراض الشائع القائل باعتماد مصر على إنتاج القطن. يفترض الرأي المعاصر، المصري والبريطاني على حد سواء، أن خصوبة التربة في مصر تضمن ازدهارها. عندما بدأت محاصيل القطن في الانخفاض في حوالي عام 1900، كان هناك نقاشاً حاداً حول كيفية استعادة الغلات. لم يقترح أحد تنويع الاقتصاد لتقليص الاعتماد على القطن. لم يكن الترويج للزراعة مؤامرة شيطانية دبرها البريطانيين لعرقلة التصنيع؛ لقد كانت محاولة للإدارة بما يتوافق مع مصلحة الشعب المصري. إلا أن النتيجة كانت واحدة: لم يكن ثمة صناعة مصرية في الفترة التي سبقت نشوب الحرب العالمية الأولى.
في أغلب الأحيان يُعزى الافتقار إلى الصناعة، خطأً، إلى سياسات التجارة الحرة للبريطانيين. وثمة مثال مشهور في هذا الصدد، يفيد أنه عند افتتاح أول مصنع حديث للنسيج منذ عهد محمد علي في عام 1899، بادر كرومر على الفور لفرض ضريبة بنسبة 8% بقصد تعويض رسوم الاستيراد بنسبة 8%. أُغلق المصنع في عام 1907 بسبب نقص المساعدة الحكومية ومواجهة الحماية الجمركية السلبية الصارمة (منذ أن استوردت أجهزته). وربما كان كرومر مؤمناً بفضائل التجارة الحرة وعدم التدخل، ولكن النقطة الجوهرية هي أن هذه المبادئ لم تمنع الحكومة من تقديم الدعم الكبير لقطاع القطن. لم تكن الحكومة محايدة بين الصناعة والزراعة. فعلى حين كانت تضخ موارد هائلة في البنية التحتية والمساعدة الفنية للزراعة، بدا أنها لم تكن مستعدة لبذل أدنى جهد في مساعدة الصناعيين [16]. لعبت المعارضة البريطانية للمعونة الحكومية للصناعة دوراً كبيرا في عرقلة تطور العلائق الرأسمالية في مصر من 1882 إلى 1919. أعاقت السياسات البريطانية الأخرى نشوء العلائق الرأسمالية، تلك السياسات التي كانت تعكس تدويل الرأسمال السلعي. أدى تشجيع صادرات القطن (مقروناً بالتوسع في صناعة النسيج الأوروبية) إلى تعزيز قطاع القطن، مما أضعف الإقبال على الإستثمار في القطاعات الأخرى. شكل التقدم التكنولوجي البريطاني المضطرد قياساً إلى مصر، عقبة إضافية أمام نشأة الصناعة المحلية. حلت المنافسة الأوروبية محل المنتجين المحليين للكثير من السلع؛ بحلول منتصف القرن التاسع عشر، تلاشت النقابات التقليدية بصورةٍ عامة. لم تكن قاعدة القطن هي المحطة الأولى على طريق التنمية المؤدية إلى التصنيع في نهاية المطاف. أدى ارتفاع الدخل من اقتصاد القطن إلى انخفاض الإنتاج في العديد من القطاعات الأخرى. لم يكن انفصال إنتاج القطن عن بقية الاقتصاد المصري نتاجاً عرضياً للبنية المؤسسية المصرية، كما يشير عيسوي. لا يمكن أن تتحقق التنمية الشاملة، والصناعة على وجه الخصوص، إلا بعد وقوع عددٍ من التغييرات الأساسية في العلاقة بين مصر والاقتصاد العالمي.
الرأسمال الأجنبي والصناعة المحلية 1919-1945
بعد زهاء قرن من التوسع في تصدير القطن، والإعتماد على الواردات الأوربية كمصدرٍ للسلع المُصنّعة، تعرض الإقتصاد المصري للتغيّر بعد الحرب العالمية الأولى. تراجعت صادرت القطن، وحل الإنتاج الصناعي المحلي مكان استيراد السلع الإستهلاكية. تطورت الرأسمالية في الصناعة والزراعة على امتداد السنوات الستين السابقة. الفرضية الأساسية لهذه الدراسة، تتقوم في أن الرأسمالية المصرية قد تطورت بفعل الرأسمال الأجنبي.
لعبت المعارضة البريطانية للمعونة الحكومية للصناعة دوراً كبيرا في عرقلة تطور العلائق الرأسمالية في مصر من 1882 إلى 1919
إن الأطروحة الرئيسية التي تمحورت حولها الكتابات الراديكالية عن التنمية خلال السنوات الستين السابقة، تتلخص في أن الرأسمال الأجنبي يعرقل تصنيع البلدان المتخلفة. قدم بول باران الصياغة الكلاسيكية لهذه النظرية في كتابه "الاقتصاد السياسي للنمو". اضطلع اندريه غوندر فرانك في كتابه "الرأسمالية والتخلف في أميركا اللاتينية" بتطوير أطروحة باران، قائلاً أن ضعف سيطرة المدينة على الأطراف هو الذي حدد نشأة التصنيع في أميركا اللاتينية. ثم وجدت النظرية تطورها عند سمير أمين الذي قال أن تصنيع العالم الثالث هو ثمرة كفاح مظفر ضد الرأسمال الأجنبي. يذهب أمين في كتابه "الأمة العربية"، إلى أنه أن لا سبيل إلى بدء التصنيع العربي إلا إذا فرضت "البرجوازية الوطنية" على الإمبريالية إعادة النظر في التقسيم الدولي للعمل. ينطوي هذا الرأي الراديكالي على قدرٍ من الحقيقة: ففي خلال الفترة المبكرة من تدويل الرأسمال، وقف الرأسمال الأجنبي موقف المعارض تجاه الصناعة المحلية. ستبيّن الدراسة الحالية أن الرأسمال الأجنبي سوف ينشط، لاحقاً، في العمل على تعزيز التطور الرأسمالي. إن وجهة نظر سمير أمين الراديكالية، بتشديدها أحادي الطرف على التأثيرات المثبطة للرأسمال الأجنبي، لا تقل خطأ عن وجهة النظر السابقة لماركس ولينين، التي بالغت في تقدير مساهمة الرأسمال الأجنبي في التطور الرأسمالي [17]. نتيجة لصعود الإمبريالية، قام الرأسمال الأجنبي بالإستثمار في الصناعة المصرية خلال تلك الحقبة. هيمن الرأسمال المالي على الرأسمال الصناعي في البلدان المتقدمة. لم يكن الرأسمال الصناعي يرى في الأجزاء المتخلفة أكثر من مصدرٍ للمواد الخام وسوق للإنتاج. كان إهتمام الرأسماليون الصناعيون بتراكم الرأسمال في مشاريعهم الخاصة يصرفهم عن الاستثمار في المناطق المتخلفة. هذا الإستثمار الذي يقتضي من الرأسمال الفردي حجماً كافياً للقيام بمشاريع ضخمة تحف بها المخاطر في الخارج. يستند الرأسمال المالي على الشركات الضخمة التي تتمتع بالقدرة على الحصول على التمويل عبر البنوك وأسواق الإئتمان، والتي يمكنها نشر المخاطر ولكن يحتمل أن تكون فائقة الربحية. وفي العصر الحديث، غالبا ما تتحول الشركات العملاقة عن أسواقها المحلية المشبعة صوب أسواق جديدة بالخارج، سعياً للحفاظ على النمو. يستثمر الرأسماليين الماليين في أي مشروع طالما أنه يَعِد بأعلى معدل للربح، ولا يعرفون التقيد بحدود صناعة معينة أو شركة أو دولة. ولذلك، فحين انخفضت معدلات الربح في ثلاثينيات القرن الماضي، زادت استثمارات الرأسماليون من بريطانيا وفرنسا في مصر، ما سمح بالإبقاء على الأرباح مرتفعة. بدعمٍ من الحركة القومية وعون الدولة، نمت الصناعة المصرية بالإعتماد على الرأسمال الأجنبي قبل كل شيء، فهو ولا سواه القادر على توفير النقد الأجنبي الإضافي اللازم لاستيراد الآلات التي هي عماد الصناعة.
بالإضافة إلى هذا، مهّد الرأسمال الأجنبي السبيل أمام الصناعة المحلية على نحو ٍ غير مباشر. لقد خلق اقتصاد القطن، الذي كان نتاجاً لطلب الرأسمال الأجنبي على المواد الخام الصناعية، شريحةً من العمال الأجراء المحتملين، عن طريق تجريد بعض الفلاحين من كل حقٍ في الأرض، مما اضطرهم بالتالي إلى العمل المأجور. كما أرسى اقتصاد القطن الأساس للأفكار البرجوازية في مصر، وفي عدادها الأفكار القومية، التي لعبت دوراً حاسماً في الدعم المحلي للنمو الصناعي. النقطة الجوهرية في هذا القسم تتعلق لا بالدور غير المباشر والأيديولوجي للرأسمال الأجنبي، وإنما تتعلق بدوره الإقتصادي المباشر والمحدد.
نمت الصناعة المصرية بالإعتماد على الرأسمال الأجنبي قبل كل شيء، فهو ولا سواه القادر على توفير النقد الأجنبي الإضافي اللازم لاستيراد الآلات التي هي عماد الصناعة
تدين الصناعة بصعودها للموقف المتغير لملاك الأراضي والتجار، وتحولهم إلى البحث عن مراكمة الرأسمال عن طريق الإستثمار في الإنتاج الصناعي، ومع ذلك، فقد كان الرأسمال الأجنبي هو العنصر الحاسم في نشأتها. والأرقام التي يقتبسها كراوتشلي[18] تسلط الضوء على الأهمية الحاسمة للصناعات المملوكة للأجانب. في العام 1934، كان ما يقرب من 77% من أصول الشركات الصناعية والتجارية، و85% من أصول جميع الشركات، ضمن شركات مساهمة أجنبية. ثمة هنا مبالغة في أهمية الرأسمال الأجنبي من حيث أن البيانات تشير إلى الشركات ولا غير. ويقدر جريتلي أن ما يزيد عن 50% من الرأسمال الصناعي كان في شركات من المفترض أنها تشمل جل الإنتاج الحديث غير الحرفي. وعليه، فإن ما لا يقل عن 35% من إجمالي الرأسمال الصناعي كان في شركات ذات مساهمة أجنبية. إلا أن بيانات كراوتشلي تقلل من أهمية الرأسمال الأجنبي بطريقتين على أقل تقدير.
كان لدى منتجي الشركات المملوكة للأجانب، ربما حتى أكثر من كبار المنتجين الآخرين، إمكانية الحصول على المزيد من القروض المصرفية التي كان يحصل عليها صغار المنتجين، بحيث كانت نسبة الشركات المملوكة للأجانب من إجمالي الرأسمال أكبر من نسبة رأسمالها المساهم. ثانيا، تضمن إنشاء الصناعة المصرية المحلية زمرة وازنة من الأجانب المقيمين بمصر. حين تأسس اتحاد الصناعة المصري عام 1922، كان الأحد عشر مديرا يعيشون جميعاً في مصر، إلا أن ثلاثة منهم فقط كانوا مواطنين مصريين [19]. لم يكن من بينهم واحد من ممثلي الشركات الأجنبية. يشير تعداد عام 1927، إلى 226000 مقيم مصري من مواطني البلدان الأوروبية. العديد منهم كان يعيش بمصر منذ عقود. يبدو من المتعين إدراج المواطنين الأجانب بين ذوي الرأسمال الأجنبي. لكن إحصاءات الحكومة المصرية تشير إلى الأصول الاحصائية التي يحوزها الأجانب ممن يعيشون بمصر بوصفها "أصولا مملوكة محلياً". ومن ثم، فإن الأرقام تقلص من حجم السيطرة الأجنبية على الصناعة المصرية.
كان المصريون يسيطرون، نظرياً، على كل الشركات المحلية، بما فيها تلك التي تتضمن مساهمة أجنبية. في ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين تبلورت بالتدريج قوانين صارمة ترمي إلى تمصير الشركات. نصّ قانون 1947 على ضرورة أن يكون 51% من الرأسمال، و 40% من مجلس الإدارة، و 75% من الموظفين بأجر، و 90% من العمال، من المصريين. لكن كثيرا ما كان يُضرب بالقوانين عرض الحائط أو أنها كانت تطاع ظاهريا ليس إلا. يوضح جريتلي الدور التافه الذي لعبه السكان المحليين في الإدارة اليومية: "كثيراً ما يشاع أن المصالح الأجنبية المهيمنة تقبض على زمام السلطة بينما المصريون يقبعون في المجلس، كرجال القش، ممتثلين على مضض لنص القانون ". إجمالاً، كان الأجانب يملكون ويديرون الصناعة المصرية عموما.
حين تأسس اتحاد الصناعة المصري عام 1922، كان الأحد عشر مديرا يعيشون جميعاً في مصر، إلا أن ثلاثة منهم فقط كانوا مواطنين مصريين
بخلاف العديد من النظريات الراديكالية، تشير نظرية تدويل الرأسمال إلى استحالة التصنيع من دون دعم الرأسمال الأجنبي. لا يوجد مصدر للخبرة والتكنولوجيا بخلاف المصادر الأجنبية. لقد أدى استيراد السلع المصنعة إلى تدمير الانتاج المصري المحلي، فأصبح الخارج هو المصدر الوحيد للآلات. تحت ضغط هذا الواقع الإقتصادي، اضطر القوميين المصريين إلى العمل برأسمال أجنبي. كان بنك مصر، الذي تأسس على خلفية الإنحسار القومي لثورة 1919، معارضاً في البداية لكل تعاون مع الرأسمال الأجنبي. إلا أنه بحلول الثلاثينيات، بالتزامن مع بداية الطفرة الصناعية الحقيقية، قام بنك مصر بتغيير موقفه، واضطر إلى البحث عن التكنولوجيا الأجنبية والاستعانة بشركاءٍ أجانب هددوا بتطوير إنتاجِ محلي منافس لشركات بنك مصر.
لم يكن هناك مهرب من استيراد كلاً من السلع الاستهلاكية المصنعة والسلع الآلية، وعليه، فقد أدت زيادة تراكم الرأسمال في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي إلى زيادة في الطلب على الواردات. على حين لم تشهد الصادرات نموا مماثلا. كان تصدير المواد الخام (القطن) هو المصدر الوحيد لعائدات التصدير، ومع ذلك، لم يكن الطلب على المواد الخام ينمو بمثل هذه السرعة. وفي عبارة موجزة، قاد ظهور الصناعة إلى الضغط على ميزان المدفوعات. بدون الرأسمال الأجنبي، يستحيل التوسع في استيراد السلع اللازمة للصناعات الجديدة.
كان من حُسن الطالع لمصر أن تدخل في تلك المرحلة من تدويل الرأسمال باحتياطي كبير من النقد الأجنبي عمل على تسريع التراكم الأولي للرأسمال. خلال الحرب العالمية الأولى وما تلاها، ارتفعت قيمة صادرات القطن بالتلازم مع ارتفاع أسعاره. جرى استخدام الإيرادات المتزايدة في تصفية الديون وتراكم الحيازة بنحو 150 مليون جنيه مصري في الاستثمارات الأجنبية. ساعدت هذه الأموال في التخفيف من الانهيار في مصر خلال أواخر عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، عندما انخفض سعر القطن انخفاضا حادا على خلفية توقف الصناعة الأوروبية عن التوسع. بلغ متوسط صادرات القطن 23.4 مليون جنيه إسترليني في ثلاثينيات من القرن الماضي، منخفضا عن متوسط 34.1 مليون جنيه إسترليني في 1915-1929. خلال الثلاثينيات من القرن الماضي ، عانت مصر من ضغوط حادة في أسعار الصرف الأجنبي. وبالنظر إلى أن الجنيه المصري كان قابلاً للتحويل بالكامل إلى الجنيه الاسترليني حتى الحرب العالمية الثانية، كان الانخفاض في عائدات التصدير يعني انخفاضاً فورياً في القدرة على الاستيراد، حيث كان المجال منعدما للتلاعب بالعملة. تركز العبء الأكبر للانخفاض في الواردات على السلع الاستهلاكية، حيث انخفضت وارداتها بأكثر من 70% في ثلاثينيات القرن الماضي مقارنة بعشرينياته. سد الإنتاج المحلي نصف الانخفاض في واردات المستهلكين بقيمة 30 مليون جنيه إسترليني لا غير. من 7 ملايين جنيه إسترليني في عام 1929، ارتفعت القيمة المضافة الصناعية إلى حد أقصى قدره 25 مليون جنيه إسترليني في عام 1940، بما لا يزيد عن 18 مليون جنيه إسترليني.
قاد ظهور الصناعة إلى الضغط على ميزان المدفوعات. بدون الرأسمال الأجنبي، يستحيل التوسع في استيراد السلع اللازمة للصناعات الجديدة
بعبارة أخرى، نشأ التصنيع المصري في الثلاثينيات رغم الانخفاض الكبير في الدخل، على خلاف ما تقول به النظرية الشائعة عن تقيد الصناعة بمدى السوق.
كان التقدم كبيراً في مجال التصنيع البديل للواردات–أو الاستثمار البديل للتصدير كما يبدو من وحهة نظر الدول المتقدمة. مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفرت الصناعة المصرية كل الاستهلاك المحلي من السكر، والكحول، والملح، والسجائر. 90% من الأحذية والأسمنت والصابون؛ 80% من الأثاث والثقاب ؛ 40% من المنسوجات.
كانت مصر مكتفية ذاتياً إلى حد كبير في معظم السلع الاستهلاكية، حتى قبل نشوب الحرب العالمية الثانية التي أعطت دفعة كبيرة للصناعة المحلية.
القومية، والاستعمار، والرأسمالية 1919-1936
استند نمو الصناعة بشكل كبير على صعود الحركة القومية. ونادى القوميون بتأسيس صناعةٍ مصرية لتقليص الإعتماد على أوروبا. قوطعت البنوك والمتاجر والمنتجات الإنجليزية بشكل منظم، في أوائل عشرينيات القرن الماضي أثناء فترة الأزمة الأنجلو-مصرية [20]. وزاد ضغط القوميون على الحكومة من أجل دعم الصناعة. ورغم اندحار الوفد (الذي كان آنذاك حزباً قومياً) أمام القصر والبريطانيين، عدلت الحكومة عن خطها السابق وبدأت في دعم الصناعة. عام 1925، أُلغيت ضريبة الإنتاج على المنسوجات المنتجة محلياً، والبالغة 8%. وفي أوائل الثلاثينيات، ومع سيطرة مصر على سياسة التعريفة الجمركية، طرأ ارتفاعاً حاداً في الرسوم الجمركية على السلع المصنعة. في عام 1926، عندما كان بنك مصر يعاني من نقصٍ في الأموال ويواجه خطر الإنهيار، عهد إليه البرلمان بالودائع العامة.
مع اندلاع الحرب العالمية الثانية، وفرت الصناعة المصرية كل الاستهلاك المحلي من السكر، والكحول، والملح، والسجائر. 90% من الأحذية والأسمنت والصابون؛ 80% من الأثاث والثقاب ؛ 40% من المنسوجات
لقد شكلت مساعدات الدولة عاملاً معتبراً في تحديد وتيرة تراكم الرأسمال المحلي بلا جدال؛ ومع ذلك، فلا يمكن القطع بأنها كانت العنصر الضروري. عادةً ما يقال إن الحواحز الجمركية لازمة للتصنيع الأولي. ومع هذا، فقد نشأت بعض الصناعات في مصر قبل فرض الحماية الجمركية. كان العنصر الجوهري يتجسد في صعود الرأسمال المالي، المستعد للاستثمار في المشاريع المربحة في أي قطاعٍ من قطاعات الاقتصاد المحلي.
شكّل بنك مصر إحدى المؤسسات الرئيسية التي ساهمت في تنظيم نهضة الصناعة المصرية. تأسس البنك في العام 1920 على أكتاف قوميين مصريين ("مصر" هو الاسم العربي لمصر). وبحلول عام 1925، كان البنك يحتوي على ودائع تبلغ 3190 ألف فرنك، جاء جلها من الملاك. وعلاوة على ذلك، كان كبار الملاك هم أنفسهم المستثمرون الرئيسيون في الصناعات التي أنشأها البنك [21]. أُنشيء بنك مصر خصيصاً لتعزيز الصناعة المحلية. في البداية، قام بتكوين الشركات دون كبير إهتمام بالربحية، إلى حد أنه كان يعاني، في بعض الأحيان، من نقص الأموال. عن طريق هذه الشركات، وبينها واحدة من أكبر مصانع النسيج والمطابع ومصانع الأزرار ومصانع غزل الكتان في العالم، سيطر بنك مصر على الاقتصاد المصري بأكمله، إلى أن تم تأميمه في عام 1960.
في أغلب الأحيان، تجادل الكتابات الماركسية المتعلقة بالعالم الثالث بأن التنمية الاقتصادية، وخاصة التصنيع، سوف تقودها "البرجوازية الوطنية". ويقال إن هذه الطبقة تتكون من صغار الرأسماليين الذين يعملون على تطوير الصناعة، والذين تتعارض مصالحهم مع الإمبريالية. وهي طبقة تتميز عن "البرجوازية الكومبرادورية"، أو البرجوازية الكبيرة القائمة على التجارة والمرتبطة بالرأسمال الأجنبي والرجعية برابطة لا تنفصم [22]. وفي السياق المصري، لا معنى مطلقا لهذا التمييز.
انخرط أكثر المصريين ثراء في مجموعة مصر، وبالتالي فقد كانوا منخرطين في تعزيز التصنيع، كانت الطبقة المسماة بالبرجوازية الكومبرادورية تعمل بنشاط على تطوير الصناعة. وفضلاً عن ذلك، سعى الجناح الصناعي للبرجوازية إلى التعاون مع الإمبرياليين البريطانيين والشركات الأجنبية. لم يكن التحالف مع الجماهير الشعبية ضد الإمبريالية على قائمة اهتمام الرأسماليون "التقدميون" اقتصادياً.
لقد كانت الطبقة الحاكمة في مصر منقسمة بالفعل، إلا أن انقسامها لم يكن على شاكلة خط "الوطني" مقابل خط "الكومبرادوري". قسمٌ واحد فحسب من الطبقة السائدة كان يتوافق مع الانتقال صوب العلائق الرأسمالية. كانت جذور هذا القسم تمتد إلى الملاك أو التجار الذين كانوا ينتقلون إلى الصناعة أو إلى السيطرة الرأسمالية على الإنتاج الزراعي. أما القسم الآخر من الطبقة الحاكمة المصرية فقد كان متجذراً في التجارة وملكية الأرض. كان هذا القسم هو الذي أنفق مدخراته في شراء الأرض، مما أثار امتعاض البرجوازية الصناعية التي شجبت المضاربة في الأراضي الريفية والحضرية. ورغم اندحاره الكبير في الاقتصاد، ظل هذا القسم محتفظاً بالسلطة السياسية حتى عام 1952. كانت زمرة القصر (التي احتفظت بالسيطرة على إدارة الدولة حتى أثناء الفترات القصيرة من حكم الوفد) تخضع علانية لملاكي الأراضي الكبار، ولكن، حتى الوفد عارض ضريبة الأراضي التصاعدية أو الإصلاح الزراعي. اقتصرت العضوية في مجلس الشيوخ على أولئك الذين يمتلكون أكثر من 150 فدانا. وكان في طوع أصحاب العقارات، عن طريق هذه السلطة السياسية، الحصول على دعم كبير من الدولة. على سبيل المثال، جرى إنشاء بنك الائتمان الزراعي عام 1931 بمساعدة الدولة بمبلغ 12.6 مليون جنيه مصري على شكل قروض قصيرة الأجل قائمة في عام 1951 للبذور والأسمدة ونفقات الزراعة. كانت الدولة تقدم كذلك قدراً كبيراً من الدعم للصناعة، وهو ما يبرز الوحدة بين قسمي الطبقة الحاكمة. شكّل جناحي الطبقة الحاكمة لا فئتين متعاديتين في الجوهر، وإنما لحظتين مختلفتين في عملية تبلور الطبقة الرأسمالية. وعلى حين أنه قد بالغ في تقدير وحدة الفئتين، كان سمير أمين محقا عندما كتب في "مصر الناصرية" L'Egypte nasserienne يقول أنه لا يمكن تمييز البرجوازية المصرية، بأي حال من الأحوال، عن البيروقراطية. حصلت [مجموعة مصر] نتيجة لنجاحها على دعم الطبقة الأرستقراطية المالكة للأراضي، التي بدأت مُذاك في "برجزة" نفسها.
أحكمت بريطانيا قبضتها الاستعمارية على مصر حتى عام 1956، رغم المعارضة القومية الراديكالية [23]. بعد سحق ثورة عام 1919، تنازل البريطانيون بالتدريج عن بعض حقوقهم. مكثت القوات البريطانية في مصر حتى عام 1953، بما في ذلك فترة الاحتلال العسكري الرسمي خلال الحرب العالمية الثانية. لقد انسحبوا فقط للعودة ثانية عبر العدوان الثلاثي لبريطانيا وفرنسا وإسرائيل. وطبقاً للنظرية الراديكالية، كان يتعين على هذا الاحتلال الاستعماري أن يعمل على قمع الصناعة المحلية لصالح المستوردين من البلد الأم. لكن شيئاً من هذا لم يحدث: فقد ساهمت الشركات البريطانية بنشاط في تنمية الصناعة المصرية. لقد عملت السيطرة الاستعمارية البريطانية لا على تعويق التصنيع المصري، وإنما على تطويعه كلياً لمصلحة إنجلترا. أرادت الحكومة البريطانية أن تضمن للشركات البريطانية دوراً محورياً في الصناعات الجديدة. تقود هذه السياسة إلى تشجيع الحلفاء المحليين لبريطانيا، الملاك، على التحول إلى رأسماليين، وهي عملية بطيئة. وبالمثل، حرصت حكومات القوى المتقدمة الأخرى على مساعدة الشركات من بلدانها. نافحت الحكومة الأميركية عن حقوق مصر السياسية، كما أيدت إصلاح الأراضي؛ القضية الأولى كانت تعني الحد من الإمتياز البريطاني؛ القضية الثانية كان من شأنها أن تنسف سلطة الملاك، وتحفز بالتالي من سرعة التصنيع، تمهيداً لانتقال السلطة إلى الصناعيين الذين كانوا على صداقةٍ غير وثيقة مع البريطانيين. رد القوميون المحليون، ومن بينهم الضباط الأحرار، بالتقرب من الولايات المتحدة.
لقد كانت الطبقة الحاكمة في مصر منقسمة بالفعل، إلا أن انقسامها لم يكن على شاكلة خط "الوطني" مقابل خط "الكومبرادوري"
لا توفر تجربة مصر أي سند للفرضية الراديكالية الدارجة، القائلة بأن التنمية الإقتصادية تعتمد على تخطيط الدولة أو على نجاح الحركات القومية المتشددة. وهي نقطة سنعود إليها فيما يلي ذكره.
الزراعة تصبح رأسمالية 1919-1970
لم يكن نمو الصناعة سوى أحد الأشكال التي ارتداها تغلغل الرأسمالية في مصر. يركز هذا القسم من الدراسة على الشكل الآخر، نمو الزراعة الرأسمالية، مع التركيز على تمايزها عن الزراعة المنتجة للسلع غير الرأسمالية التي كانت أكثر أهمية عند مطلع القرن. لا يجوز القول إن الرأسمالية قد غيّرت مصر بالكامل ما دامت لم تهيمن على الريف بعد، نظراً لأن معظم المصريين يتركزون في الريف. الأطروحة الأولى في هذا البند، تتلخص في أن الرأسمالية الزراعية تكونت في مصر بالتزامن تقريباً مع بزوغ الصناعة، وبلغت ذروتها مع إصلاح الأراضي في أوائل الخمسينيات. وهي تكشف عن عدم دقة النظرية التي تذهب إلى أن الزراعة المصرية تقليدية، أو ذات طابع "إقطاعي_جديد". لقد كانت مصر بأسرها، ريفاً وحضراً، رأسمالية بحلول أواخر الخمسينيات. الأطروحة الثانية هي أن الدافع وراء الإصلاح وما نجم عنه من آثار، كان تشجيع تطور الرأسمالية. لم يكن المقصود من الإصلاح الزراعي أن يكون، وهو لم يكن قَطّ، خطوة في اتجاه الاشتراكية الريفية. من الحق أن تطور الرأسمالية في الزراعة لم يكن نتيجة مباشرة لتدويل الرأسمال، إلا أن الرأسماليين الأجانب والقوى الأجنبية قد دعموا الإصلاح بلا ريب، وكان لهم دوراً هاماً في انتصار الضباط الأحرار الذين كرسوا أنفسهم للإصلاح.
كان تطور الزراعة المصرية عاملاً مهماً لاستمرار النمو الصناعي. أعاق نظام استعباد الديون التنمية الصناعية بعدة طرق. فقد حدّ من توافر العمال من الريف. قام الملاكين بإنفاق الدخل في الاستهلاك وشراء الأراضي، على حين كان من الممكن الانتفاع به في الاستثمار. إن الأموال التي تنفق على شراء الأراضي تزيد من أسعار الأراضي فحسب، ولكنها لا تزيد الرأسمال الإنتاجي. إن الكتاب السنوي الصادر عن الإتحاد المصري للصناعة في أواخر الأربعينيات يكتظ بهجماتٍ شديدة على عملية ضخ الأموال في شراء الأراضي بدلاً من استخدامها في التوسع الصناعي. يبدو الكتاب السنوي لعام 1952 مفعما بالحماسة تجاه إصلاح الأراضي: "يمكن أن يكون إصلاح الأراضي أحد أفضل الوعود لمستقبل صناعتنا". وعبّر وزير المالية عبد الجليل العمري عن رأيٍ مماثل (ذكره نجيب في كتابه "مصير مصر"). وشرح كيف أضعف الإصلاح من الرغبة في الاستثمار في الأراضي في منتصف الخمسينيات، وكيف شجع، بالتالي، تراكم الرأسمال في الصناعة:
" يعاني الاقتصاد المصري حتى الآن من عقبةٍ حالت دون تطوره، وهي ميل الأثرياء إلى استثمار رؤوس أموالهم في الأراضي الزراعية… هذا الشكل من الاستثمار لم يخلق الثروة؛ بل كان مجرد تركيزا للثروة الموجودة بالفعل. وهكذا، أصبحت الأراضي الزراعية المصرية هاوية لا قاع لها، تبتلع الشطر الأكبر من رأسمالنا… يتمثل الهدف الرئيسي من مشروع الإصلاح الزراعي في توجيه الاستثمارات الرأسمالية الجديدة نحو استصلاح الأراضي وإلى المؤسسات التجارية والصناعية".
كانت القيادة السياسية تعي بوضوح أهمية الإصلاح الزراعي بالنسبة للنمو الصناعي. كتب محمد نجيب، أول رئيس لحكومة الضباط الأحرار(الذي أطيح به لتباطؤه في إصلاح الأراضي):
"إن الهدف الأساسي والجوهري للإصلاح هو فرض التحول من العقارات إلى الصناعة. المصريون مهووسين بالأرض. ينبغي لجم هذا الهوس. يجدر برؤوس أموالهم المتراكمة أن تغذي القطاع الصناعي".
ونظرا لأن إصلاح الأراضي كان بمثابة حافزاً للصناعة، فقد لاقى أكبر التشجيع من المستشارين الغربيين. يؤكد وارينر أن أحد الأسباب الرئيسية للإصلاح هو أن "الإصلاح الزراعي كان لا يزال غير محمي دوليا إلى حد بعيد". قيل إن دعوة أمريكا لإصلاح الأراضي هي ضوءٌ أخضر، ومما لا يقبل الجدل أن نفوذ وزارة الخارجية قد لعب دوراً في إعداد المرسوم [24]. جزءٌ من سببِ دعم الولايات المتحدة لإصلاح الأراضي، كان الرغبة في الحلول محل الإمبريالية البريطانية الآفلة. عبر دعمها الإصلاح، ساعدت الولايات المتحدة في توطيد القسم الصناعي من الطبقة الحاكمة، الذي كانت يتطلع بالفعل إلى الولايات المتحدة للحصول على الدعم. وفضلاً عن الدافع الاقتصادي لتحرير الرأسمال من أجل الاستثمار الصناعي، كان الهدف من الإصلاح الزراعي هو تعزيز قوة الصناعيين من خلال نسف سلطة الملاك وقمع احتجاج الفلاحين.
خلال العقود التي سبقت الإصلاح الزراعي عام 1952، كان هناك تطور كبير في اتجاه العلائق الرأسمالية في الريف. فبينما كان المنتجون المباشرون يفقدون السيطرة على وسائل الإنتاج وعلى عملية الإنتاج، تبلورت طبقة مالكة للأدوات والمنتج تدير العملية الانتاجية. يبين تعداد السكان لعام 1947 أن العمال يشكلون على الأرجح ثلث السكان في الريف. بالإضافة إلى خُمسٍ آخر، وهم المزارعون في الأراضي المستأجرة، كانوا بسبيلهم لأن يصبحوا عمالاً أجراء. وسواء كانت الأرض ضمن عزبة أو مؤجرة نقداً، لم يكن للمستأجر أقل سيطرة على محصول القطن. كان وكيل المالك هو الذي يعين المواقيت لكل العمليات، وهو الذي يوفر المعدات، ويوجه الشغيلة أثناء تقلب الإنتاج. إن البيانات التي يُستشهد بها في الغالب عن حيازات الأراضي، تُخفي التطور صوب الإنتاج الرأسمالي. تتسم البيانات المتصلة بحيازات الأراضي بالتضليل لجملة من الأسباب. أولاً، كان يجوز للفرد أن يتملك الأرض في عدة قرى؛ إلا أن كل قطعة أرض في قرية بعينها كانت تُحسب كملكية مستقلة. ثانياً، قُسّمت العديد من المزارع إلى حيازاتٍ أصغر جرى تأجيرها كل على حدة. عدد من هذه الحيازات الصغيرة كانت مملوكة لأصحاب العقارات الغائبين كصغار التجار من أهل المدن. كان المستأجرون في هذه الأراضي عبارة عن مزارعين يديرون عمليات واسعة النطاق على مساحة تزيد عن 20 فدان. ارتكزت تلك المزارع على العمل المأجور. لكن لسوء الطالع، فإن البيانات الوحيدة المتاحة عن حجم المزرعة تعود إلى عام 1957، أي بعد الموجة الأولى من الإصلاح الزراعي. ومع ذلك، فهذه البيانات تعرض صورة مذهلة للتركيز: ما يزيد عن نصف الأرض كان يتكون من 4% من المزارع التي تزيد مساحتها عن 20 فدان.
شكل الإصلاح الزراعي المعلن في عام 1952، الضربة القاضية لعلائق ما قبل الرأسمالية في الزراعة. من إجمالي المساحة المنزرعة البالغة 6 ملايين فدان، بِيِع 145000 فدان، بخصمٍ هائل، في قِطعٍ تقل مساحة القطعة عن 10 أفدنة من قِبَل الملاكين المتلهفين للحصول على المال بدلاً من السندات الحكومية. (جرى منع البيع بهذه الطريقة في أكتوبر 1953). وأغلب الظن أن الكثير من الـ 160.000 فدان التي كان يملكها الأجانب في عام 1954 قد بيعت بهذه الطريقة. علاوة على ذلك، فقد قامت سلطات الإصلاح بتوزيع 877000 فدان بحلول عام 1966(348000 منها وُزّعت خلال المدة من 1952 إلى 1961).
كان تشكيل التعاونيات يرمي إلى الحفاظ على الإنتاجية، إلا أنها لعبت دوراً في خلق نواة لبرجوازية الدولة الرأسمالية في الريف
قاد تفكك العقارات المملوكة للغائبين إلى بروز شكلين لملكية الأرض. أما الشكل الأول فكانت مزارع شبه رأسمالية يملكها المغتربون الأغنياء. وكانت هذه المزارع، التي تتراوح مساحتها من 10 إلى 20 فدان، تعمل بواسطة عمالة عائلية تُدَعم بعددٍ محدود من العمال الدائمين والكثير من العمال الموسميين خلال مواسم الذروة. أما الشكل الآخر لتملك الأرض، والذي شجع عليه الإصلاح، فتمثل في التعاونيات التي تديرها الدولة. خضعت الأراضي الموزعة بمقتضى الإصلاح للتنظيم في تعاونيات، كانت العضوية فيها إلزامية، وكانت تخضع لرقابةٍ مشددة من قبل الدولة. وأُجبر الشاغلين الجدد للعقارات المصادرة على الانضمام إلى التعاونية "المحلية"، العاملة داخل حدود القرية التي تضم الحيازات. كما أجبروا على التوقيع على تعهدٍ بالموافقة على شراء جميع المستلزمات الضرورية (بذور، أسمدة، مبيدات حشرية، إلخ)، وتصريف كامل منتجاتهم، من خلال القنوات التعاونيةة[25]. كانت إدارة التعاونيات نظرياً من شأن مجالس منتخبة، لكن السلطة الفعلية كانت بيد المشرف، الذي مارس سيطرة مطلقة تقريباً على عملية إنتاج القطن. كان يقرر متى تُحرث الأرض ومتى تُروى وتُرش؛ لم يكن يُسمح للفلاحين بدخول الحقول للحصاد إلا بإذنٍ منه (خوفاً من سرقة المحصول)؛ كان يبيع القطن، فيحصل الفلاحين على القليل، إن وجد، من المستحقات، بعد اقتطاع الضرائب وسداد الديون، وثمن البذور والأسمدة، وما إلى ذلك. فقد الفلاحون السيطرة على وسائل الإنتاج، وعلى المنتَج، وعلى عملية الإنتاج . لقد صاروا، من حيث الجوهر، بروليتاريا زراعية.
وبينما كان تشكيل التعاونيات يرمي إلى الحفاظ على الإنتاجية، إلا أنها لعبت دوراً في خلق نواة لبرجوازية الدولة الرأسمالية في الريف. عندما صدر مرسوم الإصلاح، ساد القلق من أن تؤدي تجزئة الأرض قطعاً صغيرة إلى تخفيض الإنتاجية. ومع ذلك، لم توزع الأرض إلا عندما جرى تشكيل التعاونية (مما يعني بطء وتيرة التوزيع). استلم المستفيدون أراضيهم على ثلاث قطع، بما يتوافق مع نظام التناوب كل ثلاث سنوات. ثم دُمجت الحقول التعاونية في كتل كبيرة (مكونة من قطع يملكها عدد عديد من الفلاحين)، كل منها يغطيه نفس المحصول. سهل هذا من السيطرة المركزية التي كان يمارسها موظفو الإصلاح الزراعي- طاقم أغلبه من الأكاديميين المثقفين من أوساط البرجوازية الصغيرة. لم تكن التعاونيات بأي حال من الأحوال اشتراكية بالمعنى الكلاسيكي، بمعنى أنه لم يكن يسيطر فيها العمال على وسائل الإنتاج. فعلى الرغم من ملكيتهم الإسمية للأرض، لم يكن لدى المنتجين المباشرين سيطرة تُذكر على عملية الإنتاج.
لم تكن التعاونيات بأي حال من الأحوال اشتراكية بالمعنى الكلاسيكي، بمعنى أنه لم يكن يسيطر فيها العمال على وسائل الإنتاج. فعلى الرغم من ملكيتهم الإسمية للأرض، لم يكن لدى المنتجين المباشرين سيطرة تُذكر على عملية الإنتاج
تنامى نفوذ الدولة على سائر الزراعة منذ أواخر الخمسينيات فصاعدا. في أوائل ستينيات القرن الماضي، بذلت الحكومة جهداً كبيراً في سياق توسيع نظام التعاونيات الخاضعة للإشراف بحيث يستوعب الأراضي غير الإصلاحية، كما سعت في اتجاه دمج الأراضي داخل كل قرية في عدة كتل كبيرة، يُطلب من كل مالكٍ فيها زراعة نفس المحصول. أثمرت الخطة عن زيادة الإنتاج حيثما جرى تطبيقها [26]، وقد طُبّقت ضمن نطاق محدود بسبب المعارضة المستعرة من جانب ملاك الأراضي الصغار، الذين اضطروا للاستدانة لشراء الغذاء أثناء الأعوام التي كانت فيها أراضيهم تُدرج ضمن كتلة مُلزمة بإنتاج القطن. تمثلت الطريقة الأنجع التي سيطرت بها الحكومة على الزراعة في التوسع المستمر لنظام التسليمات الإلزامية. بدأ هذا النظام في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي مع التسليم الإلزامي للقمح. أما تسويق القطن من خلال التعاونيات، الذي بدأ في العام 1953، فقد أصبح إلزامياً بالنسبة لكل إنتاج القطن في عام 1965. ثم اتسع النظام بعد ذلك بوقت قصير ليشمل محاصيل أخرى. لم يكن من المستغرب أن يكون سعر التسليمات الإجبارية أقل بنسبة 20-50% من سعر السوق الحرة. إلى جانب كونه نظاماً فعالاً للضرائب، فقد أدى التسويق الحكومي إلى تنامي سيطرة الدولة على القطاع الزراعي، حيث بات في وسع الدولة أن تؤثر بقوةٍ على إنتاج كل محصول من خلال تغيير سعر التسليم الإجباري. وفي عبارةٍ موجزة، كان للدولة الكلمة العليا في تحديد خلطة الإنتاج على 85% من الأرض، بينما كانت تسيطر سيطرة مباشرة على 15% منها. وفيما يلي من الدراسة، سوف نختلف مع الادعاء القائل بأن سلطة الدولة كانت اشتراكية، حيث تظهر الدولة الناصرية كدولةٍ محكومة بواسطةٍ نخبة محدودة، أي أنها ليست دولة عمالية.
شخصية المجتمع المصري في أواخر الخمسينيات
أظهرت الأقسام السابقة أن الرأسمالية نمت في مصر خلال العقود التي سبقت العام 1956. وسيقدم هذا القسم بعض الشواهد الإحصائية حول التركيب الطبقي في مصر في أواخر الخمسينيات. الأطروحة المركزية تفيد بأن الرأسمالية كانت مهيمنة كلياً في مصر خلال ذلك العهد.
نختلف مع الادعاء القائل بأن سلطة الدولة كانت اشتراكية، حيث تظهر الدولة الناصرية كدولةٍ محكومة بواسطةٍ نخبة محدودة، أي أنها ليست دولة عمالية
جادل الراديكاليون المصريون البارزون، لاسيما سمير أمين وعادل حسين، بأن السواد الأعظم من المصريين في أواخر الخمسينيات كانوا من المهمشين والعاملين غير المنتظمين بالإقتصاد، أو ما يسميانه "الجماهير البروليتارية". يستنتج حسين، الذي كثيراً ما يقتبس من بيانات أمين، بصريح العبارة أن تطور الرأسمالية في مصر كان محدوداً بحلول عام 1957. وهو يُرجع مستوى التطور المنخفض المزعوم إلى تأثير الرأسمال الأجنبي. وعلى العكس من أمين وحسين، يوضح هذا القسم أن مصر قد عرفت تطوراً رأسمالياً كبيراً. لقد اضمحلت أشكال الإنتاج ما قبل الرأسمالية بالتلازم مع نمو الصناعة والزراعة الرأسمالية.
يعاني عرض أمين من مجموعة من المثالب المنهجية، لنذكر الأكثر أهمية منها: إنه يفترض أن جميع سكان الريف كانوا يعملون في الزراعة، على عكس ما تشير إليه البيانات المستفيضة. ونظراً لأنه عد "الفلاحين المعدمين" مقولة فائتة، فقد قاده هذا الخطأ إلى المبالغة في عدد الأشخاص الذين لا يملكون أرضاً. علاوة على ذلك، فقد نظر إلى المعدمين على أنهم كتلة متجانسة، على الرغم من أن البعض منهم كان يعمل عملاً منتظما نظير أجر، على حين كان بعضهم مستأجرين، فيما كان البعض الآخر عمالاً مؤقتين. وثمة خطأ مماثل وقع فيه فيما يتعلق بالعاطلين عن العمل في المناطق الحضرية: فقد قلص من أعداد القوى العاملة من السكان البالغين في المناطق الحضرية، فيما صُنفت البقية على أنها "جماهير بروليتارية". بقي أن نلتفت في عجالة لمسألة أفراد الأسرة، وهي مسألة مربكة، ليس فقط فيما يتعلق بالعائلات الحضرية (حيث لا تعمل الزوجات عموماً مقابل أجر)، ولكن أيضاً فيما يتصل بالعائلات الريفية (حيث يعمل العديد من الأقارب، كالإخوة الأصغر سناً والأصهار والزوجات، بدون أجر عند ربّ الأسرة).
تأسيساً على الافتراضات التي توفر تحيزاً تصاعدياً لعدد "الجماهير البروليتارية" وتحيزاً تنازليا لعدد البروليتاريين وأشباه البروليتاريين، يستطيع المرء أن يجري تقديراً تقريبياً للتكوين الطبقي في مصر في أواخر الخمسينيات [27]، تختلف عن تلك التي رسمها أمين وحسين. كانت البروليتاريا (بالمعنى الدقيق للكلمة) قوة اجتماعية كبيرة في مصر، كانت تمثل 30% من السكان على أقل تقدير. أما البروليتاريا (بشكل عام) فكانت تمثل 50% من السكان (7 ملايين)، ليصبح المجموع 80%. هذه المجموعة الأوسع تضم ثلاث شرائح اجتماعية أُقصيتْ خارج نطاق البروليتاريا المحددة. فأولاً، هناك 3.5 مليون عامل ريفي مؤقت. يزعم أغلب الاقتصاديين (باستثناء هانسن) بأن هناك بطالة مقنعة في الزراعة المصرية. لكن هذا الاستنتاج يغض نظره عن الطبيعة الموسمية للغاية لأنماط العمل في الزراعة [28]. تلك العمالة المؤقتة، بمقتضى نظام التراحيل، كانت تعمل لحساب مقاول في مشاريع الأشغال العامة لمدة 4-8 أسابيع متتالية، لأربع مرات في السنة عادة، بالإضافة إلى ثلاثة أشهر في الزراعة، أي ما مجموعه سبعة أشهر من العمل المكثف في السنة. ثانياً، كان 2.5 مليون مزارع يملكون أقل من 5 أفدنة. ثالثاً، مليون من الجماهير المهمشة في المدن كانت تعتاش على دخل الأجور. وعليه، ينبغي إدراج هاتين المجموعتين ضمن نطاق البروليتاريا. لقد كانت البروليتاريا أكبر طبقة اجتماعية دون أدنى شك.
بالتأكيد، لقد تغيرت مصر كثيراً منذ أيام اقتصاد القطن. إن الخط البياني لقيمة صادرات القطن المصري مثير للغاية حقيقةً (انظر كلاوسون، تدويل الرأسمال في الشرق الأوسط). من عام 1880 إلى أوائل العشرينات من القرن الماضي، كان الاتجاه في ارتفاع مستمر. منذ عشرينيات القرن الماضي، انخفض الاتجاه، لا سيما خلال الخمسة عشر عاما من الكساد والحرب (1930-1945) حيث شهد انخفاضا حاداً. ربما لا يخلو هذا من التبسيط، غير أنه بالتأكيد يعزز الفرضية الأساسية للمقال الحالي، وهي أن التنمية الاقتصادية في مصر منذ تغلغل الرأسمالية الأوروبية قد مرَّت بمرحلتين متميزتين. خلال المرحلة الثانية، وهي مرحلة التطور الرأسمالي الشامل، شهدت صادرات القطن ركوداً بينما ارتفع الإنتاج الصناعي ثلاثة أضعاف من أوائل الثلاثينيات إلى أواخر الخمسينيات (وستة أضعاف بحلول أواخر السبعينيات). ويتعذر التوفيق بين هذا التقرير وبين النظرية الراديكالية القائلة بأن الرأسمال الأجنبي يعيق التنمية الصناعية، خاصة وأن الرأسمال الأجنبي كان المؤسس الرئيسي للصناعة المصرية.
رأسمالية الدولة في مصر إبان عهد عبد الناصر
بخلاف الزعم القائل أن فترة عبد الناصر تمثل انتقالاً اشتراكياً وانعطافاً عن الطريق الرأسمالي السابق، سوف نجادل في البندين التاليين بأن مصر إبّان عهد عبد الناصر قد واصلت، من حيث الأساس، نفس نمط التنمية السابق: التصنيع الرأسمالي. وبقصد إقامة البرهان على أن الاقتصاد المصري خلال الستينات كان من نمط رأسمالية الدولة، سوف يوضح البند الحالي أن الدولة كانت تتملك وسائل الإنتاج الرئيسية، وتسيطر بقوةٍ على الباقي، وأن الاقتصاد كان رأسمالياً. وتختلف النقطة الأولى مع الفكرة القائلة بأن الدولة كانت تنوب عن الرأسماليين الذين كانوا مسيطرين في حقيقة الأمر. أما النقطة الثانية، فتختلف مع النظرية القائلة بأن مصر كانت اشتراكية. وما أن نقيم البرهان على الطبيعة الرأسمالية المستمرة للاقتصاد المصري، حتى يصير في وسعنا الانتقال (في البند التالي) إلى طبيعة علائقه بالاقتصاد العالمي.
في بدايته، أبدى نظام عبد الناصر تعاطفاً كبيراً تجاه المشروعات الخاصة، بيد أنه أخذ يتحول، شيئاً فشيئاً، نحو تكريس رأسمالية الدولة، منذ منتصف الخمسينات فصاعداً. وشهد العام 1956-1957 انقلاباً دراماتيكياً فيما يتعلق بتدخل الدولة في الاقتصاد. فعن طريق تشجيع تراكم الرأسمال الخاص من خلال البنية التحتية وعبر القروض، سعت الدولة للسيطرة على الإستثمار بصورةٍ تامة، وعلى الإنتاج بصورةٍ كبيرة. شهدت السنوات الأولى من ثورة يوليو، إقبال الحكومة على زيادة قروض الصناعة، من خلال البنك الصناعي الخاضع للدولة (قروض بقيمة 2 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 1958، وبقيمة 4.2 مليون جنيه إسترليني بحلول عام 1960). علاوة على ذلك، كان هناك انفاقاً كبيراً على البنية التحتية، جاء معظمه من خلال المجلس الدائم لتنمية الإنتاج الوطني. كان هذا بعد أحداث 1955- 1956(دور عبد الناصر البارز في باندونغ، الغارة الإسرائيلية على غزة، الاتفاقية الفاشلة مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبنك الدولي للإنشاء والتعمير المتعلقة بتمويل السد العالي، صفقة الأسلحة التشيكية، تأميم القناة، العدوان الثلاثي.). لقد أكدت الدولة سيطرتها على الاستثمار، اقتناعاً منها بأن الرأسمال الخاص، ولا سيما الرأسمال الأجنبي، يعيق النمو. تلك الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لم تكن تطبيقاً لخطة دُرست بعناية ورويّة بهدف تعزيز سلطة الدولة على الاقتصاد.
وما أن تَقرر سياسياً أنه يتعين على الدولة توجيه الاستثمار باتجاه تسريع وتيرة مراكمة الرأسمال، حتى تحركت عجلات البيروقراطية بأقصى سرعة. تشكلت لجنة وطنية للتخطيط، وقامت بالإشراف على اختيار المشاريع لخطةٍ صناعية أفادت كثيراً من المقترحات التي تقدم بها المجلس الدائم لتنمية الإنتاج الوطني، المنحلّ آنذاك. ارتفعت مساهمة الحكومة في الاستثمار إلى 30-40%. خضع الاستثمار الخاص للتنظيم الصارم في سياق توجيه الاستثمار نحو الصناعة. وحوصرت المضاربة على العقارات (وهو نشاط رئيسي منذ إصلاح الأراضي) عبر تنظيم الإيجارات واشتراط تصاريح للمباني الجديدة. وتشكلت لجانٌ مختلطة من رواد الأعمال والمسؤولين الحكوميين لبلورة الخطط التفصيلية؛ واُستقدم خبراء ممتازين من الأجانب، وفي خريف عام 1959 صدرت الخطة الأولى.
اتسمت الخطة، التي صمَّت آذانها عن نصيحة الخبراء ورجال الأعمال، بالسخافة الكاملة. في كتابه "تمويل الاستثمارات 'Le financement des investissements'، يشير سمير أمين إلى الفرضيات الخيالية اللازمة "لإنتاج" التمويل الكافي للنفقات الهائلة المتوقعة. انطوت الخطة على افتراض ضمني أن مدخرات الأُسر سوف ترتفع من 45 مليون جنيه إسترليني في عام 1958 إلى 81 مليون جنيه إسترليني سنوياً، وأن تفضيلات السيولة للأسر كانت عالية للغاية إلى حد أن الطلب على الأوراق النقدية سيرتفع 37 مليون جنيه إسترليني خلال فترة الخطة (لا تدفع الأوراق النقدية أي فائدة ولا تحتاج إلى "إعادة السداد"، على عكس السندات الحكومية). افترضت الخطة أن 84% من الزيادة في الاستهلاك خلال فترة الخطة سوف تؤول إلى السلع الصناعية المنتجة في مصر. إن كل انخفاض في هذه النسبة سوف يقتضي المزيد من واردات السلع الزراعية، وهو ما يترتب عليه تفاقم مشكلة الصرف الأجنبي. لقد كانت مشكلة حقيقية. لم يكن هناك سوى مخرج وحيد، بنظر الخطة، لسد الفجوة في ميزان المدفوعات، وهو افتراض أن قروض الصناعة الآتية من دول الكتلة الشرقية تساوي ضعف قروض السد العالي. وفي عبارة موجزة، كانت الخطة مبنية لا على أساسٍ من الواقع الاقتصادي، بل امتثالاً لعزم الحكومة على زيادة معدل النمو الصناعي. كان الدافع الأساسي وراء تدخل الدولة المتزايد في الاقتصاد، هو القناعة المنتشرة في مصر بأن الرأسمال الخاص غير قادر، إن لم يكن غير راغب، في تسريع نمو الإنتاج.
تنامت سيطرة الدولة بالتدريج بعد عام 1956، لاسيما في العام 1961 حيث جرت وثبة كبيرة، وذلك حين عزز التأميم المكثف من السيطرة لا على الإنتاج فحسب، بل وعلى الاستثمار كذلك. في عام 1956، تعرضت ممتلكات الرأسماليين البريطانيين والفرنسيين للتأميم دون تعويض: 31 شركة تمتلك 12% من إجمالي الناتج الصناعي و 10% من القوى العاملة الصناعية، خضعت للتنظيم الاقتصادي المنشأ حديثاً في عام 1958. وفُرضت على بنك مصر قيود أكبر فأكبر، بلغت ذروتها مع تأميمه في عام 1960، في وقتٍ كان البنك يسيطر فيه على قرابةِ خمس إجمالي الناتج الصناعي. خلا الطريق لتأميم جميع المؤسسات الصناعية والمالية الكبرى في يوليو 1961، وفي أعقابه صودرت ممتلكات 167 من الأثرياء المصريين في أكتوبر 1961. توسعت هذه القوانين بالتدريج خلال السنوات القليلة التالية، وذلك من خلال التأميم الإضافي، والحجز، وتخفيض التعويضات المدفوعة، وتشديد السيطرة على القليل المتبقي من الشركات الخاصة، وما إلى ذلك.
مع حلول أواخر الستينيات، كان الحكومة قد سيطرت فعلياً على الصناعة المصرية. استولت شركات القطاع العام على ثلاثة أرباع الإنتاج ونصف العمالة، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أخماس العمالة في المصانع التي تضم أكثر من عشرة عمال. كان العمل في القطاع الخاص يجري ضمن مؤسسات "ذات مستويات تكنولوجية وإنتاجية متدنية"، لا سيما في المجالات ذات التكاليف الرأسمالية الخفيضة (الفخار، وصناعة الأحذية، والمنسوجات اليدوية). شكلت الصناعة ملمحاً بارزاً من المشهد المصري، حيث بلغ إجمالي العمالة أكثر من 12%. وفي عام 1970/71 بلغ عدد العمالة الصناعية 1,053 ألف من إجمالي العمالة المبلغ عنها (أي الذكور) والبالغة 8،506 ألف. في عام 1966/1967، من إجمالي العمالة المدنية غير الزراعية البالغة 3769 ألفاً، كان 1035 (27%) منهم يعمل بالقطاع العام [29]. باختصار، هيمنت الدولة على الاقتصاد الحضريّ المصري، حيث امتلكت جميع الشركات والبنوك الكبيرة، فيما نظمت البقية تنظيماً محكماً (أصبحت الواردات، على سبيل المثال، تستلزم ترخيصاً حكومياً بدءا من عام 1964 فصاعدًا). في ضوء المعلومات الواردة أعلاه حول دور الدولة الحاسم في الزراعة، يبدو الدليل على خضوع الاقتصاد للدولة مقنعاً.
مع حلول أواخر الستينيات، كان الحكومة قد سيطرت فعلياً على الصناعة المصرية. استولت شركات القطاع العام على ثلاثة أرباع الإنتاج ونصف العمالة، بما في ذلك ما يقرب من أربعة أخماس العمالة في المصانع التي تضم أكثر من عشرة عمال
يتعيّن علينا حصر السمات التي تميز الرأسمالية عن الإشتراكية، إذا أردنا البرهنة على أن مصر كانت رأسمالية في عهد عبد الناصر. سنستعين بمفهوم الإشتراكية الذي حدده كلاً من ماركس ولينين في كتابيهما "نقد برنامج غوتا" و"الدولة والثورة"، أي بمعنى سيطرة العمال على المجتمع، مع مواصلة استبدال الأجهزة الحكومية والبيروقراطية الخاصة بالجماهير المنظمة، واستبدال الأسواق والتفاوت الإقتصادي بالتوزيع على أساس الحاجة. تنحصر الخصائص الأساسية للرأسمالية في ثلاث خصائص، هي: أولاً، الإنتاج للسوق عن طريق الوحدات التي تجبرها المنافسة على تعظيم الأرباح؛ ثانياً، مجموعة كبيرة من السكان "الأحرار بصورةٍ مزدوجة"، على حد عبارة ماركس: فهم أحرارٌ في العمل حيث يشاءون، وأحرارٌ من أي وسيلة أخرى لكسب الرزق؛ وثالثاً، السيطرة على وسائل الإنتاج بواسطة مجموعة صغيرة من الشعب [30]. تتوافق تلك الخصائص مع ملكية الدولة لوسائل الإنتاج. توقع إنغلز، في كتابه "ضد دورينغ"، أن تحل ملكية الدولة محل الرأسمال الخاص:
"سيتعين على الممثل الرسمي للمجتمع الرأسمالي - الدولة - في نهاية المطاف أن يتولى توجيه الإنتاج… إن الدولة الحديثة، وبقطع النظر عن شكلها، هي آلة رأسمالية بالأساس، إنها دولة الرأسماليين، التجسيد المثالي للرأسمال الوطني في مجموعه. وكلما أمعنت في السيطرة على القوى المنتجة، كلما أصبحت في الواقع رأسمالياً وطنياً، وكلما استغلت المزيد من المواطنين. ويظل العمال عمالاً بأجر، أي بروليتاريين. إن العلاقة الرأسمالية لم تُلغَ، وإنما انتقلت إلى مرحلةٍ متطورة".
في مصر عبد الناصر، كانت السيطرة على وسائل الإنتاج مُركزة في أيدي حفنة صغيرة من مسؤولي الدولة، وهو ما يمثل أحد المحددات الثلاثة للرأسمالية. تبلورت هذه المجموعة من المهنيين – الضباط العسكريين، والأكاديميين، والفنيين من النظام السابق على عام 1952. أُبيدت البرجوازية القديمة تقريباً من خلال التأميم.
لم يسيطر المنتجون المباشرون لا على السلطة السياسية ولا على الإنتاج. كان الإتحاد الإشتراكي العربي، الحزب الشرعي الأوحد، الذي تأسس عام 1962، منظمة للعمال والفلاحين من الناحية النظرية، أما في الواقع، فقد كان آلية دقيقة لاحتواء المبادرة الجماهيرية، ومراقبة المسؤولين المحليين، ودمج هيكل النظام القديم على مستوى القرية في المجتمع الجديد. على سبيل المثال، تشكلت لجان عمالية في كل مصنع لتحل محل النقابات. لم تكن تلك اللجان خاضعة لسيطرة الجهاز الفني - الإداري فحسب، بل إن الصلاحيات التي حازتها كانت جد قليلة، ونادراً ما كانت تعمل، وإن حدث ففي لحظات الضغط. ومع أن القانون كان قد حدد فترة العضوية بسنتين، إلا أن قيادة النقابات لم تتغير من عام 1964 إلى أوائل السبعينيات. "لا غرو، إذن، أن عدداً من هؤلاء النقابيين المهنيين قد تحولوا إلى قادة بيروقراطيين يسرفون في الإنفاق على المكاتب والمباني والكماليات، بينما يكممون الأفواه أو يقيدون المبادرات المختلفة، المنبثقة من الأسفل". لقد كافأت النخبة نفسها بسخاء: أدنى 43% من الموظفين الحكوميين كانوا يحصلون على رواتب تتراوح بين 84 و 300 جنيه إسترليني سنوياً؛ على حين أن أعلى 0.13% (1035 شخصا) حصلوا على ما يتراوح من 1200 إلى 2000 جنيه إسترليني؛ وبينهما 1.1%(8889 شخصا) حصلوا على 684-1440 جنيه إسترليني. بالإضافة إلى ذلك ، "لا ينبغي قياس الاستهلاك الصافي للبيروقراطيين الأعلى بالقوة الشرائية لرواتبهم وبدلاتهم… فإن "الامتيازات الإدارية" قد تشمل عناصر مثل السيارات والمنازل والخدمات الاجتماعية والرياضية والعطلات ومرافق التسوق [31].
من المغري القول إن البرجوازية الصغيرة الأكاديمية -الثقافية -العسكرية، قد استولت على السلطة الاقتصادية رغبةً منها في إثراء نفسها كأفراد. هذا هو جوهر حجة حسين. ففي إشارة إلى منتصف الستينيات، كتب يقول: "لقد حاولوا (برجوازيو الدولة الرأسمالية) تنظيم الحياة الاقتصادية للبلاد رغبة منهم في إرضاء تعطشهم لكل ما يمكن تحقيقه من المكاسب الشخصية بدلاً من العمل على تعزيز التنمية الاقتصادية التي تمس الحاجة إليها". إذا كان الجشع الشخصي هو ما يدفع بالبرجوازية الصغيرة، فمن المتعذر أن نفسر سر تلاحمهم معاً. كان سيتعين على كل فرد منهم في هذه الحالة أن يسعى إلى التحالفات مع نفرٍ من البرجوازيين الكبار (كما كان الحال بالفعل طوال ثلاثينيات وأربعينيات القرن العشرين). لقد تحولت البرجوازية الصغيرة الجديدة إلى قوة سياسية فاعلة بالإعتماد على الأيديولوجيةْ، وهي أيديولوجية مكنتها من الفوز بدعم كلاً من البروليتاريا والجماهير البروليتارية.
تلك الأيديولوجية كانت قومية من النوع الحديث، تُركز بشدة على التنمية الاقتصادية. إن كتاب فلسفة الثورة الذي وضعه عبد الناصر عام 1953، مضمخ بالقومية السياسية المشددة على إزالة آخر بقايا الاستعمار البريطاني. إن الميثاق الوطني لعام 1962 هو، بالأساس، وثيقة من وثائق القومية الاقتصادية، تحمل العديد من الإشارات إلى "معركة الإنتاج" : "الإنتاج هو المعيار الذي يمكن من خلاله الحكم على ديناميكية العرب". كما ينظر إلى الرأسمالية الخاصة بإعتبارها عاجزة عن تعبئة الموارد الوطنية؛ فلا يمكن تعظيم النمو إلا من خلال "سيطرة الشعب على جميع وسائل الإنتاج وإدارة الفائض وفقاً لخطة صارمة". نظرت البرجوازية الصغيرة إلى التأميم بإعتباره آلية لزيادة وتيرة التنمية - لم تكن أحلام الإثراء الشخصي هي المسيطرة على أذهانهم.
لكن ما أن قبضوا على السلطة، حتى قرر العديد من أفراد النخبة الجديدة أنهم يبتغون الثروة الشخصية وليس الصالح العام. كان معدل النمو الاقتصادي البطيء بعد منتصف الستينيات يعكس تفاقم الفساد وتراجع التفاني في التخطيط الفعال للدولة. خلال عشرين عام، تلاشت الحماسة لمضاعفة دخل الفرد، وحل محلها الرغبة في التَّمتُع بوضعٍ رغيد. بحلول عام 1970، تحول مديرو الشركات الحكومية إلى السوق السوداء والتربح طمعاً في زيادة دخولهم. "إن التواطؤ بين المديرين في القطاع العام – الذين دخل بعضهم في شراكة مُقنّعة مع تجارٍ أو رواد أعمال من القطاع الخاص – وبين مقاولين من الباطن، يُسفر عن خسائر فادحة في المال العام [32]. كانت مساعي برجوازية الدولة في سبيل مصالحها الشخصية تتناسب عكسياً مع التزامها بأيديولوجية رأسمالية الدولة. أدرك السوفييت أن نفوذهم يعتمد على نجاح رأسمالية الدولة، وبذلوا جهدا كبيرًا لتشجيع الإتحاد الإشتراكي العربي، الذي عدّوه لازماً لبثّ أيديولوجية الدولة الرأسمالية، وللتحقق كذلك من استحواذ الأفراد على الثروة (يقوم مسؤولو الحزب بفرض انضباط التراكم على نطاق الدولة). باءت الجهود السوفيتية بالفشل؛ ولم تستطع رأسمالية الدولة أن تمد جذورها الأيديولوجية في مصر.
إن سيطرة النخبة الجديدة على وسائل الإنتاج، تلبي أحد الشروط الثلاثة للرأسمالية. أما الشرط الثاني، أي وجود مجموعة كبيرة من السكان مجبرة على العمل مقابل أجر، فقد وفرته التطورات التي جرت في الريف خلال النصف الأول من هذا القرن، عندما فقد الملايين من المنتجين أراضيهم وتحولوا إلى عمال أجراء وأشباه أجراء. وقد عمل الإصلاح الزراعي على تعزيز هذه العملية، ولم يُسفر عن خلق مجموعة جديدة من المزارعين المستقلين: 342.000 أسرة، تمثل 2 مليون على الأكثر من سكان الريف البالغ عددهم 18 مليون، تسلموا الأرض بحلول عام 1970[33]. عام 1965، كان 1.2 مليون لا غير من أصحاب الأراضي يمثلون ثلث سكان الريف - يمتلكون 5 أفدنة أو أكثر، وهو الحد الأدنى الضروري لإعالة الأسرة. وكما هو موضح أعلاه، كان العديد من الملاك الإسميين للأراضي تحت إمرة الطاقم التعاوني في واقع الأمر. قاد هذا إلى الهجرة صوب المدن بحثاً عن عمل. من بين سكان المدن المقدّر عددهم بـ 13 مليون نسمة في عام 1970، كان هناك أقل من 2 مليون شخص مستقل اقتصادياً، بما في ذلك الباعة المتجولون والحرفيون الصغار. لقد تعيّن على الغالبية العظمى من المصريين أن تعمل مقابل أجر. ولم يكن لهم نصيب من دخل المصانع المملوكة للدولة.
يتقوم الجانب الثالث للرأسمالية في الإنتاج للسوق، عن طريق الوحدات المتنافسة فيما بينها على تعظيم الربح. من الجليّ أن الإنتاج المصري كان موجها للأسواق وليس للإستخدام المباشر. لقد فُرض تعظيم الربح إلى حدٍّ ما على جميع شركات القطاع العام. يجادل أوبراين بأن مديري القطاع العام كانوا يُقيَّمون على أساس الأرباح التي استطاعت مؤسساتهم أن تحققها، وكثيرا ما تعرضوا للفصل من العمل نظرا للأداء الضعيف. ومع ذلك، كانت السوق الدولية هي القوة الحاسمة في فرض تعظيم الربح. يوضح البند التالي أن الاقتصاد المصري في الستينيات كان مقيد جدياً بسبب نقص النقد الأجنبي. كانت هناك طريقتان، فخسب، لكسب النقد الأجنبي، وكلاهما كان يتطلب إنتاجاً مربحاً. الأول هو التصدير، الذي يشترط أن تكون تكاليف الإنتاج في مصر منخفضة إلى حدٍّ كافٍ، حتى يكون مفيداً. والثاني هو الحصول على قروضٍ خارجية، التي تستلزم أن يكون هناك ضماناً للسداد في المستقبل، حتى يمكن توفيرها. العديد من هذه القروض أتت من حكوماتٍ أجنبية وسميت "مساعدات". لم تكن القروض، بما فيها القروض الآتية من الكتلة الشرقية، قروضا جشعة: كانت مكرسة بشكلٍ عام لاستيراد الآلات بغية انتاج مخرجات يمكن تصديرها إلى البلد المُقرض لسداد القرض. تَدبَّر القرض السوفيتي للمرحلة الأولى من سدّ أسوان. اتخذ ناصر مبادرة سياسية كبيرة بقطع المفاوضات مع الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والبنك الدولي والإعلان عن قبول التمويل السوفيتي - بيد أن السوفييت أبقوا ناصر معلقاً لمدة 18 شهر قبل توقيع اتفاقية القرض، لأنهم، على حد عبارة خروشوف، أرادوا التحقق من أن السد سوف يسمح بإنتاج ما يكفي من القطن والأرز لسداد القرض. كان الرأسمال الأجنبي، بما في ذلك المساعدات السوفيتية ، متوفرا بشرط الإنتاج المربح فحسب.
بالنظر إلى استيفاء مصر كل الشروط التي تميز الرأسمالية، وبما أن الدولة كانت تمتلك وسائل الإنتاج الرئيسية، فإن التوصيف المطابق لمصر في عهد عبد الناصر، هو مجتمع الدولة الرأسمالية.
رأسمالية الدولة المصرية والاقتصاد العالمي
تزعم الأسطورة الراديكالية حول التطور "الاشتراكي"، أن الأنظمة القومية، وفي جملتها نظام عبد الناصر، هي وحدها القادرة على إنهاء الإعتماد على البلدان الرأسمالية المتقدمة، ومن ثم، تحقيق معدلات نمو عالية في الصناعة وفي الناتج القومي الإجمالي. سيوضح البند الحالي أن هذه الأسطورة غير دقيقة من جميع وجوهها الرئيسية. لا تحقق الأنظمة القومية بالضرورة معدلات نمو أعلى من تلك الأنظمة الموالية للغرب، كما أنها لا تُطور الصناعة دائماً بسرعة أكبر. إن الإرتباط بالسوق العالمية لا يعني التخلف في النمو والتصنيع بالضرورة. وأخيراً، إن الأنظمة القومية لا تقلص دائماً من الاعتماد على الاقتصادات المتقدمة.
لم يكن النمو الاقتصادي في فترة عبد الناصر سريعاً بصورة لافتة. لا تختلف معدلات النمو إلاّ قليلاً عن تلك التي كانت في الأنظمة السابقة. لا توجد بيانات موثوقة عن الناتج القومي الإجمالي قبل فترة عبد الناصر، بيد أنه ثمة مؤشرات مختلفة للإنتاج. يعد معدل نمو التصنيع مؤشرا مفيدا للنمو في الناتج الكلي. قام مابرو ورضوان بحساب معدل الإنتاج الصناعي فتبيّن أن متوسط معدل النمو السنوي لعام 1945-1952 (قبل عبد الناصر) كان 8.1% ، ولعام 1953-1969 / 70(سنوات حكم عبد الناصر) كان 7.2%.
كان النمو خلال العقد الأول من حكم عبد الناصر (حتى 1963-4) بمعدل 10.3%، إلا أن المعدل انخفض في السنوات الست الأخيرة إلى 2.0%. من عام 1945 إلى عام 1952، ارتفع الناتج القومي الإجمالي، بأسعار 1954، من 732 مليون جنيه إسترليني إلى 1،007 مليون جنيه إسترليني، أو 4.66 في المائة سنوياً. من عام 1952/3 إلى عام 1969/70، ارتفع الناتج القومي الإجمالي، بأسعار 1952/3، من 806 مليون جنيه إسترليني إلى 1700 مليون جنيه إسترليني، أو 4.36% سنوياً. البيانات الأكثر ثراءاً عن فترة ما قبل عام 1939 هي تقديرات رضوان لصافي احتياطي الرأسمال الثابت. ومرة أخرى، لا تظهر فترة عبد الناصر كفترة نمو فائق السرعة. ففي حين أن متوسط معدل النمو السنوي من عام 1952 إلى عام 1967 كان 3.44٪، نجد أن المتوسط من عام 1920 إلى عام 1951 كان 3.33٪ (باستثناء سنوات الحرب، حيث كان المتوسط 4.77٪).
كان نمو الناتج المحلي الإجمالي والناتج الصناعي في عهد عبد الناصر أعلى قليلاً من متوسط معدل النمو السكاني السنوي البالغ 2.4% من عام 1947 إلى عام 1976. تدعي البيانات الرسمية، التي تقلص من حجم التضخم، أن دخل الفرد ارتفع بنسبة 2.13% سنوياً منذ عام 1952/3. ويقدر مابرو الرقم الحقيقي بــ 1.6%. انعكست الزيادة بشكل أكثر أو أقل دقة في كل طبقة اجتماعية. وبخلاف ما تصفه الصورة الراديكالية لنظام عبد الناصر، انخفض الدخل النسبي للعمال إلى حدٍّ ما. كان ما يقارب خُمس السكان يتكون من العمال الريفيين وعوائلهم، وكانت أجورهم الحقيقية في عام 1971 هي نفسها تقريباً كما كانت في عام 1952(بعد أن انخفضت قليلاً في أوائل الخمسينيات من القرن الماضي، وارتفعت حتى منتصف الستينيات، وانخفضت بعد ذلك بقليل). يقدر مابرو أن دخل عمال الصناعة قد ارتفع بنفس المعدل تقريباً لعامة السكان. معظم الزيادة التي حصل عليها العاملون في القطاع الحديث خلال الفترة 1952-1970، كانت في الأعوام من 1962-1964. باختصار، هناك القليل من القرائن على أن أداء الطبقة العاملة المصرية كان أفضل من الناحية الاقتصادية في ظل النظام القومي الراديكالي مما كان عليه الحال في ظل حكومات عدم التدخل السابقة.
كما لا يوجد أي دليل على أن مصر قد أصبحت أكثر اعتماداً على نفسها في ظل نظام عبد الناصر. خطب النظام ببلاغة عن إنهاء التبعية والاستقلال عن الاستعمار الجديد، ولكن الواقع الاقتصادي قال كلمته. بحلول عام 1940، أصبحت مصر مكتفية ذاتياً في معظم السلع الاستهلاكية. أمّنت الصناعة المحلية كل، أو ما يقرب من كل، استهلاك السكر والكحول والأحذية والأسمنت والصابون والأثاث وما إلى ذلك. وبعيداً عن هذه الصناعات، طرأ في عهد عبد الناصر تقدماً طفيفاً تمثل في خطوطِ إنتاجٍية أكثر تطوراً من الناحية التكنولوجية وكثيفة الرأسمال، على غرار التوسع في الصناعة الكيميائية المحلية وإنشاء مجمع حلوان للصلب. كانت نسبة الــ 10.9% الإضافية من القوى العاملة في التصنيع على نطاق واسع ضمن مجموعة المعادن والكيماويات في عام 1967 مقارنة بعام 1952. هذا التغير الذي يقتصر على ما يقل عن 60.000 عامل من أصل 30 مليون نسمة، إنما يشكل، بالكاد، محاولة لإعادة توجيه الاقتصاد نحو الصناعات الثقيلة.
إن توجه الصناعة المستمر نحو السلع الاستهلاكية لم يكن ناتجاً عن سياسة واعية للدولة. لقد دعمت الحكومة تطوير الصناعات الثقيلة والسلع الآلية، إلا أنها لم تحقق نجاحاً تجارياً كبيراً. كانت المنافسة من الصناعة في البلدان المتقدمة في غاية الشدة. توقفت الصناعة المصرية عند نهاية دورة حياة الُمنتَج، حيث كانت تنتج سلعا أصبحت موحدة، عبر عمليات الإنتاج التي لم تشهد تطوراً تكنولوجياً سريعاً. أما البلدان المتقدمة فقد كان يتوفر لديها من دعائم الابتكار الصناعي القوى العاملة ذات الخبرة، والمجتمع العلمي، والرأسمال الاستثماري، والبنية التحتية الصناعية. على الرغم من الجهود المضنية التي بذلتها مصر للحاق بالركب، لم تنل غير الفتات: الصناعات التي انتشرت في العديد من البلدان وشهدت منافسة سعرية حادة، بخلاف المجالات الكثيفة تكنولوجياً فائقة التقدم.
أدت عملية دورة حياة المنتج بمصر إلى الاعتماد على الواردات لتوفير السلع المتطورة تكنولوجياً، بما في ذلك معظم السلع الرأسمالية. لم يكن الاعتماد على الواردات - وبالتالي على عائدات النقد الأجنبي - نتيجة لسياسةٍ حكوميةٍ خاطئة. لقد شجعت حكومة عبد الناصر الإنتاج المحلي بكل الوسائل التي أتيحت لها. إن التصنيع لاستبدال الواردات- أي الإنتاج المحلي للسلع الصناعية (السلع الاستهلاكية عادة) التي سبق استيرادها - ليس سوى استيراد مكثف للغاية في واقع الأمر. من أجل إنتاج سلع مصنّعة بقيمة مضافة تبلغ 252.4 مليون جنيه إسترليني في عام 1967، كانت هناك حاجة إلى 563.5 مليون جنيه إسترليني كمدخلات وسيطة - تضمنّت 188 مليون جنيه إسترليني للواردات (78.8 مليون جنيه إسترليني للسلع الزراعية، 31.2 مليون جنيه إسترليني) للمواد الكيميائية و 19.2 مليون جنيه إسترليني لقطع الغيار). بالاستناد على الجداول الأولية للصناعة البينية لعام 1954 و 1962، خلص مابرو ورضوان إلى أن التكنولوجيا حظيت بكثافة استيراد أكبر في العام الأخير. إن الاستعانة بتقنيةٍ تعود لعام 1954 في عملية الإنتاج عام 1962،كان من شأنه أن يخفض الواردات بنحو 4%.
إن الاعتماد على السلع الرأسمالية المستوردة والمدخلات الصناعية، كان يعني أن النمو المصري مقيداً بندرة النقد الأجنبي. كانت الصادرات المصرية القادرة على المنافسة في الأسواق العالمية بجانب القطن قليلة. وبغض الطرف عن السياسة التي انتهجتها الحكومة، لم يكن التوسع في صادرات القطن بالأمر اليسير: كان ارتفاع الطلب العالمي على القطن محدوداً، وكان القطن قصير التيلة يحل محل القطن طويل التيلة من حيث الشعبية. وفصلاً عن ذلك، كان يتحتّم تحويل الموارد عن قطاع القطن إذا ما أريد للصناعة أن تتطور. والحاصل، ركدت مداخيل الصادرات على حين كان الطلب على الواردات يرتفع.
بنهاية الحرب الكورية، كان لدى مصر احتياطيات كبيرة من النقد الأجنبي: 980 مليون دولار في عام 1952[34]. بالإعتماد هذه الاحتياطيات اعتماداً كبيراً، جرى تمويل التوسع الصناعي في الخمسينيات من القرن الماضي، والذي بلغ ذروة نموه السريع أوائل الستينيات (المدة التي تَلَتْ التأميمات الواسعة). من عام 1952 إلى عام 1958، عانت مصر من عجز في الميزان التجاري التراكمي بلغ 560 مليون دولار، تم تمويله بشكل أساسي عن طريق سحب احتياطيات قدرها 487 مليون دولار. كان هذا العجز يشكل حوالي ربع الاستثمار المحلي الإجمالي، وأكثر من 150% من واردات الآلات. في أوائل الستينيات، اختفت وسادة الاحتياطيات الفائضة، وهو ما قاد، أول الأمر، إلى انخفاضٍ طفيف في قيمة العملة في عام 1962، قبل أن يتسبب في أزمة كبيرة في العام 1965-1966. بالتزامن مع نضوب الاحتياطيات، شهدت المساعدات الأميركية انخفاضاً حاداً من 175 مليون دولار في عام 1964 إلى 55 مليون دولار في عام 1966، ثم إلى صِفرٍ مُذّاك وحتى منتصف السبعينيات. ساعدت الاعتمادات المصرفية قصيرة الأجل على الوفاء بالفواتير العاجلة، بيد أنها لم تكن حلاً حيوياً على المدى الطويل.
كان العلاج الوحيد للعجز في ميزان المدفوعات يتمثل في إبطاء النمو الاقتصادي. لم يكن لخفض قيمة الجنيه المصري أي أثر يُذكر، اللهم إلا أثره في تدهور الميزان التجاري. إن المتغير الحاسم الذي كان يحدد التغيرات في الميزان التجاري، كان معدل النمو. تستلزم الإنتاجية المرتفعة مزيداً من السلع الرأسمالية المستوردة والمدخلات من دون توسيع الصادرات ( لقد أخذ النمو الموارد بعيداً عن قطاع القطن، وبالتالي، قلص من الصادرات). قاوم عبد الناصر بشدة ضرورة خفض معدل النمو. كان يريد الحفاظ على المستوى العالي للاستثمار والاستهلاك. في نهاية المطاف، تم تنفيذ التخفيضات في الإنفاق العام التي أوصى بها صندوق النقد الدولي، برغم الرفض المصري الرسمي لتوصياته، وبرغم أنه لم يُقرض مصر مليماً.
ويجادل هانسن والنشاشيبي بقوة أن الركود في منتصف وأواخر الستينيات لم يكن ناجماً عن مشكلات الصرف الأجنبي وحدها. يقيناً كانت هناك عوامل أخرى مساعدة، مثل ركود الإنتاج الناجم عن انعدام الكفاءة البيروقراطية، ومع هذا، تبقى الحقيقة أن الأزمة قد نشبت، بالضبط، بالتزامن مع نفاد النقد الأجنبي في مصر. وأما ملاحظة إبراهيم القائلة بأن '' جذور الركود في الستينيات تكمن في الاعباء التي خلقتها حرب 1967"، فلا أساس لها على الإطلاق. لقد بدأ الركود قبل الحرب بوقتٍ طويل. وكذلك، كان صافي تكاليف الحرب للحرب أقل بكثير من الإجمالي. لقد عوّضَت المساعدات السوفيتية الكثير من الزيادة في الإنفاق العسكري، على حين أن مساعدات من الدول العربية تقدر بمبلغ 250 مليون دولار قد ساهمت جزئياً في تعويض خسارة سنوية قدرها 300 مليون دولار من عائدات قناة السويس، و 50 مليون دولار من عائدات النفط، و 50 مليون دولار في السياحة [35]. لم يكن الركود الاقتصادي بأي حال من الأحوال ناجماً عن ضيق الأسواق بالنسبة للمنتجين المصريين. نشأت الأزمة الاقتصادية على الرغم من ارتفاع مستويات المعيشة الشعبية والزيادات المفترضة في تعاظم الطلب على السلع الاستهلاكية المنتجَة محلياً على حساب الطلب على السلع الاستهلاكية المستوردة. كانت أسواق الصناعة المصرية تتوسع، على أمل أن يتمكن المنتجون المحليون من تحقيق وفورات الحجم وتقليل تكاليف الإنتاج. ولهذا، فلم يكن ثمة نقصٌ في فرص الاستثمار. لقد نتج الركود في الستينيات عن نقص النقد الأجنبي. كان التوسع في الصناعة المصرية مقيداً بتوافر النقد الأجنبي، حتى أنه ما كان بمقدور العديد من المصانع أن يعمل إلاّ على نحوٍ مُتقطع، وكان ذلك يحدث حين تكون المدخلات أو الأجزاء المطلوبة في متناول اليد. وعلى الرغم من تطلعات عبد الناصر إلى زيادة الاستقلال الاقتصادي، فقد اِضطره نقص النقد الأجنبي إلى الاعتماد على القروض الخارجية لتمويل الواردات اللازمة للنمو. تطلب النمو ربط مصر بالاقتصاد العالمي والاعتماد أكثر على الدول المتقدمة. ليس تدويل الرأسمال بالخيار السياسي الذي يمكن للحكومة أن تختار قبوله أو رفضه؛ إنه ضرورة لأي دولة نامية لا تتبع مساراً اشتراكياً بكل معنى الكلمة. بمجرد أن قررت مصر التصنيع باستخدام التكنولوجيا الرأسمالية الحديثة، أضحى النمو مرهوناً بالعملة الأجنبية. تمثلتْ الخطوة التالية في السعي من أجل الحصول على قروض خارجية - 1.725 مليون دولار من عام 1959 إلى عام 1966 لتغطية عجز ميزان المدفوعات البالغ 1.6 مليار دولار. مُنحت القروض على شرط أن تحقق الصناعة المصرية إنتاجاً مربحاً، والضمان الرئيسي للسداد كان التوسع في الإنتاج الذي أتاحه القرض. وبالتالي، كان على الصناعة المصرية أن تتبنى تعظيم الربح. كانت المحصلة النهائية للإرتباط بالسوق العالمية أنه تعيّن على الصناعة المؤممة أن تعمل بشكل أساسي على المبادئ الرأسمالية، شأنها شأن الصناعة الخاصة التي حلت محلها.
في أواخر عهد عبد الناصر، اعتمدت مصر بشدة على قروض الكتلة السوفيتية. تخطت قروض الكتلة الشرقية أكثر من نصف الـ1628 مليون دولار التي اقترضتها مصر من 1967 إلى 1972. كانت هذه القروض مهمة لسد العجز في النقد الأجنبي البالغ 3746 مليون دولار (2،250 مليون دولار في عجز ميزان المدفوعات و 1،446 مليون دولار في الإطفاء)؛ إلا أنها لم تكن على نفس الدرجة من الأهمية قياساً بمنح 1566 مليون دولار من الدول العربية [35]. أسفر التحول من المصادر الغربية إلى الشرقية عن الاستخدام دون المستوى الأمثل للعديد من المصانع التي كانت الأجزاء والمدخلات الخاصة بها غير متوفرة لدى المصادر الشرقية. ونظراً إلى هذه المشكلات، شَكّل الإنتقال إلى الكتلة الشرقية خسارة اقتصادية كاملة لمصر خلال عددٍ من السنوات، مما كذّب أمل ناصر في تؤدي القروض السوفييتية واسعة النطاق منخفضة التكلفة - لا سيما للصناعات الثقيلة والقطاع العام - إلى حفزِ نمو مصر. كان للتحول من المعسكر الغربي إلى المعسكر الشرق، بطبيعة الحال، دوافع سياسية وعسكرية قوية، مستقلة عن أي مكاسب اقتصادية مأمولة.
لم يسفر الاعتماد على الكتلة السوفيتية عن تغيير قيود الصرف الأجنبي على النمو المصري. كانت القروض السوفيتية- التي سُميت "مساعدات"- متاحة بشروط القروض الغربية نفسها، حتى وإن كانت أسعار الفائدة عليها منخفضة نوعاً ما. تلخصت تلك الشروط في أن تستخدم مصر الأموال لتوسيع الإنتاج، ولا سيما إنتاج المواد الخام والمواد الغذائية للسوق السوفياتي. أقرض اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية المال لسد أسوان، ليس لمجرّد أسباب سياسية: كان القطن والأرز المشحون إلى الاتحاد السوفيتي، على سبيل سداد القرض، يجيء بسعر أرخص من الزيادة المقابلة في الانتاج الآتي من آسيا الوسطى السوفيتية. لم يكن برنامج القروض السوفييتية أكثر إيثاراً من برنامج المستثمرين الغربيين: كلاهما كان يشترط أن يكون الإنتاج المصري مربحًا بدرجة كافية لسداد القرض. أمّا أن القروض السوفيتية تتخذ شكلاً مؤسسياً مختلفاً عن القروض الغربية (من حكومةٍ إلى حكومةٍ، وليس من بنك إلى شركة)، فأمرٌ لا ينطوي أهمية اقتصادية ذات شأن.
ومما لا جدال فيه، أن القلق الناجم عن فشل النظام الناصري في تحقيق أهدافه، كان أحد عومل القطيعة مع رأسمالية الدولة في عهد السادات خلال السبعينيات. شملت العوامل الأخرى التحول من الاتحاد السوفيتي إلى الغرب ورغبة النخبة في إثراء نفسها من خلال تأسيس مشروعات خاصة. ومع ذلك، فلا ينبغي الاستهانة بتأثير الاقتصاد العالمي. كان إخفاق الناصرية، في جزءٍ كبير منه، نتيجة لعدم القدرة على الحصول على الائتمان الأجنبي اللازم لتمويل استيراد التكنولوجيا والسلع الرأسمالية. لم يكن نقص الائتمان نتاج مؤامرة على الناصرية؛ وإنما نتيجة منطقية للإنتاجية البائسة والربح الأكثر بؤساً للصناعة المصرية. لم يكن ناصر قادراً البتّة على تنظيم النظام الاقتصادي الجديد ليعمل بفعالية، وكانت النتيجة بالقياس إلى نظام رأسمالية الدولة مماثلة لإفلاس أي شركة فردية: قطيعة كاملة مع الماضي، وإعادة تنظيم شاملة. يفرض النظام الرأسمالي على جميع العاملين داخله إما أن يواصلوا تعظيم الربح وإما أن يدفعوا الثمن: الإفلاس.
كان إخفاق الناصرية، في جزءٍ كبير منه، نتيجة لعدم القدرة على الحصول على الائتمان الأجنبي اللازم لتمويل استيراد التكنولوجيا والسلع الرأسمالية
لقد علق نظام السادات آمالاً عريضة على إقناع الشركات الغربية باتباع الطريق الذي بدأ السوفييت يسلكونه. طريق تدويل الإنتاج من خلال دمج مواقع الإنتاج المنتشرة على نطاق واسع في عملية عالمية واحدة. يشكل عصر الإنتاج العالمي الناشئ مرحلةً جديدة في توسع الرأسمالية، تتجاوز تدويل الأسواق والاستثمار. وكما كان نمو الشركات يعني أن الوحدات الفردية للرأسمال قد أصبحت الآن كبيرة بما يكفي لرفع التمويل وتحمل مخاطر الاستثمار في الخارج، فإن نمو الشركات متعددة الجنسيات ومجتمعات الدولة الرأسمالية يعني أن الوحدات الفردية للرأسمال الراهنة كبيرة بما يكفي لتخطيط عملياتها على نطاق عالمي. ومن الآن، لن يقتصر الإنتاج الصناعي في البلدان المتخلفة مثل مصر على السوق المحلية: سوف يشيد رأسماليو الدول المتقدمة مصانع مصممة للسوق العالمية. لقد اتخذ السوفييت بعض الخطوات في هذا الاتجاه في مصر، عبر الحديث عن التأسيس لإنتاج سلع مصنعة بسيطة للبيع في الكتلة الشرقية. في توجهه إلى الغرب، كان السادات يأمل أن تستغل الشركات الغربية القوى العاملة الكبيرة في مصر لإنشاء مصانع تُنتج للتصدير - وهو حلم لم يتحقق حتى الآن.
تعليقات ختامية
إن تاريخ مصر على مدى القرنين الماضيين هو تاريخ الصراع الطبقي، وفي المقام الأول، نضال الطبقة الرأسمالية العالمية لتشكيل الاقتصاد المصري وفقًا لمتطلباتها. لقد قاومت الجماهير المصرية مطامع البرجوازية، بيد أن الرأسماليون استطاعوا التغلب بشكل عام على هذه المقاومة. لا ينبغي أن نتفاجأ من أن الطبقة السائدة كانت لها اليد العليا في الصراع الطبقي. إن تاريخ مقاومة غزو الرأسمال، ضروري لفهم المجتمع المصري. لكن، يتعين علينا أن ندرك أن المقاومة لم تستطع إحراز الغلبة، فإن الرأسمالية ما زالت تحكم مصر. لذلك، فإن تاريخ الاقتصاد المصري، قبل كل شيء، هو تاريخ تَقدُّم الرأسمال.
كان السادات يأمل أن تستغل الشركات الغربية القوى العاملة الكبيرة في مصر لإنشاء مصانع تُنتج للتصدير - وهو حلم لم يتحقق حتى الآن
حقا كان تطور الاقتصاد المصري يتوفر على العديد من السمات الفريدة، إلا أنه يتكشف مع هذا عن نمطٍ عام. يشبه هذا النمط، إلى حد كبير، النمط الذي يمكن رؤيته في أمريكا اللاتينية أو إفريقيا أو آسيا: مرحلة من تصدير المواد الخام مقرونة باستيراد السلع المصنعة ينتشر خلالها إنتاج السلع غير الصناعية؛ تليها مرحلة التصنيع البديل للواردات بمساعدة الاستثمار الأجنبي. إن قابلية هذا النمط العام للتطبيق الواسع تعزز أطروحتي الأساسية: إن التغيرات في الاقتصاد المصري كانت نتيجة لتدويل الرأسمال، وليس نتيجة تطوراتٍ خاصة بمصر. لذا، يتوجب علينا رسم مخطط لعملية التصنيع قبل أن نتمكن من ملء التفاصيل الدقيقة للتجربة المصرية.
لقد كان تدويل الرأسمال عملية، وليس واقعة. إن التركيز على لحظة واحدة– ولتكن إنشاء سوق عالمية – يخاطر بإغفال الحركة الديناميكية صوب اقتصاد عالمي أشد تماسكاً من أي وقت مضى. كان تحديد مراحل التدويل هو المساهمة الأساسية للينين، التي ينبغي علينا أن نطبقها. ويجب علينا عند القيام بذلك، وكمثل لينين، أن نكون حساسين للتغييرات المستمرة في كلٍّ من البلدان المتقدمة والبلدان الأقل تقدماً، إذا أردنا إنتاج تحليل متكامل للتراكم على نطاق عالمي.
نُشِر هذا المقال في Libcom في العام 2014.
الملاحظات
1) الاشارة الى نظرية عيسوي المفصلة في التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط، وزعمها أن أسواق التصدير المتنامية كانت مهمة للاقتصاد المصري، على حين أن التنمية المصرية كانت تعتمد على قدرة الهيكل المؤسسي المحلي من الاستفادة من الفرص التي تتيحها التجارة الدولية.
2) ريمون، حرفيون وتجار في القاهرة في القرن الثامن عشر، ص 193 - 202.
3) يبرز غران في كتاب "الجذور الإسلامية للرأسمالية: مصر، 1760-1890"، الفصل الأول، أهمية تجارة الحبوب من وجهة نظر الفرنسيين.
4) كتاب أوين الكلاسيكي "القطن في الاقتصاد المصري 1820-1914". أنظر أيضا: ريفلين، "السياسة الزراعية في مصر محمد علي"؛ وعيسوي، "التاريخ الاقتصادي للشرق الأوسط 1800-"1914.
5) يصف باير في "دراسات في التاريخ الاجتماعي لمصر الحديثة"، هذه الفترة وصفا جيدا.
6) باير، "تاريخ ملكية الأراضي في مصر الحديثة 1800-1950.".
7) من الخطأ الحديث عن التراكم البدائي في أوائل القرن التاسع عشر بمصر، كما فعل آلان ريتشاردز في "التراكم والتوزيع والتغيير التقني في الزراعة المصرية". الظاهر أن ريتشاردز يتصور التراكم البدائي على أنه يعني ببساطة فقدان الحقوق في الأرض. بالنسبة لماركس، كانت العبارة تعني التراكم الأصلي للبروليتاريا والبرجوازية، وهي عملية لم تكن تجري في مصر خلال تلك الحقبة. كان المجتمع المصري يتحول إلى مجتمع منتج للسلع، لا إلى مجتمع رأسمالي. يبدو أن ريتشاردز يتقاسم بعض جوانب النهج النظري لأندريه غوندر فرانك بقدر ما يعرّف ريتشاردز الرأسمالية ضمنياً بالإنتاج للسوق.
8) عيسوي، مصر في الثورة، ص 25، يستشهد باللورد دوفرين لعامي 1876 و 1883 وكروشلي لعام 1914. أوين، القطن، ص 271-3، يعطي بيانات مماثلة. تعرض البيانات الحكومية حول الرهون العقارية أرقاما أقل بكثير، أغلب الظن بسبب عدم تسجيل العديد من الرهون العقارية الصغيرة.
9) بيانات ملكية الأراضي في "الدليل الإحصائي" Annuaire Statistique تنحاز نحو الحيازات الصغيرة من حيث أنها تبلغ عن الإقرارات الضريبية للأراضي التي تم جمعها من قبل القرية.
سيظهر الفرد الذي يمتلك أرضا في عدة قرى غير مرة.
مثال على التحيز: أظهر التعداد الزراعي لعام 1939 حيازات أقل من 5 أفدنة مع 19070 من المنطقة بينما أظهر الدليل 32.4٪ ؛ سجل التعداد الحيازات التي تزيد عن 50 فدانًا بنسبة 45 ٪ من المساحة ، بينما سجلها الدليل بنسبة 37.3 ٪ (أشار إليه باير، التاريخ، ص 71 - 3). لم يقدم الدليل ولا التعداد بيانات عن حجم المزرعة.
10) "Ta 'maliyya". يحتوي البحث الممتاز، "الاقتصاد السياسي للعزبة المصرية، ١٨٨٠ - ١٩٤٠"، بقلم ريتشاردز، على وصف جيد لـ"نظام العزبة".
11) البيانات مأخوذة من كراوتشلي، "استثمار الرأسمال الأجنبي في الشركات المصرية والدين العام".
12) باير، "التاريخ"، الصفحات 68-9 و 120-31؛ أوين، "القطن"، ص 291-3.
13) أحد الموضوعات الرئيسية لتقارير كرومر هو مصادر الرخاء المصري مقارنة بالبؤس الهندي.
14) كراوتشلي، "التطور الاقتصادي لمصر الحديثة"، ص 115 - 8، يسجل نفقات الأشغال العامة بين عامي 1850 و 1880، كاشفاً عن ارتباطها الوثيق بنمو الدين. في عهد إسماعيل(1863-1879)، أُنفق 51 مليون جنيه إسترليني على الأشغال العامة، بما في ذلك 13 مليون جنيه إسترليني على السكك الحديدية، و 12 مليون جنيه إسترليني على الري، و12 مليون جنيه إسترليني على قناة السويس. كان إسماعيل يحاول تقليل الاعتماد على أوروبا من خلال التنويع الاقتصادي والتوسع. انتهى به الأمر إلى تشديد قبضة اقتصاد القطن لا أكثر.
15) تقرير كرومر السنوي لعام 1902 في عيسوي، "التاريخ". أنظر أيضا تيغنور، "التحديث والحكم الاستعماري البريطاني في مصر".
16) حقيقة أغفلها أوين في "لورد كرومر وتطور الصناعة المصرية، 1883 - 1907". فعلى حين كان يرحب بالبنية التحتية التي توفرها الحكومة للزراعة، عارض كرومر المساعدة الفنية(توفير البذور، وحملات مكافحة الديدان) والقروض (بنك الائتمان الزراعي). كانت معارضته غير فعالة عموما (باستثناء: منع كل إجراء لمساعدة أولئك الذين سقطوا في حادث تحطم 1907). لا يميز أوين أيضاً بين حاجز التعريفة الاسمية الذي تواجهه واردات المنسوجات(8٪) والحواجز الجمركية الفعالة (التي لا يمكن أن تكون أكثر من 4٪، بالنظر إلى دفع تعريفة 8٪ على الآلات المستوردة).
17) كتب لينين في كتابه الإمبريالية: "يؤثر تصدير الرأسمال بشكل كبير على تطور الرأسمالية ويسرع من تطورها في البلدان التي يتم تصدير الرأسمال إليها". كتب ماركس وإنجلز في بيان الحزب الشيوعي: "البرجوازية… تفرض على جميع الأمم، تحت التهديد بالإبادة، على تبني نمط الإنتاج البرجوازي: إنها تفرض عليهم أن يُدخلوا في بيئتهم ما تسميه هي بالحضارة، أي أن يصبحوا هم أنفسهم برجوازيين".
18) كرواتشلي، "استثمار الرأسمال الأجنبي"، ص 106.
19) بيرك، الإمبريالية والثورة، ص 633 وما بعدها. يناقش تيغنور، "الثورة المصرية عام 1919" ، ثلاث مجلات اقتصادية أسبوعية أسسها أوروبيون مقيمون في مصر - دعت جميعها إلى الصناعة المحلية والتحرر من زراعة القطن الأحادية.
20) للوقوف على وصف الترويج القومي للصناعة المحلية ، انظر بيرك، الإمبريالية والثورة، الفصل 4 من الجزء 3. وهذا أيضا هو المصدر الأساسي للصناعة في عشرينيات القرن الماضي.
21) دور بنك مصر في الاقتصاد المصري بين الحربين موصوف في ديب، "بنك مصر وظهور البرجوازية المحلية في مصر" ، وديفيز، "بنك مصر والاقتصاد السياسي للتصنيع في مصر".
22)حسين، الصراع الطبقية في مصر 1945-1971، الفصل الأول، ميز بين قسمين من الطبقات الحاكمة المصرية. فهو يخلط بين التمييز الوطني / الكومبرادوري وبين الانقسام بين الرأسمال المصري والرأسمال الأوروبي المشرقي. يهاجم كل من عبد الملك وأمين هذه النظرية، لكن لا يحللا بشكل كاف الانقسامات الفعلية في الطبقة الحاكمة.
23) عبد الملك، الفصل الأول، يشرح بالتفصيل تاريخ الحركة القومية، موضحًا دور التيارات اليمينية المتطرفة.
24) وارينر، إصلاح الأراضي والتنمية في الشرق الأوسط، ص 2-1.
عبد الملك، الصفحات 62-68 و 80، يقتبس من وثائق الحكومة الأمريكية المعاصرة حول الرغبة في الإصلاح الزراعي وصحة مرسوم الإصلاح.
25) صعب، الإصلاح الزراعي المصري 1953-1962، إنه المصدر الأساسي للإصلاح الزراعي. الاقتباس من ص 48.
26) رضوان، الإصلاح الزراعي والفقر الريفي: مصر 1952-1975، الصفحات 62-3.
27) مستمدة من بيانات حكومية مفصلة. راجع كلاوسون، تدويل رأس المال.
28) دونالد ميد، "النمو والتغيير الهيكلي في الاقتصاد المصري"، ص 80-98، يجادل في استنتاج هانسن، في هانسن ومرزوق، "السياسة الاقتصادية التنموية في الجمهورية العربية المتحدة (مصر)"، بأن هناك القليل من البطالة المقنعة في الزراعة المصرية. ينجح ميد، وحسب، في إثبات أنه غير قادر على تصور أي نمط عمل باستثناء 9 إلى 5، خمسة أيام في الأسبوع. إن دليل ميد على وجود بطالة مقنعة ينهض على افتراض أن العمال سيعملون على مدار السنة بنفس الكثافة التي يعملون بها خلال موسم الحصاد. في العديد من المجالات، تعتبر أنماط العمل المنتظمة غير عادية - تدبر صناعة السيارات الأمريكية، بدوراتها من العمل الإضافي الثقيل والتسريح الطويل للعمال.
29) إبراهيم، مصر، ص 110؛ مبرو ورضوان، تصنيع مصر 1939-1973، ص 97-103. الاقتباس من إكرام ص 134 - 5. البيانات مأخوذة من الملخص الإحصائي 1975، ص 13، ومبرو، الاقتصاد المصري 1952-1972، ص 210.
30) تتميز الرأسماليةَ عن الإقطاع ومجتمعات الصيد والجمع… إلخ، بإنتاج السوق. بينما تتميز عن المجتمعات التجارية مثل اليونان القديمة، بالاتجاه الى الربح. على حين تتميز عن العبودية أو الإقطاع، بحرية العمالة في العمل حيثما شاءت. "الحرية" من أي مصدر آخر للإنتاج يميز الرأسمالية عن صغار المنتجين على غرار يومان، وعن الكومونات على غرار الكيبوتس. إن التحكم في وسائل الإنتاج بواسطة مجموعة صغيرة من السكان يضمن أن معظم السكان يجب أن يعملوا مقابل أجر، لأنهم لا يستطيعون المشاركة في الدخل من وسائل الإنتاج.
31) الأيوبي، "البيروقراطية والسياسة في مصر المعاصرة"، انظر ص 455-6 للاقتباس الأول، وانظر ص 733 و 378 للبيانات(من 1970) وانظر pp 384 للاقتباس الثاني. يحتوي مايفيلد، "السياسة الريفية في مصر تحت حكم عبد الناصر"، على وصف مفصل للاتحاد الاشتراكي العربي. يركز على المنظومة الورقية المعقدة للاتحاد الاشتراكي، إلا أنه يتضمن لمحات حول أسلوب عمله في الحقيقة.
32) مبرو ورضوان، ص 99. يستشهدون بمثال عقد من قبل شركة عامة لتجريف الأرض بمعدل 3.0 جنيهات إسترلينية لكل متر مكعب. قام المقاول الخاص بتأجير العقد من الباطن إلى رؤساء العمال بمعدل 65 جنيه استرليني وجرى دفع 0.04 جنيه استرليني للعمال على المتر المكعب (تجريف الأرض في مصر يتطلب عمالة كثيفة وندرة رأس المال).
33) البيانات مأخوذة من الكتاب الإحصائي السنوي لعام 1975. رقم 2 مليون من سكان الحضر من المستقلين اقتصادياً هو تقدير أولي من بيانات التوظيف.
34) إكرام، pp340-345، تعرض تقديرات البنك الدولي للموارد، والعجز، وتمويل العجز للفترة 1952-1972. هذا هو المصدر الرئيسي للبيانات المذكورة هنا.
35) كانوفسكي، "الأثر الاقتصادي لحرب الأيام الستة"، ص 270 - 291.