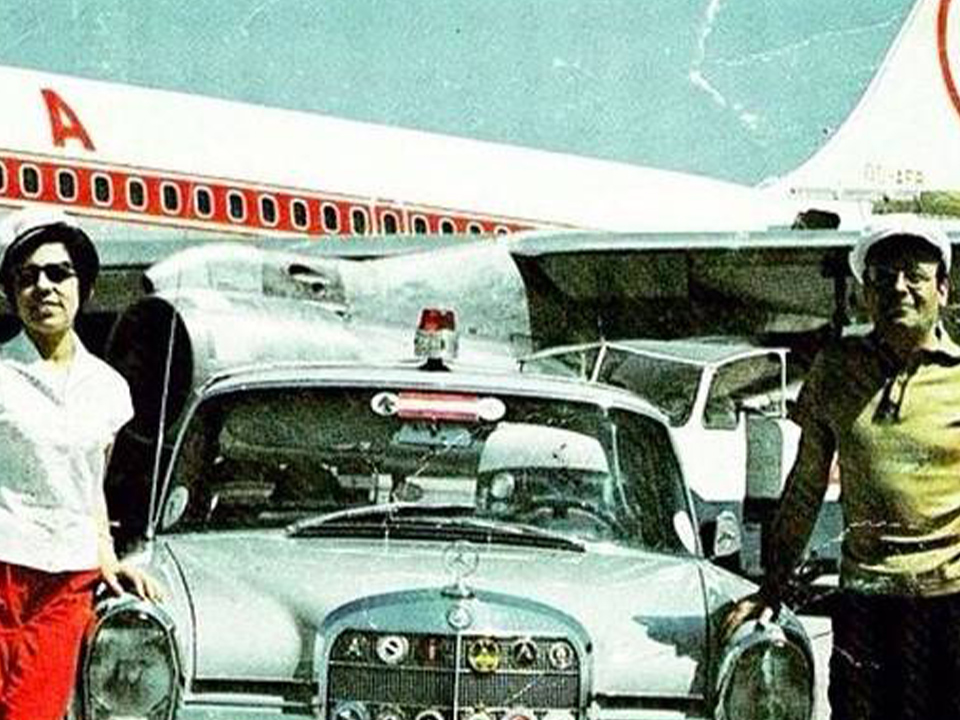انعكاس لضعف التنافسية الاقتصادية
4 حقائق عن التضخّم في لبنان
مع مضي أكثر من 5 سنوات على الأزمة في لبنان، لا يزال مستوى التضخّم مرتفعاً للغاية. وما يميّز في هذا المؤشّر هو أنه لا يقتصر على قراءة مستوى الأسعار فحسب، بل يعكس أيضاً أعراض العيوب البنيوية الراسخة في النموذج الاقتصادي اللبناني. وبالنظر إلى أن التضخّم والسياسة النقدية مرتبطان ارتباطاً وثيقاً، يعكس ارتفاع معدّل التضخّم بنية الأسعار الداخلية غير الملائمة لتنافسية الاقتصاد.
الحقائق الأربع
أولاً، يشير مؤشّر الأسعار الصادر عن إدارة الإحصاء المركزي إلى أن معدل التضخّم بلغ 45.2% على أساس سنوي في العام 2024. وبهذا، يحتلّ لبنان مكانة متقدّمة، وإن كانت غير مُحبّبة، ضمن البلدان العشرة الأوائل التي تعاني من أعلى معدّلات التضخّم عالمياً.
ثانياً، يعتبر معدّل التضخّم من المؤشّرات الماكرو-اقتصادية الأكثر متابعة في العالم، لأنّه يؤثّر بشكل مباشر على تطوّر القدرة الشرائية للسكّان وعلى قيمة ادخاراتهم. بمعنى آخر، يعمل التضخّم، بشكل ضمني، كضريبة تقلّص القدرة الشرائية للأجور والادخارات. في لبنان، تؤثّر هذه «الضريبة» على الأشخاص ذوي الدخل الثابت والمتقاعدين الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية. ما يجعل هذه الضريبة الضمنية على القدرة الشرائية بالليرة اللبنانية، بمعزل عن الدخل أو الثروة أو الوضع الاجتماعي، غير متناسبة، وبالتالي غير عادلة، إذ تؤثر بشكل أكبر على أصحاب الدخل المنخفض.
ووفقاً لتقرير «المرصد الاقتصادي لخريف 2024» الذي يصدره البنك الدولي، فقد عانى العامل الذي يتقاضى أجراً بالليرة اللبنانية أو يدّخر بالليرة اللبنانية، من تضخّم تراكمي بلغ 5,970.7% منذ بداية الأزمة في العام 2019، وهو ما قلّص قدرتهم الشرائية إلى مستوى قريب من الصفر. وبسبب انهيار العملة، سُجِّل تضخّم ثلاثي الأرقام بين تموز/يوليو 2020 ونيسان/أبريل 2024. ففي العام 2021 بلغ متوسّط معدّل التضخم 155%، وارتفع في العام 2022 إلى 171% بعد الإلغاء التدرّجي للدعم، فيما وصل في العام 2023 إلى نحو 221% على أساس سنوي، مع ذروة بنسبة 350% في أسعار الغذاء سُجِّلت في نيسان/أبريل 2023.
مع ذلك، لا يؤثّر التضخّم على الأشخاص الذين يتقاضون أجورهم بالليرة اللبنانية فحسب. ويعاين البنك الدولي حالة عامل افتراضي يتقاضى راتبه بالدولار الأميركي منذ العام 2019، ويلاحظ أن قدرته الشرائية انخفضت تراكمياً بنسبة 4.9% بين أيلول/سبتمبر 2019 و2024. يتبيّن أن هذه القدرة الشرائية شهدت تقلّبات كبيرة سنوياً، لكن الاتجاه الغالب هو الانخفاض. ففي العام 2021 سجّلت القدرة الشرائية بالدولار زيادة بنسبة 54%، قبل أن تسجِّل انخفاضات مُتتالية بنسبة 14% في العام 2022، ومن ثمّ 19.1% في العام 2023، وأخيراً بنسبة 26.6% في العام 2024. ووفقاً للبنك الدولي، تعود هذه الانخفاضات بالأساس إلى الإلغاء التدرّجي لدعم العملة، الذي كان يغطّي سابقاً المنتجات الأساسية مثل الوقود، والأدوية، والقمح، بالإضافة إلى التوسّع في تسعير السلع بالدولار في جميع القطاعات الاقتصادية، وخصوصاً في الخدمات المحلّية مثل النقل والتعليم والصحّة والإسكان، فضلاً عن تطبيق زيادات غير خاضعة للرقابة في الأسعار ناتجة عن توقّعات مستقبلية بحصول مزيد من التدهور في العملة المحلية.
ثالثاً، صحيح أنّ وتيرة التضخّم قد تباطأت، وبات معدّل التضخّم الآن مؤلفاً من رقمين بدلاً من 3 أرقام، ما قد يوحي بتحسّن نسبي، ولكنّه لا يزال مرتفعاً بكل المقاييس.
رابعاً، يعود تباطؤ التضخم إلى استقرار سعر الصرف عند 89,500 ليرة للدولار. وهو إجراء فرضه حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري بعد انتهاء ولاية الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة في تموز/يوليو 2023، خصوصاً أن منصّة «بلومبرغ»، التي كان من المفترض أن تدير العرض والطلب في سوق الصرف. لم ترَ النور لليوم، على الرغم من أنه روِّج لها كأولوية في حينه. وبدلاً من ذلك، تم اعتماد سياسة نقدية شديدة التقييد تهدف إلى الحدّ من تمويل الدولة بحجة السيطرة على الكتلة النقدية المتداولة. وقد دُعِم هذا الاستقرار بزيادة الإيرادات الضريبية المُجباة عبر وزارة المالية أو عبر المؤسّسات العامة مثل كهرباء لبنان. فيما يبدو أن احتياطات مصرف لبنان بالعملات الأجنبية سجّلت ارتفاعاً طفيفاً.
ويتشابه هذا النهج، إلى حدّ كبير مع النهج الذي ساد في عهد رياض سلامة، حين كان التوازن المُصطنع يأتي على حساب تكاليف باهظة تفرض على المجتمع. وبدليل أن المودعين لا يزالون محرومين من الوصول إلى مدّخراتهم (حتى مع إخضاعها للقصّ)، فيما يتحمّل دافعو الضرائب أعباءً مالية أثقل من دون أي تحسّن ملحوظ في الخدمات العامّة المقدّمة. وفي حين نجح المقترضون من القطاع الخاص بمحو ديونهم، لم تستأنف عملية الإقراض في الاقتصاد بسبب التمنّع المتعمّد عن إعادة هيكلة المصارف، ما أدّى إلى تفاقم الركود الاقتصادي.
لذلك، يحذّر البنك الدولي من هشاشة سياسة استقرار الليرة اللبنانية، مشيراً إلى أن هذه الاستراتيجية تعتمد على تدابير مؤقتة تم تبنّيها منذ آب/أغسطس 2023، وهي غير مُستدامة، خصوصاً في ظل التوقّعات الحالية بزيادة الحاجة إلى التمويل العام لتدارك تداعيات الحرب وتلبية متطلّبات إعادة الإعمار.
استقرار ظاهري لنموذج يعيد تجديد نفسه
تعكس السوق حقيقة مفادها أن تجفيف الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، إلى جانب وقف منح قروض بالعملة المحلية، أدّيا إلى اضمحلال التعامل بالعملة الوطنية وشبه اختفائها. ونتيجة لذلك، أصبح الاقتصاد اللبناني مدولراً بالكامل. وفعلياً، تقتصر استخدامات الليرة اللبنانية، اليوم، على إرجاع الفكّة في المعاملات التي تتطلّب تبادلاً بالأوراق النقدية ذات القيمة الاسمية الصغيرة. فضلاً عن استخدام الليرة كنوع من «قسائم» لسداد الضرائب والرسوم الإلزامية وبعض الخدمات العامة مثل الكهرباء، التي تعتمد في تسعيرها على الدولار.
والواقع أن استقرار سعر الصرف وتنامي الدولرة يؤدّيان إلى تفاقم التضخّم الحقيقي، وبالتالي حرمان الاقتصاد من القدرة على التكيّف مع الفجوة الحقيقية بين تكاليف إنتاجه وتكاليف الإنتاج في بقية العالم. وهذا بدوره يشكّل عائقاً أمام تحقيق مكاسب في التنافسية الاقتصادية.
وهذا ما توضحه حسابات الاقتصادي شربل نحاس، الذي يقارن تطوّر الأسعار بتطوّر سعر الصرف عند تثبيت الدولار. وتُستخدم هذه القياسات بالدولار الثابت لتقييم الضغوط التضخّمية الحقيقية، وليس التضخّم الاسمي فحسب، من خلال تحييد تأثير التقلّبات النقدية، بمعنى تحييد آثار تغيّرات سعر الصرف وتأثير التضخّم في الولايات المتّحدة في خلال الفترة المدروسة. ماذا نلاحظ إذاً؟ بين كانون الأول/ديسمبر 2017 وكانون الأول/ديسمبر 2024، تدهورت قيمة الليرة اللبنانية بشكل حادّ (الخطّ الرمادي). وانتقلت من 1,507 ليرات مقابل الدولار في نهاية العام 2017، هو العام الأساس، إلى 125,000 ليرة في ذروتها في آذار/مارس 2023، قبل أن تستقرّ عند حوالي 89,500 ليرة للدولار بعد انتقال الحاكمية من رياض سلامة إلى وسيم منصوري في تموز/يوليو 2023.
إلى ذلك، يُظهر منحنى مؤشر الأسعار (الخطّ البرتقالي) ارتفاعاً موازياً للأسعار مع تراجع قيمة الليرة، ولو أن الارتفاع كان أبطأ نسبياً. واللافت هو القفزة شبه العمودية في الأسعار بين آب/أغسطس وأيلول/سبتمبر 2023 بمجرّد استقرار سعر الصرف. وكان شربل نحاس قد رصد قفزة مماثلة في بداية العام 1992 في كتابه «اقتصاد ودولة من أجل لبنان». آنذاك، لم تنجح سياسة تثبيت سعر الصرف في الحدّ من التضخّم بالدولار، بل على العكس تماماً، أدّت إلى تضاعف مؤشّر الأسعار. فقد تسبّبت تدفّقات الأموال الآتية من الخارج في تضخّم حادّ بفعل زيادة الطلب، ما أدّى إلى فصل الأسعار تماماً عن سعر الصرف، على الرغم من الدولرة شبه الكاملة للاقتصاد.
ويمكن توضيح تأثير العملة الأجنبية على اقتصاد محلّي من خلال حالة اليونان مع اليورو. فعندما لا يكون هناك توافق اقتصادي وإنتاجي مع الدولة التي تتحكّم في العملة، تميل الاقتصادات التي تعتمد على عملة خارجية إلى الإفراط في الاستدانة. وهذا بالضبط ما حدث في لبنان حتى العام 2019، عندما كان النموذج الاقتصادي يعتمد على الودائع المصرفية والديون.
من خلال مقارنة التضخّم بسعر الصرف عند تثبيت الدولار، يمكن تحديد ما إذا كانت الأسعار المحلّية ترتفع بسرعة تفوق انخفاض أو ارتفاع قيمة العملة المحلّية مقابل الدولار. ويساعد ذلك في فهم ما إذا كانت القدرة التنافسية للمنتجات المحلّية في الأسواق الدولية ترتفع أو تنخفض. ويعود هذا التمييز إلى تأثير العوامل المختلفة التي تؤدّي إلى ارتفاع الأسعار. فإذا كان التضخّم مرتفعاً على الرغم من استقرار سعر الصرف بالدولار الثابت، فهذا يعني أن التضخّم ناتج بشكل أساسي عن عوامل داخلية مثل زيادة الطلب، وارتفاع تكاليف الإنتاج، أو توسّع هوامش الأرباح.
حتى العام 2019، كان استقرار أو ارتفاع سعر الصرف في لبنان يعوِّض التضخّم بالدولار في الولايات المتّحدة، ما وفّر ضماناً إضافياً لتدفّقات رأس المال نحو لبنان. لكن الأزمة أوقفت هذه الدينامية، محدثة تعديلاً في نسبة التضخّم الداخلي. ومع ذلك، لم يدم هذا التعديل طويلاً، وسرعان ما ارتفعت الأسعار مرّة أخرى، وفقاً لشربل نحاس. يظهر هذا الاتجاه في المنحنى (الخطّ الأصفر) الذي يمثل تطوّر نسبة مؤشّر الأسعار إلى سعر الصرف. ويمكن ملاحظة انخفاضٍ هذه النسبة من 100 إلى 50 بين آب/أغسطس 2019 وتموز/يوليو 2020، حيث استقرت نسبياً. ومع رفع الدعم، ارتفعت مجدّداً في أيلول/سبتمبر 2021 إلى حوالي 100، ومع استقرار سعر الصرف منذ صيف 2023، تجاوزت هذه النسبة 120 نقطة.
التضخّم ليس مستورداً بالكامل
يتناقض هذا التطوّر مع الفكرة الشائعة بأن التضخّم في لبنان مستورد بالكامل، أي أنه مجرّد انعكاس لتقلّبات أسعار السلع العالمية مثل النفط أو القمح. على العكس من ذلك، تظهر البيانات أن الجزء الأكبر من التضخّم يتعلّق بأسعار الاستهلاك المحلّية التي تُحدّد في السوق الداخلية. وبالتالي، فإن استقرار سعر الصرف لا يعني بالضرورة استقرار الأسعار عموماً، وإنّما يشير إلى انخفاض القيمة المضافة المحلّية، ما يؤدّي إلى تراجع أكبر في الدخل المحلّي مقارنة بأسعار السلع المستوردة. وهذا يعكس انخفاض الوزن النسبي للدخل المحلّي في مقابل الدخل الخارجي، ويجعل الاقتصاد اللبناني أكثر اعتماداً على تدفقات العملات الأجنبية. بعبارة أخرى، يزداد الوزن النسبي للدخل الخارجي عندما يكون الدخل المحلي ضعيفاً.
إن تأثير هذه التغيرات على بنية التكاليف كارثي بالنسبة إلى التنافسية الاقتصادية. وفي الواقع، تُظهر هذه التطوّرات فقداناً بنيوياً للتنافسية، ما يشكّل تحدّياً كبيراً لعكس هذا المسار وبناء اقتصاد منتج. كان من المفترض أن يؤدّي تصحيح بنية الأسعار الناتج عن تخفيض قيمة العملة إلى تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد اللبناني من خلال خفض تكاليف الإنتاج المحلّية، لكن هذا التأثير لم يدم سوى عامين ونصف العام فقط. والمؤشّر الذي يقيس التنافسية النسبية هو سعر الصرف الحقيقي (المشار إليه بالخطّ الأزرق)، ويتمّ حسابه من خلال ضرب سعر الصرف الاسمي بنسبة الأسعار بين بلدين (في هذه الحالة لبنان والولايات المتّحدة). يتيح هذا المؤشر مقارنة الأسعار النسبية، أي قدرة البلاد على التصدير أو الميل إلى الاستيراد مقارنة بدولة أخرى. وتُظهر بيانات هذا المؤشر أن الأسعار في لبنان، مقارنةً بالولايات المتّحدة، ارتفعت بمعدل مرتين ونصف المرّة أعلى من مستواها التاريخي. ووفق حسابات شربل نحاس، ارتفعت الأسعار من قاعدة 100 في العام 1970 إلى 240 في كانون الأول/ديسمبر 2017، وهي الذروة التي عكست حينها المبالغة في تقييم العملة الوطنية. ثمّ عادت الأسعار إلى مستوى قريب من ذلك (220 نقطة) بعد استقرار سعر الصرف في صيف 2023. ومع استقرار سعر الصرف، استقرّت الأسعار النسبية مقارنة ببقية العالم عند مستويات ما قبل الأزمة. ولكن، تزامن ذلك مع انكماش الناتج المحلي الإجمالي إلى نحو 40% ممّا كان عليه في العام 2019، ما أدّى إلى انتقال لبنان وفق تصنيف البنك الدولي من الشريحة العليا للبلدان المتوسط الدخل إلى الشريحة الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل.
يرى وزير الاقتصاد، عامر بساط، أن هذا المستوى الاقتصادي أقل بكثير من إمكانيات لبنان. ففي خلال ندوة أقامها معهد عصام فارس في الجامعة الأميركية في بيروت، أشار بساط إلى أن نصيب الفرد من الدخل في لبنان ينبغي أن يكون أقرب إلى دول مثل تركيا والبرتغال وقبرص أو تشيلي. وقد وضع رؤيته لإعادة الإنتاجية في ورقة بحثية مُشتركة مع إسحاق ديوان بعنوان «نحو لبنان منتج جديد». يؤكّد عامر بساط أن الحلّ يكمن في إعادة توجيه الموارد نحو القطاعات القابلة للتداول والمنافسة الخارجية على حساب القطاعات غير القابلة للتداول. والهدف هو دعم الصادرات وتشجيع أي إنتاج لسلع وخدمات يمكن أن يدرّ العملة الصعبة أو يقلّل من إنفاقها، من دون الاعتماد المفرط على الهجرة وتحويلات المغتربين، وهو ما يشدّد عليه شربل نحاس.
ويضرب هذا الهدف في صميم المشكلة البنيوية اللبنانية التي أدّت إلى الأزمة، وتقليص العجز في الحساب الجاري هو مفتاح الحلّ.
ارتفاع أسعار السلع غير القابلة للتداول
تظهر تحليلات تطور التضخّم حسب القطاعات أنّ العكس هو ما يحدث الآن: القطاعات غير القابلة للتداول هي التي تشهد أكبر زيادة في الأسعار، كما يظهر في قطاع المطاعم حيث وصلت الأسعار بالدولار إلى 6 أضعاف مستوى ما قبل الأزمة. ويقدّم انفجار الأسعار في قطاع المطاعم مثالاً واضحاً لشرح النموذج القائم: من المفترض أن يؤدّي انخفاض الناتج المحلي الإجمالي إلى انخفاض تكاليف الإنتاج المحلّية واستعادة القدرة التنافسية، وبالتالي عودة النمو الاقتصادي. لكن المفارقة هي أن انخفاض الدخل يسبّب أيضاً هجرة جماعية تؤدّي إلى تحويلات ضخمة من رؤوس الأموال من الاغتراب. وهذا التدفّق من العملات الأجنبية يعوِّض انخفاض الدخل من خلال زيادة الطلب الذي يحدث في بعض القطاعات المحدّدة، ومن ضمنها قطاع المطاعم. وبالتالي، تميل الموارد المتاحة في البلاد إلى التراكم في هذه القطاعات على حساب القطاعات الأخرى القابلة للتبادل والخاضعة للمنافسة الأجنبية، ما يقلّل من القدرة التنافسية العامة للاقتصاد بدلاً من زيادتها.
ويستمر هذا النموذج منذ عقود، وتزيد الأزمة من تأثيراته التشويهية بسبب الزيادة النسبية لرؤوس الأموال الخارجية مقارنةً بالإيرادات المحلّية. بدليل ارتفاع نسبة تحويلات المغتربين إلى الناتج المحلي الإجمالي بشكل ملحوظ، من 15% أو 20% إلى نحو 40%. ويستلزم استمرار هذه النسبة تسريع الهجرة لضمان تدفّق العملات الأجنبية.
وبالنسبة إلى العوامل الداخلية، يكمن التحدّي في الاستفادة من تدفقات هذه العملات الأجنبية التي تزداد حصتها في الاقتصاد. يحدّد التجار هوامشهم بالدولار للحفاظ على قوتهم الشرائية وتمويل استهلاكهم الخاص للخدمات الدولارية (المطاعم والسفر، إلخ…). وللتأثير على التضخّم - وهو في الأساس أحد الأهداف الرئيسة لأي سياسة اقتصادية - يجب العمل على المكوّنات المختلفة لهذا النموذج، الذي يمثل تصدير اللبنانيين الاتجاه الرئيس له.