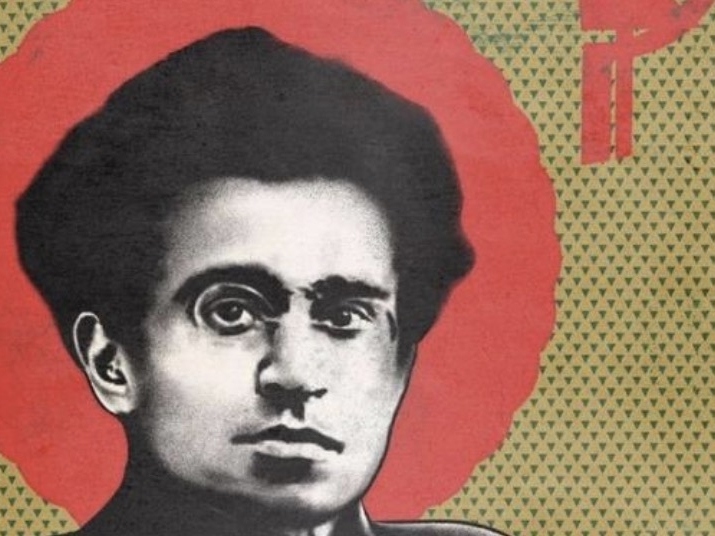دولة التوافقية في لبنان
- ماذا لو أن تبنّي التوافقية يسير جنباً إلى جنب مع تشكيل الدولة؟ كيف يؤثّر في «الأشكال المختلفة للدولة» التي تظهر في هذه السياقات، وفي آفاق بناء الدولة؟ وعلى نطاق أوسع، ما تأثير الاختلافات في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية على بناء الدولة وشكل السياسة في مرحلة ما بعد الاستعمار؟ تعود هذه الورقة إلى أصول تبنّي التوافقية في بنية الدولة الكولونيالية في لبنان لتوضيح ما للاختلافات في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية من آثار في أشكال الدولة والمسارات السياسية.
- ماذا لو أصبحت التوافقية ذريعة لتبرير استيلاء النخبة على مؤسّسات الدولة ومواردها، وبالتالي كبح نشوء مظاهر الدولة والقدرة على الحكم كشروط مُسبقة لنجاح تقاسم السلطة؟ هذه الصورة عن «الدولة الفاعلة» مع «مؤسّسات غير مشخصنة» و«مديرو دولة» فاعلين يمكنهم إدارة الاختلافات العرقية بقبضة مُحكمة، تنتمي إلى شكل الدولة المؤسّساتية الفيبرية باحتكارها للعنف والقدرات الاستخراجية والتدخلية التي تمارس من خلال بيروقراطية مركزية وعقلانية ومستقلة، أكثر من انتمائها إلى أشكال الدولة التي تجدها في جميع أنحاء الجنوب العالمي، سواء في المراحل ما بعد الكولونيالية أو بعد الحرب.
يُعدُّ التقاسم التوافقي للسلطة واحداً من الاستراتيجيات الديمقراطية لإدارة النزاعات في الأماكن المنقسمة.1 وسماته المؤسّسية الرئيسة الرامية إلى تعزيز السلام والاستقرار في الأماكن المُنقسمة أو الخارجة من حرب، تتمثّل في تشكيل تحالف واسع بين مكوّناتها، وامتلاك كلّ منها حقّ النقض المتبادل، وحصّة متناسبة مع حجم كلّ مكوّن واستقلالية ثقافية جزئية.2 طوِّرت استراتيجية تقاسم السلطة للمرّة الأولى تجريبياً من خلال دراسة أربع حالات أوروبية - النمسا وبلجيكا وهولندا وسويسرا - تتشارك في عدد من السمات التي تميّزها عن حالات أخرى طُبِّقت عليها هذه الاستراتيجية في وقت لاحقٍ، إذ «انقسمت هذه التوافقات الكلاسيكية الأربعة أيديولوجياً ولغوياً ودينياً وليس إثنيّاً».3 بعبارة أخرى، فإنه على العكس من حالات البوسنة والعراق ومقدونيا وإيرلندا الشمالية وجنوب تيرول، لم تتضمّن الحالات الأوروبية الكلاسيكية أية مجموعات إثنية تطالب بحقّ تقرير المصير4 - تُعدّ الحركة الانفصالية الفلمنكية تطوّراً حديثاً. كما أن الترتيبات التوافقية فيها، باستثناء النمسا، لم تنشأ بعد نزاعات عنيفة.5 والأهمّ من ذلك، أن الحالات الأربعة تتشارك «تقاليد دولتية عريقة»،6 حيث سار تشكيل الدولة (عملية إنشاء الحدود مع احتكار العنف) وبناؤها (أي التحوّل من السلطة الميراثية إلى الإدارة البيروقراطية)7 بالتوازي. وهو ما مكّن الدولة من توسيع قدرتها المؤسّساتية، وتأدية دور هام في الوساطة بين المصالح المجتمعية وتحوّلها، وبالتالي فتح المجال أمام إنهاء الفصل العمودي للمجتمع وإلغاء التوافقية السياسية في المستقبل، كما هو الحال على الأقل في النمسا وهولندا،8 «حيث تلاشت الانقسامات الطبقية والدينية».9
العمليات الطويلة لتشكيل الدولة بعد الثورة الصناعية تعني أن تقاسم السلطة في الحالات الأوروبية الكلاسيكية لم يرتكز على الهويات الإثنية أو الدينية، بل على الانقسامات الإقليمية والأيدولوجية والوظيفية
إنّ العمليات الطويلة لتشكيل الدولة بعد الثورة الصناعية تعني أن تقاسم السلطة في الحالات الأوروبية الكلاسيكية لم يرتكز على الهويات الإثنية أو الدينية، بل على الانقسامات الإقليمية والأيدولوجية والوظيفية.10 في بلجيكا وهولندا، على سبيل المثال، تسبّب وجود أكثر من انقسام غير ديني وقوّة الانقسامات الطبقية الاجتماعية في الدفع نحو تبنّي مواقف معتدلة في السياسة. إن الضغوط التنظيمية المتقاطعة بين الأقطاب الاشتراكية والليبرالية والمسيحية في بلجيكا، أو بين الاشتراكيين والليبراليين والديمقراطيين المسيحيين في هولندا، «أجبرت هذه الأقطاب على تخفيف حدّة مواقفها».11 فضلاً عن ذلك، أُنهِي الفصل الطائفي للمجتمع في هولندا في سياق دولة الرفاه،12 وحدث من أسفل نتيجة اختفاء الانقسام الاجتماعي لا نتيجة انفراط توافق النخبة، وأدّى في النهاية إلى التخلّي عن الاصطفاف على أساس الانقسامات الاجتماعية-الاقتصادية والدينية بشكل دائم. أمّا في بلجيكا فقد أدّى التخلّي عن الاصطفاف القائم على أساس الانقسامات الطبقية والدينية إلى نشوء اصطفاف وفق الانقسام اللغوي.13 وبالمثل، كانت تجربة تقاسم السلطة في سويسرا «نتيجة لكلٍ من الاستمرارية التاريخية والابتكار السياسي».14 لقد أدّت هذه العملية الطويلة لتشكيل الدولة إلى إنشاء هيئات إقليمية ووظيفية، بدلاً من الجماعات الإثنية، بوصفها الأسس الرئيسة لتقاسم السلطة، دون ظهور أحزاب سياسية إثنية أو تقاطع بين الجماعات العرقية أو المناطق أو الطبقات.15
ماذا لو أن تبنّي التوافقية يسير جنباً إلى جنب مع تشكيل الدولة؟ كيف يؤثّر في «الأشكال المختلفة للدولة»16 التي تظهر في هذه السياقات، وفي آفاق بناء الدولة؟ وعلى نطاق أوسع، ما تأثير الاختلافات في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية على بناء الدولة وشكل السياسة في مرحلة ما بعد الاستعمار؟ تعود هذه الورقة إلى أصول تبنّي التوافقية في بنية الدولة الكولونيالية في لبنان، لتوضيح ما للاختلافات في تسلسل (sequencing) تشكيل الدولة واعتماد التوافقية من آثار في أشكال الدولة والمسارات السياسية في الحالات الأوروبية الأصلية وفي سياقات ما بعد الاستعمار.
إن التشديد على العمليات البديلة لتشكيل الدولة يؤكّد أهمّية التحقّق من كيفية تفاعل أشكال الدولة المختلفة مع السمات المؤسسية للحزمة التوافقية. لذلك تعتمد هذه الدراسة على عدد من الخيارات المنهجية، أولاً من أجل تجنّب الوقوع في شرك مقارنة التجارب التوافقية المختلفة من بوابة التشابهات بدلاً من مقارنتها طبقاً للعمليات القائمة بالفعل،17 وثانياً لتتبع تأثير التوافقية بصفتها حزمة مؤسّسية في الدولة في طور تشكيلها. وللقيام بذلك، أضع جانباً شكل الدولة الذي تدرج فيه السمات المؤسّسية للتوافقية. يفتح «إضفاء الطابع التاريخي على الدولة في تشكُّلها»18 المجال لمقاربة «المنعطفات الحاسمة» (critical junctures) التي تشدِّد على «دور الخيارات والأفكار»19 في بلورة التوافقية في أثناء تشكيل الدولة، وهو تشكيل أعاق بناء الدولة وأنتج نظاماً طائفياً في لبنان في حقبة ما بعد الاستعمار، وأعيد إنتاجه في وقتٍ لاحق في حقبة ما بعد الحرب. تضمّنت هذه العملية النخب السياسية التي فرضت على النظام السياسي الجديد صورة مجتمع يتألّف من جماعات طائفية «متجانسة داخلياً ومغلقة خارجياً»20 من أجل تبرير تقاسم السلطة التوافقية وكذريعة للاستئثار بمؤسّسات الدولة ومواردها. يكشف هذا المنهج الجينيالوجي عن أن الفرض المتعمّد للتوافقية من النخبة في خلال السنوات التأسيسية للدولة في حقبة الاستعمار الفرنسي ربّما لم يكن جديداً من نوعه، لكنّه لم يكن بالتأكيد البديل السياسي الوحيد المُتاح. علاوة على ذلك، وكما تؤكّد المقاربات التي تشدّد على الفاعلية السياسية (political agency) عند المنعطفات الحاسمة،21 بما فيها المقاربة المؤسّساتية التاريخية22 ومقاربة تشكيل الدولة المقارنة،23 فإن الخيارات المتّخذة في المراحل الأولى من تشكيل الدولة حدّدت النتائج السياسية المستقبلية بطريقة لا رجعة فيها، آسرةً الهوية السياسية والتعبئة السياسية في دوافع ومحفّزات طائفية.
إن دراسة المنعطفات الحاسمة في تشكيل الدولة في لبنان تبرز آثار الاختلافات في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية على أشكال الدولة والمسارات السياسية فيها سواء في الحالات الأوروبية الأصلية أو السياقات ما بعد الكولونيالية. في الحالات الأوروبية، أدّى تزامن تشكيل الدولة وبنائها قبل الاعتماد الرسمي للتوافقية إلى خلق مسار تاريخي بدأ من ظهور شكل من أشكال التشابك وسياسة التوافق، تبعه ظهور مؤسّسات بيروقراطية حديثة قوية، ثمّ اعتماد ترتيبات رسمية لتقاسم السلطة ترتكز على مبدأ المواطنة الديمقراطية المتساوية. في لبنان، وعلى النقيض من ذلك، أدّى تبني التوافقية في مرحلة تشكيل للدولة في ظل الاستعمار الفرنسي إلى خلق مسار عكسي: انطوى على البناء المتعمّد لصورة مجتمع مقسّم إلى جماعات طائفية متجانسة مغلقة، سمحت للنخب السياسية باستغلال التوافقية لتعزيز الاستيلاء على الدولة في فترة ما بعد الاستعمار وتبريره، ما حال دون بناء الدولة وظهور دولة المواطنة.
الفرض المتعمّد للتوافقية من النخبة في خلال السنوات التأسيسية للدولة في حقبة الاستعمار الفرنسي ربّما لم يكن جديداً من نوعه، لكنّه لم يكن بالتأكيد البديل السياسي الوحيد المُتاح
يمكن استخلاص آثار هذا الاختلاف في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية من مقارنة المسار في سويسرا ولبنان. وكما يقول مارك فرحة، «لقد تحقّق الاستقلال الكامل والتوحيد الوطني تحت رعاية دولة حديثة في سويسرا في العام 1848 قبل زهاء قرن من الاستقلال اللبناني».24 وقد أدّى هذا بدوره إلى ظهور اختلافات صارخة في «الشكل المؤسّسي للتحالفات السياسية»25 بين الدولة ومواطنيها. في سويسرا، سبقت شبكات منظّمات المجتمع المدني القويّة العابرة للمناطق والمتعدّدة الاثنيات الانتقال إلى الدولة القومية26 وبناء المؤسّسات البيروقراطية الحديثة.27 واستغلت النخبة الليبرالية التي جاءت إلى السلطة بعد العام 1848 هذه الشبكات لتجنيد الأتباع والقادة فيما أصبح لاحقاً «بنية سياسية جامعة وعابرة للأعراق».28 هذا الشكل المؤسّسي الأفقي للمجتمع والدولة من أجل بناء التحالفات السياسية سبق أي ترتيب رسمي لتقاسم السلطة بين الجماعات العرقية اللغوية المختلفة29 وأثبت فعاليته في بناء الدولة، وبالتالي في الانحسار اللاحق للهويات الطائفية واللغوية والإثنية.30 على النقيض من ذلك، إن إقامة التوافقية في أثناء تشكيل الدولة في لبنان31 خدمت شكلاً عمودياً من المحسوبية في بناء التحالفات السياسية مما أعاق بناء الدولة: شبكات محسوبية طائفية داخل، وليس عبر، الجماعات الطائفية رابطةً النخبة السياسية الطائفية بأتباعها. إن اختلاف هذا التسلسل في سويسرا قاد إلى بناء سلطة مؤسّسية قوية للدولة مقارنة بلبنان. والتعبير الأفضل عن نتائج هذا الاختلاف في التسلسل هو اعتماد سويسرا قانوناً مدنياً للأحوال الشخصية عابر للطوائف32 مقابل اعتماد لبنان قوانين أحوال شخصية خاصة بكلّ طائفة، ما أنتج رعايا طائفيين.33
هذه الاختلافات في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية تفسِّر السبب في أن الحزمة التوافقية أتاحت إمكانية إنهاء الفصل العمودي للمجتمع، وبناء المؤسّسات، والمحاسبة، والتنافس الاثني، والتخلّي عن التوافق كلياً في بعض السياقات، بينما أدّت في سياقات أخرى إلى تفاقم الانقسامات القائمة، وسمحت بالسيطرة على الدولة، وشجّعت على الفساد المنهجي، وقوّضت سيادة القانون، وتماسك مؤسّسات الدولة وقدراتها.34 كما أن إزاحة أشكال الدولة وتتبع الآثار المختلفة التي يمكن أن تحدثها الترتيبات التوافقية في الدولة بعد جلاء الاستعمار، تجنِّبنا الاختيار الثنائي بين الرفض الكلّي35 أو التأييد التام36 لفائدة التقاسم التوافقي للسلطة في سياقات ما بعد الحرب. فإذا كان «السياق مهمّاً عند البحث عن التسويات التوافقية»37 كما تقول أليسون ماكولوك، فمن المؤكّد أن الشكل المُحدِّد للدولة الذي يجب أن تمرّ من خلاله السمات المؤسّسية للتوافقية التي تحفّز النتائج السياسية هو السياق الرئيس.
كما تكشف هذه الطريقة في دراسة كيفية تفاعل أشكال الدولة المختلفة مع الحزمة التوافقية عن الافتراضات الضمنية التي وصلت إليها أدبيّات تقاسم السلطة عن الدولة. وقد جادل بريندان أوليري بأنه «هناك حاجة لوجود بعض مظاهر الدولة أو القدرة على الحكم لتنجح وصفة تقاسم السلطة في الأماكن المنقسمة بشدّة».38 ولكن عن أي أشكال دولة نتحدّث، وأيها الأهم على وجه التحديد لنجاح التقاسم التوافقي للسلطة؟ يلخّص أوليري عناصر وجود الدولة، أو عدم وجودها، في تمييز بين الدول «الفاعلة» والدول «الفاشلة»:
«تتميز الدول الفاعلة بوجود مؤسّسات غير مشخصنة تتمتع بدرجةٍ من المركزية وتحكم عملية اتخاذ القرارات وفق إجراءات معيّنة. ولديها الإمكانات القسرية لضمان الأمن: يمكنها تنظيم جميع أدوات العنف العام المحتمل ومنع إداراتها من التحوّل إلى إدارات ناهبة. وهي تعبّر عن سلطة قانونية حقيقية على الأشخاص والممتلكات وحركتهما، ويعترف بها مواطنوها ومنظّمات المجتمع المدني والدول الأخرى. ويمكنها الدفاع عن نفسها بالاعتماد على نفسها أو من خلال إقامة التحالفات. وأخيراً، تُعرف الدول الفاعلة من خلال سيادتها المعترف بها على أراضيها والصلاحيات المصاحبة لها: السيطرة على دخول الأشخاص والكيانات وخروجهما. […] في المقابل، الدول الفاشلة مشخصنة: يسيطر عليها الحكّام أو الأسرة أو العشيرة أو الطغمة، وهذه الفئات لا تميّز بين الفضاء العام والخاص. تتحوّل هذه الدول إلى «الكليبتوقراطية»، حكومة لصوص، قبل أو في أثناء انهيار أنظمتها. فهي تفتقر إلى الأنماط المتناسقة والمؤسسية المحكومة بالقانون التي تمنع النهب. و«حكّامها» لصوص بالفعل. وعادة ما تكون هذه الدول قد فقدت احتكار تنظيم العنف وتواجه تحدّيات من العصابات والجماعات المسلّحة والإرهابيين والمافيا؛ وقد تتعرّض للغزو والنهب والاحتلال من دول أخرى. وهي لا تضع القوانين ولا تفرضها. وأولئك الذين فشلت هذه الدول في حكمهم يحتقرونها بقدر ما يخافونها».39
علاوة على ذلك، وفي دراسة سابقة عن «الاستراتيجيات الإثنو-قومية للدول الصناعية وتلك في طور التصنيع»، يعمل «مديرو الدولة» ضمن حدود نوع معيّن من شكل الدولة: إنه شكل «تكون بموجبه قبضة الدولة ومؤسّساتها المعنية باستخراج الموارد وصنع السياسات ذات قدرة متساوية وموحّدة ضمن حدودها الجغرافية».40
أدّى تبني التوافقية في مرحلة تشكيل للدولة في ظل الاستعمار الفرنسي إلى خلق مسار عكسي: انطوى على البناء المتعمّد لصورة مجتمع مقسّم إلى جماعات طائفية متجانسة مغلقة، ما حال دون بناء الدولة وظهور دولة المواطنة.
لكن ماذا لو أصبحت التوافقية، كما تقترح هذه الورقة، ذريعة لتبرير استيلاء النخبة على مؤسّسات الدولة ومواردها، وبالتالي كبح نشوء مظاهر الدولة والقدرة على الحكم التي وضعها أوليري كشروط مُسبقة لنجاح تقاسم السلطة؟ هذه الصورة عن «الدولة الفاعلة» مع «مؤسّسات غير مشخصنة» و«مديرو دولة» فاعلين يمكنهم إدارة الاختلافات العرقية بقبضة مُحكمة، تنتمي إلى شكل الدولة المؤسّساتية الفيبرية باحتكارها للعنف والقدرات الاستخراجية والتدخلية التي تمارس من خلال بيروقراطية مركزية وعقلانية ومستقلة، أكثر من انتمائها إلى أشكال الدولة التي تجدها في جميع أنحاء الجنوب العالمي، سواء في المراحل ما بعد الكولونيالية أو بعد الحرب.41
لقد اعترفت الأبحاث الحديثة عن التقاسم التوافقي للسلطة بهذه الفجوة المؤسّسية في الصياغة الأصلية للنظرية. فقد أعاد جون ماكغاري النظر في العوامل التي تساعد على الأداء التوافقي عند أريند ليبهارت.42 فإضافة إلى الآليّات المؤسّسية السياسية الأربع المذكورة أعلاه، اعتبر ليبهارت أن حجم الدولة ووجود عدو مشترك من العوامل التيسيرية الأخرى، إلى جانب تقليد من التوافق ما قبل الديمقراطي والتوازن الديموغرافي للقوى. ويجد ماكغاري43 أن عوامل ليبهارت الأصلية لقياس نجاح واستقرار إمكانات تقاسم السلطة التوافقي لا يمكن أن تفسِّر الحالات غير الكلاسيكية اللاحقة ما لم يُنظر في ثلاثة أبعاد إضافية: البُعد الخارجي، والأمن، وحق تقرير المصير. وبالتالي، يعتمد الأداء التوافقي أيضاً على العوامل الجيوسياسية المتساهلة والتوازنات غير الديمغرافية للقوى، فضلاً عن اعتماد تصاميم مؤسّسية جديدة لمعالجة مطالبات تقرير المصير والمخاوف الأمنية لمختلف المجموعات الإثنية.
على الرغم من أن ماكغاري يحوِّل تركيز ليبهارت بعيداً من النظر إلى حجم الدولة، أو إلى القواعد المؤسسية السياسية التي تحكم التوافقية، مُدرِجاً الترتيبات الأمنية للدولة في قائمة الأسس المؤسسية التي تساعد على الأداء التوافقي الناجح، فإنه لا يأخذ في الاعتبار أشكال الدولة المختلفة التي تعمل فيها هذه الترتيبات الأمنية الجديدة: سواء كانت دولاً ذات مؤسّسات فاعلة ومتماسكة ومستقلة، أو دول ما بعد استعمارية حيث بناء الدولة مُتعثِّر، أو دول خارجة من حرب حيث تكون المؤسّسات مهيّئة للاستيلاء عليها من عدد لا يحصى من الجهات الفاعلة. وبالتالي، إذا كانت الدولة وتلك «المؤسّسات غير المشخصنة التي تتمتّع بدرجةٍ من المركزية وتحكم عملية اتخاذ القرارات وفق إجراءات معيّنة» ضرورية لأداء تقاسم السلطة، فماذا يحدث عندما تُستَغَل التوافقية للسيطرة على الدولة ومواردها ومنع بناء الدولة؟ في العديد من الدراسات والمقالات، أظهر توبي دودج كيف نجح فرض تقاسم السلطة في العراق بعد العام 2003 في توحيد النخبة العرقية-الطائفية، إنما «على حساب مؤسّسات الدولة المتماسكة والفاعلة».44 وفي هذه الحالة، كانت الدولة وإمكاناتها المؤسسية قبل الغزو ضحية مباشرة لتقاسم السلطة التوافقي.
في هذه الورقة، أتتبّع كيف أن تبني التوافقية في لبنان في خلال التشكيل الاستعماري للدولة استلزم عمداً فرض صورة مجتمع مقسَّم بشكل رئيسي إلى جماعات طائفية متجانسة ومغلقة، مع محو أنواع أخرى من الانقسامات في الوقت نفسه. باستخدام مجموعة من المصادر العربية والغربية المستندة على مواد أرشيفية، أعيد النظر في المنعطفات الحاسمة لتشكيل الدولة الاستعمارية لإعادة خلق السياقات التاريخية والفكرية التي تسمح بفرض هذا التصوّر الطائفي. بدورها، مكَّنت التوافقية من الاستيلاء على مؤسّسات وموارد دولة ما بعد الاستعمار من قبل نخب سياسية واقتصادية قديمة وجديدة. وتسبّب هذا الاستيلاء في كبح بناء الدولة وتمييز الهويات الطائفية على غيرها من الهويات الأخرى. أما في فترة بعد الحرب، أعاد قادة الميليشيات السابقون والنخب السياسية الاقتصادية الجديدة تدوير تقاسم السلطة التوافقي ليستولوا على الدولة. أستخدم بيانات أولية جُمِعت من حسابات وزارة المالية لأوضح إمبريقياً كيف استخدمت هذه النخبُ الاقتصاد السياسي للدولة لتعيد إنتاج توافقية ما بعد الحرب على حساب الدولة وعلى حساب ظهور أشكال سياسية وتنظيمية بديلة تتجاوز الطائفية. وتوضح الخاتمة المضامين الأوسع لحجتي فيما يتعلّق باحتمالات إلغاء الطائفية، ومناقشات تقاسم السلطة، والدراسة المقارنة لأشكال الدولة ما بعد الاستعمارية.
تبرير التوافقية للسطو على دولة ما بعد الاستعمار
كان فرض التجزئة على نظام الحكم الجديد في لبنان الكبير الذي أنشأته فرنسا في العام 1920 عملية متعمّدة وتدرّجية. ولم تكن الأولى في التاريخ لكنها لم تكن حتمية، وظهرت على خلفية محاولات متعدّدة، في سوريا والعراق، للحدّ من الانقسامات العرقية-الطائفية في النظام الناشئ بعد انهيار السلطنة العثمانية.45 ويحدّد ألبرت حوراني «التجسيد الأول للمبدأ الطائفي»46 أو تقسيم الحكم السياسي على أسس طائفية، في نظام القائمقامية الذي تأسّس في جبل لبنان في الأول من كانون الثاني/يناير 1843، مع منطقة شمالية يديرها قائمقام ماروني ومنطقة جنوبية يديرها قائمقام درزي. وقد نصّ على تشكيل مجلس منتخب من اثني عشر عضواً يمثّلون الجماعات الدينية المختلفة لتقديم المشورة والمساعدة لقائمقام كل منطقة. وتكوّن كلّ مجلس من نائب لقائمقام المنطقة من نفس طائفة هذا الأخير، بالإضافة إلى قاضٍ ومحتسب ضرائب من كل طائفة من الطوائف الست المقيمة في جبل لبنان: الموارنة والدروز والروم الأرثوذكس والكاثوليك والسنة والشيعة - ويتشارك السنة والشيعة القاضي نفسه.47 وتشير كارول حكيم إلى أن النظام الجديد «أدخل رسمياً للمرّة الأولى العامل الطائفي على المستويين السياسي والمؤسّسي»، وأطلق في جبل لبنان «عملية البلورة الطائفية وإعادة التجمّع الطائفي»، والتي «تكشفت ببطء وبطريقة متباينة وغير متسقة»، بالنظر إلى أن جبل لبنان كان «يعاني من العديد من الانقسامات الاجتماعية والسياسية الأفقية والعمودية»48 التي تشكّل مشهده الاجتماعي والاقتصادي. بيد أن مسار هذا النظام الجديد، والأهمّ من نظام المتصرفية الذي رسّي بين عامي 1861-1914 في جبل لبنان واستند إلى حكم طائفي صارخ أدرِج في القانون الأساسي49 الذي وضع في 9 حزيران/يونيو 1861، إلى لبنان الكبير الذي أنشأته فرنسا لم يكن حتمياً،50 وكذلك لم يكن الكيان السياسي الجديد مؤلفاً من جماعات طائفية متجانسة ومنقسمة بدقة. فالأول كان مدفوعاً بالدرجة الأولى بعزم فرنسا على تقويض وعزل أي معارضة لانتدابها في سوريا،51 أما الثاني فكان نتيجة إعادة تصوّر النخبة للدولة الجديدة ومجتمعها على أنهما «فسيفساء متعدّدة الألوان من الكتل [الطائفية] الأحادية اللون»52 تحت ستار التوافقية.53
ما سُوِّق في كثير من الأحيان على أنه «صراعات بين الطوائف كان يعكس في كثير من الأحيان الصراع على السلطة بين النخب من أجل الوصول إلى مؤسّسة الدولة والثروة»
في أثناء سنوات الانتداب الفرنسي، عندما كان النظام السياسي لا يزال قيد البناء، ادّعت النخب السياسية القديمة والجديدة أنها تمثِّل جماعات طائفية متجانسة لتبرير تبنّي ترتيب توافقي، استخدمته للسيطرة على مؤسّسات الدولة الجديدة ومواردها. ما سُوِّق في كثير من الأحيان على أنه «صراعات بين الطوائف كان يعكس في كثير من الأحيان الصراع على السلطة بين النخب من أجل الوصول إلى مؤسّسة الدولة والثروة».54 استغلت النخبة السياسية الاقتصادية المارونية التي نشأت في ظل الانتداب وصولها إلى مناصب الدولة ومواردها «لتعزِّز مصالحها ومصالح عائلاتها».55 ولكن الاندماج في جهاز الدولة بعد الاستقلال استُغِل أيضاً لمنح الكيان الجديد تأييد ودعم النخب الإقطاعية القديمة من قلب الجبل ومن الأطراف التي ضمّت إليه، فضلاً عن الأسر السنّية البارزة من بيروت وصيدا وطرابلس. «إن نجاح النخب القديمة والجديدة على حدّ سواء في تعزيز سيطرتها على الدولة، تطوّر بسبب السياسة الفرنسية من جانب وبسبب قدرة هذه النخب على تصوير نفسها في صورة الوصي على حقوق طوائفها من جانب آخر».56 لكن هذا الدور الأخير تطلّب قدراً كبيراً من التخيّل الاجتماعي.
وكما يجادل أسامة مقدسي، فمن أجل خلق صورة مجتمع منقسم إلى طوائف متجانسة، «عمدت النخب السياسية ببراعة إلى تكريس لغة صريحة عن العيش المشترك بين الطوائف وأسقطت حقوق الأفراد العلمانيين وتجاهلت الواقع العنيف المتمثِّل في التفاوتات الجغرافية والطبقية والجندرية داخل الطوائف وفيما بينها».57 كان هذا جزءاً من عملية تدرّجية من هندسة «الجماعة»58 حيث أعيد تصوير الهويات المعقّدة والمتغيّرة والمتداخلة في صورة أشكال متجانسة، واستلزم ذلك تقديم الطوائف المنقسمة داخلياً على أنها متجانسة سياسياً واجتماعياً واقتصادياً. والعملية التي صيغَت من خلالها هذه الصورة عن المجتمع المنقسم كانت مرتبطة عضوياً بـ «فكرة لبنان كنموذج للتعايش المسيحي والإسلامي» التي روِّجت لها النخبة الثقافية والمهنية والتجارية آنذاك، وهي صورة «دولة تتعايش فيها الديانتين والجماعات المتنوّعة بانسجام في إطار نظام حكم برلماني ديمقراطي ليبرالي».59 وعند مقارنتها بأفكار سابقة منغلقة أكثر ومُتجذِّرة في تجربة جبل لبنان، فإن هذه «الفكرة الحضرية عن لبنان»، في وصف حوراني المعبّر، «لم تكن لمجتمع منعزل عن العالم الخارجي، ولا لمجتمع موحّد تذوب فيه الطوائف الأصغر، بل كانت أمراً بين الاثنين: مجتمع تعدّدي تتعايش فيه الطوائف في إطار مشترك ولكن تبقى مختلفة على مستوى الولاءات الدينية الموروثة والروابط الأسرية».60 إن صناعة هذه الصورة لمجتمع تعدّدي مقسَّم إلى طوائف منغلقة متجانسة استلزمت ارتكاب أعمال عنفية مؤثِّرة ضد تاريخ وواقع النظام السياسي الوليد. وتضمّن ذلك القفز عن حقيقة «أن الطوائف ليست، خارج حدود معيّنة، كيانات صلبة وراسخة لها مصلحة واحدة أو موقف واحد، وعن أن الانقسام إلى مجتمعات دينية ليس التقسيم الوحيد الممكن لسكّان لبنان، وفي بعض النواحي قد لا يكون الأهم»، كما يشدّد حوراني61 لاحقاً في مقال يعتمد المقاربة الاسترجاعية. بيد أن ارتكاب هذا العنف كان ضرورياً لتبرير تقاسم السلطة التوافقي بين الجماعات الطائفية، وهي استراتيجية سياسية استخدمت كذريعة من أجل استيلاء النخبة على الدولة.
لم تؤدِ أي شخصية دوراً أكثر حسماً في إعادة التصوير هذه من دور التاجر والمصرفي والمنظّر السياسي ميشال شيحا (1891-1954)، المثقّف العضوي في الطبقة البرجوازية المالية التجارية الصاعدة.62 نظّر شيحا للبنانيين على أنهم، بحكم التاريخ والجغرافيا، مجموعة من «الأقلّيات الطائفية المتشاركة»،63 ويجب أن يُدار تنوّعهم كمجموعات طائفية بشكل دائم، ولا يمكن تمثيلهم إلّا على نحو غير مباشر من خلال طوائفهم.64 وتستنتج ميشيل هارتمان وأليساندرو أولساريتي65 في دراسة سياقية دقيقة لكتابات شيحا، أنه بالطريقة نفسها التي ابتكر فيها جذور لبنان الفينيقية المتخيّلة من أجل إضفاء الشرعية على «الجمهورية التجارية»66 والمصالح المادية للبرجوازية المالية والتجارية التي يمثّلها، كان هوس شيحا بفكرة لبنان كملاذ للأقليات المضطهدة جزءاً من مخزون يبتكر صورة لدولة تشكِّل الطائفية سببَ وجودها الوحيد،67 و«تقدّم مبرراً لنظام الحكم الطائفي وترتيبات تقاسم السلطة داخله بين نخب الجماعات الدينية المختلفة».68 ويتجلّى هذا بوضوح في الطريقة التي نظّر بها شيخا لدور البرلمان المحدود للغاية.
أصرّ شيحا على أن بلد الأقليات الطائفية لا يمكنه «البقاء سياسياً على المدى الطويل من دون وجود برلمان»،69 يكون موقعاً يجتمع فيه ممثّلو النخبة «ويؤكّدون الرغبة في العيش معاً».70 ومع ذلك، كان لهذا البرلمان دور محدّد: مكان تجتمع فيه النخب الممثّلة للطوائف والمناطق من أجل ضمان السلام والتعايش بين المجموعات، وليس موقعاً لمساءلة السلطة التنفيذية أمام المواطنين من خلال ممثّليهم المنتخبين.71 وكما قال غسان تويني في وقت لاحق نقلاً عن شيحا نفسه، فمن الأفضل أن «يكون برلماناً تلتقي الطوائف تحت قبته حتى ولو للقتال [فيما بينها] بدلاً من القتال خارج البرلمان، في الشارع، في ظل الكنيسة والمسجد».72 وفي نظام سياسي مبني على شراكة بين برجوازية تجارية ومالية مسيحية صاعدة ونخبة طائفية ومناطقية راسخة، لم يكن دور البرلمان التمثيل بل ضمان السيطرة الاجتماعية على حساب الحقوق الاجتماعية والاقتصادية.73 وفي المقابل، تم تنظيم بنية تحتية مؤسّسية قويّة من أجل مأسسة العلاقات وتنظيمها بين «الأقليات الطائفية المتشاركة»، الركائز الجديدة للبنان.
إن نجاح النخب القديمة والجديدة على حدّ سواء في تعزيز سيطرتها على الدولة، تطوّر بسبب السياسة الفرنسية من جانب وبسبب قدرة هذه النخب على تصوير نفسها في صورة الوصي على حقوق طوائفها من جانب آخر
بدأ العمل بالمرسوم رقم 1307 الصادر في 10 آذار/مارس 1922 لتحويل ما كان تشكيلات اجتماعية مرنة ومتداخلة إلى «كيانات صلبة» أو «تكتلات»، عندما أنشأت سلطة الانتداب «مجلساً تمثيلياً من ثلاثين عضواً منتخباً قوامه ستة عشر مسيحياً وثلاثة عشر مسلماً، بالإضافة إلى عضو واحد عن الأقليات [بروتستانتي]»، وبذلك أدخلت معادلة 6 و5 مكرّر المحاصصة بين الطوائف، أي 6 مسيحيين لقاء 5 مسلمين، في الدولة الناشئة.74 وتمّ تأكيد هذا النهج التمثيلي في دستور العام 1926، إذ كرّست صياغة نصّه الجماعات الطائفية المتجانسة كركائز أساسية للمجتمع اللبناني. اعتمدت هذه الاستراتيجية من غالبية واضعي الدستور، ومن شيحا بالتحديد،75 لتبرير صورة لبنان المنقسم التي أرادوا فرضها على المجتمع.76 وعلاوة على ذلك، يرى فوّاز طرابلسي أن شيحا تعمّد قمع أي محاولة لنقل بنود تكرّس مبادئ «المساواة السياسية والقانونية بين المواطنين من دستور الجمهورية الفرنسية الثالثة إلى دستور العام 1926».77 وتحت قناع الإصرار على أن «حرية الاعتقاد مطلقة»، شرّعت المادة 9 من الدستور تأسيس سلطة النظام الطائفي: ألزمت الدولة بـ«تأدية فروض الإجلال لله تعالى» واحترام «جميع الأديان والمذاهب»، وضمان «حرية إقامة الشعائر الدينية تحت حمايتها على أن لا يكون في ذلك إخلال في النظام العام. وهي تضمن أيضاً للأهلين على اختلاف مللهم احترام نظام الأحوال الشخصية والمصالح الدينية».78 بيد أن الباحث الدستوري إدمون ربّاط79 اعتبر أن مُفتَتح المادة 9 غطاءً لدسّ النظام الطائفي في نصّ الدستور. إلى جانب المادة 10 التي تضمن حقّ جميع الطوائف في امتلاك مدارسها الخاصة، منحت المادة 9 الجماعات الطائفية استقلالية كبيرة قطاعياً وغير محصورة مناطقياً في إدارة شؤونها الخاصة. غير أن ما رسّخ الطائفية السياسية عبر مؤسّسات الدولة هي المادة 95 الشائنة.
«التماساً للعدل والوفاق وبصورة مؤقتة»، نصّت المادة 95 على تمثيل «الطوائف بصورة عادلة في الوظائف العامّة وبتشكيل الوزارة من دون أن يؤول ذلك إلى الإضرار بمصلحة الدولة».80 أحد أسباب سنّ هذه المادة كان معالجة مخاوف النخبة المسلمة من الهيمنة المسيحية على مناصب الدولة في ظل الانتداب الفرنسي،81 وهذه الهيمنة أتت نتيجة ميل سلطات الانتداب إلى تجنيد كوادر فرانكفونية محلّية موالية.82 كانت المادة 95 السمةَ المؤسسية التوافقية التي كشفت مؤسّسات الدولة ومواردها على سيطرة النخبة باسم المحاصصة الطائفية. وقد تعزّز ذلك في الرسائل المتبادلة بين الرئيس إميل إده (1936-1941) والمفوّض السامي الفرنسي الكونت داميان دي مارتل (1933-1939) عشية توقيع المعاهدة الفرنسية اللبنانية لعام 1936. في الملحق السادس، تعهّد إده أن تضمن الحكومة «المساواة في الحقوق المدنية والسياسية بين جميع المواطنين من دون أي تمييز بينهم»، وأنها «مستعدّة أيضاً لتأمين التمثيل العادل لمختلف الجماعات في البلاد في وظائف الدولة»، وأن النفقات العامة «ستتوزّع بعدالة بين مختلف المناطق».83
المرحلة التالية في عملية إنشاء الجماعات الطائفية المغلقة من الواقع الاجتماعي-الاقتصادي والسياسي المتنوّع للدولة الوليدة جاء في شكل سلسلة من المراسيم تعترف رسمياً بالأحوال الشخصية لـ«كل طائفة… وبالتالي تضمن لجميع الطوائف الدينية في لبنان حقّها في السيادة على قانون الأحوال الشخصية الخاص بها».84 وقد حدث ذلك غداة محاولتين فاشلتين قادتهما السلطات الانتدابية الفرنسية، في عامي 1924 و1926، لإخضاع معظم مسائل الأحوال الشخصية، باستثناء تلك المتعلّقة بالزواج، لاختصاص المحاكم المدنية وليس الدينية.85 وقد ابتدأت هذه العملية بموجب المرسوم 60/LR الصادر في 13 آذار/مارس 1936، وتلاه المرسوم 164/LR الصادر في 18 تشرين الثاني/نوفمبر 1938. وعلى الرغم من أن المعارضة الإسلامية للمرسوم 60/LR سرعان ما أجبرت سلطة الانتداب على استبعادهم من اختصاصه القضائي، استكمل هذا المسار بعد الاستقلال مع صدور القانون رقم 18 في 13 كانون الثاني/يناير 1955، الذي اعترف للطائفة السنية بسيادتها على شؤونها الدينية والإدارية والمالية، وألحق بقانونين آخرين صدرا في 31 تموز/يوليو 1962 واعترفا للطائفة الدرزية بالأمر نفسه، ومن ثمّ بالقانون رقم 72/67 الصادر في 19 كانون الأول/ديسمبر 1967 الذي منح الطائفة الشيعية صلاحيات مماثلة. رفعت هذه المراسيم، بمجملها، «الجماعات» الطائفية المصطنعة إلى مرتبة «الكيانات السياسية» المستقلّة، كما لفت رباط بنباهة.86 ووجدت هذه القوانين والمراسيم البنية البيوسياسية «للتطييف الكامل»87 للشعب اللبناني وتقسيمه إلى جماعات طائفية متجانسة شكّلت «البنية التحتية»88 للدولة اللبنانية، جماعات تحتاج إلى إدارة دائمة من جانب النخبة.
وقد استخدمت النخبة السياسية، الطائفية سلاحاً، من أجل بناء صورة مجتمع مقسّم تبرّر الاستيلاء على وظائف الدولة والموارد تحت ستار إدارة هذا التنوّع من خلال التوافقية. وبذلك خلقوا مشكلة كانت التوافقية حلّها المثالي.89 لم يعبّر شيء عن ذلك أكثر من الميثاق الوطني لعام 1943. بصياغته المصبوغة بلغة التسويات والتعايش بين ما وصف بـ«الجماعات الروحية المتعدّدة التي يتألّف منها الشعب اللبناني»90 - بعبارات رياض الصلح في البيان الوزاري لأول حكومة تشكّل بعد استقلال لبنان في 7 تشرين الأول/أكتوبر 1943 - عمل هذا الميثاق على ترسيخ الطائفية المحفّز الرئيسي للهوية والتعبئة السياسية، وتبرير استيلاء النخبة على وظائف الدولة ومواردها باسم «موازنة المصالح بين الطوائف المختلفة».91 وفّرت فلسفة شيحا السياسية الخطاب والمتخيلات92 اللذين وطّدا التحالف بين الزعامات الطائفية والمناطقية القديمة وبين البرجوازية المالية والتجارية الصاعدة في سياق التفوّق السياسي المسيحي وتحديداً الماروني.93 سهّل هذا للنخب القديمة وصول شبكات المحسوبية الخاصة بها إلى وظائف الدولة ومواردها، فيما مارست السيطرة الاجتماعية التي قمعت المطالب الاجتماعية الاقتصادية الشعبية، وسمحت بتمرير سياسات التحرير الاقتصادي المتطرّفة، وكلا الأمرين خدَما المصالح المادية للبرجوازية المالية التجارية.94 كانت لغة الجماعات هذه عصية على الزمن، فقد عاودت الظهور في فترة ما بعد الحرب تحت مسمى المكوّنات الوطنية. كما عملت أيضاً على تفكيك الوعي الطبقي وإخفاء المصالح المادية التي تربط النخبة الاقتصادية السياسية معاً.
كان هوس شيحا بفكرة لبنان كملاذ للأقليات المضطهدة جزءاً من مخزون يبتكر صورة لدولة تشكِّل الطائفية سببَ وجودها الوحيد، و«تقدّم مبرراً لنظام الحكم الطائفي وترتيبات تقاسم السلطة داخله بين نخب الجماعات الدينية المختلفة»
ينتقل القسم التالي إلى فترة ما بعد الحرب، ويبيّن كيف نهبت النخبة الاقتصادية السياسية في فترة ما بعد الحرب وظائف الدولة ومواردها بموجب ترتيب توافقي أُعيد تشكيله. وقد فعلت ذلك من خلال تنظيم اقتصاد سياسي ما بعد الحرب هدف إلى منع ظهور أشكال سياسية وتنظيمية بديلة تتجاوز الطائفية، وهو الذي أضعفَ فرص بناء الدولة بعد الحرب.
التوافقية ودولة ما بعد الحرب
في كتاباته إبان السنوات الأخيرة للحرب الأهلية، خلص مايكل هدسون إلى أن كلاً من النموذجين الليبرالي التوافقي (1943-1958 و1970-1975) والشهابي (1958-1970) - وهو نموذج تمكّن من الانخراط في عملية بناء الدولة لأنه علّق العمل بالتوافقية95 - فشل في تحقيق «التوليف بين تقاسم السلطة وتركُّزها الذي يحتاج إليه لبنان».96 تبع هذا الفشل المزدوج، نموذج اللادولة97 في فترة الحرب الأهلية (1975-1990)، وقد شهد لبنان بحلول منتصف الثمانينيات «تفتت الدولة»98 أو السحق المطلق للدولة ومؤسّساتها. فما هو تأثير الترتيب التوافقي الجديد على دولة ما بعد الحرب؟
أعاد اتفاق الطائف لعام 1989 إنتاج النظام التوافقي الذي ساد في فترة ما قبل الحرب ولكن في اتجاه أكثر توازناً.99 أبقِي على الشروط الرسمية لنموذج ما قبل الحرب فيما يتعلّق بتكريس الاستقلالية الثقافية والمحاصصة التي اتخذت شكلاً متكافئاً بين المسلمين والمسيحيين وتمدّدت عبر القطاع العام بأكمله على الرغم من أن الفقرة ب من المادة 95 من الدستور حصرت الكوتا الطائفية بوظائف الفئة الأولى. إلى ذلك، كرّست المادة 65 من الدستور حقّ النقض المُتبادل المتمثّل بالتهديد بالمقاطعة واستخدام العنف الذي ساد بشكل غير رسمي قبل إصلاحات الطائف الدستورية،100 وقد أوردت مقدّمة الدستور أن «لا شرعية لأي سلطة تناقض ميثاق العيش المشترك».101 بالطبع، يُعدّ «ميثاق العيش المشترك» بين الجماعات الطائفية التجسيد الراهني «للرغبة في العيش معاً» التي عبّر عنها شيحا. علاوة على ذلك، جُرِّدت الرئاسة المارونية من صلاحيّاتها التنفيذية وحوّلت إلى مجلس الوزراء مجتمعاً. وبالنتيجة، أُضفِي الطابع الرسمي جزئياً على الدور التقليدي لمجلس الوزراء كائتلاف توافقي كبير. نظّمت أعمال الحكومة بموجب أحكام المادة 65 من الدستور، التي لم يتمّ الركون إليها إلّا بعد انسحاب الجيش السوري من لبنان في العام 2005، وقد أدّت إلى إطالة فترات تشكيل الحكومة واتباع العديد من الحيل السياسية لضمان عدم حصول أي حزب سياسي أو ائتلاف على ثلث الأصوات المعطّل. ومع بعض الاستثناءات، أصبحت حكومات الوحدة الوطنية التي تتسمّ بالتعطيل هي القاعدة بعد العام 2005.
إن التكريس الدستوري للتوافقية في فترة ما بعد الحرب كشف مؤسّسات الدولة على النخبة الاقتصادية والسياسية،102 فاستولت عليها بالكامل وحوّلتها إلى أرخبيل من الشبكات الزبائنية التي يعمل بها أنصارها، وقد انبثق عنها دولة المحاصصة.103 فالممارسة الأكثر انسجاماً مع النظرية التوافقية سمحت لنخبة ما بعد الحرب بالإفلات من المساءلة إثر توسيع نفوذها إلى عمق قطاعات الدولة البيروقراطية والأمنية والقضائية. وهنا تكمن مفارقة تقاسم السلطة في مرحلة ما بعد الطائف: إن نجاح التوافقية «في الحفاظ على تماسك»104 لبنان ما بعد الحرب جاء على حساب تماسك الدولة وقدراتها المؤسّسية والسياسات المالية والنقدية السليمة، ما أدّى في النهاية إلى انهيار البنى المالية والنقدية والاجتماعية-الاقتصادية بأكملها.
سمحت السيطرة على السياسات المالية والنقدية، التي ترافقت مع الاستيلاء على مؤسّسات الدولة، للنخبة السياسية الطائفية بتكوين اقتصاد سياسي طائفي داخل مؤسّسات الدولة وخارجها وفّر «أسس التراضي المادية» لقطاعات اجتماعية كبيرة
يبيِّن سجل تقاسم السلطة التوافقي في لبنان أنه عمل على تشويه الأنماط البديلة للهوية السياسية105 والتنظيمية.106 وعلى الرغم من التفاوتات الاقتصادية الصارخة التي تؤثّر على الفقراء والمحرومين، ساهم تقاسم السلطة التوافقي في إخفاء الفوارق الطبقية داخل الطوائف وفيما بينها،107 سواء في سنوات ما قبل الحرب أو بعدها، من خلال تحفيز نوع محدّد من السياسات على حساب أنواع أخرى: السياسة الطائفية. في خلال الفترة التي سبقت الحرب الأهلية، حفّز النظام التوافقي أنماط التعبير الطائفية حتى عندما كانت تعمل ضدّ المصالح الطبقية للفئات الاجتماعية الأكثر تهميشاً.108 وفي سنوات ما بعد الحرب، سمحت السيطرة على السياسات المالية والنقدية، التي ترافقت مع الاستيلاء على مؤسّسات الدولة، للنخبة السياسية الطائفية بتكوين اقتصاد سياسي طائفي109 داخل مؤسّسات الدولة وخارجها وفّر «أسس التراضي المادية»110 لقطاعات اجتماعية كبيرة. طالما كان تمويل الاقتصاد السياسي للطائفية ممكناً من خلال تدفّقات رأس المال وتضخيم المديونية العامّة، تمثّل هدفه بالحيلولة دون ظهور أنواع بديلة من السياسة وأشكال تنظيمية معارضة قابلة للتطبيق.
يتكشّف جزء من هذه العملية على مستوى السياسات المالية والنقدية. يصف الجدول الأول الاقتصاد السياسي للإنفاق الحكومي البالغ نحو 195 مليار دولار أميركي في خلال الفترة المُمتدّة بين عامي 1993 و2017. موّلت الحصّة الأكبر من الإنفاق الحكومي، وتقدّر بنحو 71.7 مليار دولار، الأرباح السهلة التي استفادت منها المصارف اللبنانية المكشوفة على الديون السيادية من خلال مدفوعات الفائدة. وتليها مباشرة فاتورة أجور القطاع العام التي بلغت 63 مليار دولار وشكّلت 32.4% من إجمالي الإنفاق الحكومي في هذه الفترة. تشكّل التحويلات المالية إلى مؤسّسة كهرباء لبنان (22 مليار دولار أو 11.3% من مجمل الإنفاق الحكومي) دعما تنازلياً غير مباشر للكهرباء، في حين أن نفقات التشغيل والتحويلات إلى المؤسّسات العامة والخاصة (19.6 مليار دولار أو 10.1%) والنفقات الرأسمالية (15.2 مليار دولار أو 7.8%) تنطوي على مدفوعات تخدم الاقتصاد السياسي للزبائنية والفساد.
إذا عاينا بالتفصيل تركيبة الإنفاق الحكومي على الرواتب والأجور والمعاشات التقاعدية والتعويضات والتقديمات الاجتماعية للموظّفين الدائمين والمؤقّتين، يمكننا بالفعل أن نقدّر مدى الإنفاق الحكومي بعد الحرب على التوظيف الطائفي الزبائني في القطاع العام. يفكّك الجدول الثاني هذه المسألة إمبريقياً.
تمثّل رواتب وأجور موظّفي القطاع العام الدائمين والمؤقّتين – باستثناء أساتذة الجامعة اللبنانية والعاملين فيها وموظّفي البلديات – 90% من مجمل الرواتب والأجور، أي ما يعادل 31.4 مليار دولار أميركي. وفي حين أن رواتب وأجور موظّفي الإدارة العامة لا يتجاوز ثلث هذا المبلغ أي حوالي 10.4 مليار دولار، فإن رواتب العسكريين والأمنيين تمثّل الثلثين أي حوالي 20 مليار دولار. وبتفصيل أكبر، تقدّر وزارة المالية أنه من أصل 10.4 مليار دولار التي تشكّل رواتب وأجور موظّفي الإدارة العامّة، يستحوذ الموظّفون في الهيئات التعليمية على 57% من هذا المبلغ أي نحو 6 مليارات دولار، في مقابل 4.4 مليار دولار لموظّفي الإدارة العامة الدائمين والمؤقّتين والمتعاقدين. الأمر ليس مفاجئاً بالنظر إلى أن التوظيف في الأجهزة الأمنية ونظام التعليم العام شكّل إحدى الآليّات الأساسية التي استخدمتها النخب السياسية في فترة ما بعد الحرب لتغذية الزبائنية وخلق فرص العمل. في الواقع، من بين حوالي 300 ألف موظّف بدوام كامل وجزئي ومتقاعد في القطاع العام في عام 2017، يقدّر عدد أفراد الأمن والجيش بنحو 120 ألف في مقابل 40 ألف موظّف آخرين في النظام التعليمي العام.111 وبحلول العام 2019، نما القطاع العام إلى ما بين 310 آلاف و325 ألف موظف.112
إن عملية تشويه التشكلات البديلة للهوية والتنظيم السياسيين حصل أيضاً على مستوى المجتمع المدني. وقد اتخذ شكل تحييد الحركات العمّالية والجمعيات المهنية كمواقع للتنظيم المعارض113 من أجل تفتيت الطبقات العاملة والمهنية. كما انطوت على استيعاب الجماعات المناهضة للطائفية من أجل السيطرة عليها وترهيبها.114 في المقابل، عملت عناصر من المجتمع المدني - الأحزاب الطائفية، والمدارس، والكشافة، ووسائل الإعلام، والمؤسّسات الاجتماعية - من دون عوائق115 على إعادة إنتاج الهيمنة الطائفية على المستويين الإيديولوجي والتنظيمي بحماية ومباركة مؤسسات التوافقية الديمقراطية. طوال سنوات ما بعد الحرب، وحتى انهيار العام 2019، كانت هناك علاقة دائرية بين كيفية تمكين تقاسم السلطة للنخبة السياسية الطائفية من السيطرة على سياسات الدولة ومواردها، وقدرة هذه النخبة على استخدام الاقتصاد السياسي للطائفية وغيرها من السمات التوافقية لمنع ظهور سياسات بديلة وأشكال تنظيمية معارضة.
خاتمة
بعيداً من كونها استراتيجية محايدة لإدارة النزاعات في مجتمع شديد الانقسام، يمكن للنخبة السياسية أن تستخدم الديمقراطية التوافقية في مراحل حاسمة من تشكيل الدولة من أجل تبرير الاستيلاء على الدولة ومواردها. رصدت هذه الورقة كيف أن بناء صورة مجتمع منقسم إلى جماعات طائفية مُتجانسة في لبنان برّر تبني التوافقية في فترة ما بعد الاستعمار من أجل تمكين النخبة من الاستيلاء على الدولة. وبالمثل، على الرغم من أنها تعكس الحقائق السياسية والاجتماعية-الاقتصادية في فترة ما بعد الحرب، سمح الترتيب التوافقي المُعاد تدويره في اتفاق الطائف للنخبة السياسية والاقتصادية والمالية الجديدة المتداخلة بالاستيلاء على مؤسّسات الدولة ومواردها المالية في فترة ما بعد الحرب.
ساعدت هذه العودة إلى جذور تبنّي نظام تقاسم السلطة أثناء تشكيل الدولة في المرحلة الاستعمارية في مقارنة التجارب التوافقية في الحالات الأوروبية الأصلية وفي سياقات ما بعد الاستعمار. ظهرت الديمقراطية التوافقية في الحالات الأوروبية بعد عملية طويلة من تشكيل الدولة، وتداخلت مع بناء الدولة وخلقت ضغوطاً على المستويات الاجتماعية التنظيمية، والتي ساعدت على الحدّ من الهويات الإثنية والطائفية. على النقيض من ذلك في لبنان، استخدمت نخبة ما بعد الاستعمار ونخبة ما بعد الحرب التوافقية كأداة للاستيلاء على مؤسسات الدولة ومواردها، ومنع بناء الدولة (أو إعادة بنائها) وإنتاج (أو إعادة إنتاج) السياسات الطائفية. وعلى عكس تجارب الدول الأوروبية التوافقية، فمن خلال الاستيلاء على مؤسّسات الدولة واقتصادها السياسي باسم تقاسم السلطة والعيش المشترك أثناء تشكيل الدولة في المرحلة الاستعمارية - أو إعادة بنائها في فترة ما بعد الحرب - جرّدت النخبة السياسية الطائفية الدولة من أي دور في الوساطة بين الطبقات والفئات الاجتماعية، وبالتالي منعت إمكانية اندثار الانقسامات العمودية والترتيبات التوافقية. ويترتّب على هذه الحجة عدد من الآثار النظرية.
على الرغم من كون الهويات الطائفية متخيلة تاريخياً، فهي يعاد إنتاجها من خلال مجموعة من الممارسات المادية والمؤسسية والبيوسياسية، «التي تصقل وتنمّي أشكالاً طائفية من الذاتية»
تتناول دراسة الحالة هذه المناقشات النظرية الجارية المتعلّقة بآفاق إنهاء الطائفية في الشرق الأوسط، أو«التنافس بين الهويات الطائفية وإعادة تخيّل دور الطوائف في الحياة السياسية».116 في لبنان، استخدمت التوافقية كذريعة من أجل استيلاء النخبة في فترة ما بعد الاستعمار (وما بعد الحرب) على الدولة، وتطلّبت فرض صورة مجتمع منقسم في المقام الأول على أساس جماعات طائفية مغلقة. على الرغم من كون الهويات الطائفية متخيلة تاريخياً، فهي يعاد إنتاجها من خلال مجموعة من الممارسات المادية والمؤسسية والبيوسياسية، «التي تصقل وتنمّي أشكالاً طائفية من الذاتية».117 إن التقاسم التوافقي للسلطة هو في قلب هذه المجموعة، وتستخدمه النخبة السياسية والاقتصادية والدينية المتداخلة كسلاح وأحد أشكال الثورة المضادة لمنع إلغاء الطائفية.118 وهذا ما يظهر بوضوح من الطريقة التي استخدمت بها النخبة الاقتصادية والسياسية التوافقية كجزء من الاستراتيجيات التي اتبعت لاحتواء الآثار اللاحقة لاحتجاجات تشرين الأول/أكتوبر 2019. لقد حمت التوافقية هذه النخب والمحسوبين عليها وشركائها داخل مؤسّسات الدولة وخارجها من المحاسبة. ومن خلال تفريغ النقاش السياسي وتقويض المنافسة السياسية باسم السلم والعيش المشترك في فترة ما بعد الحرب، تحوّلت التوافقية إلى «تقاسم سلطة زومبي»،119 تعيق جميع محاولات الإصلاح السياسي والاقتصادي والمالي. لم تتخيل النظرية التوافقية هذا الوضع، لكن الانهيار الحالي متجذّر مع ذلك في الكيفية التي سهّلت التوافقية الاستيلاء على الدولة، وسمحت في وقت لاحق بإعادة إنتاج نوع طائفي من السياسة، وبالتالي تحويل نتائج المرحلة الحاسمة في اللحظة التأسيسية للبلاد إلى إرث دائم. لكن انهيار الاقتصاد السياسي هذا قوبل بمطالب لبناء دولة جديدة ترتكز على مبادئ المواطنة والمحاسبة،120 وهذا ما يؤكد أن هناك دائماً بدائل للهويات الطائفية والتوافقية في السابق والآن، وفي لبنان وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.
تنطوي حجّة هذه الورقة أيضاً على آثارٍ أوسع على نظرية الديمقراطية التوافقية، وتدعو إلى الابتعاد من المواقف الثنائية السائدة التي هيمنت حتى الآن على النقاشات عن فائدة التسويات التوافقية فيما يُسمّى بالأماكن المقسّمة في مراحل ما بعد الحرب. وبدلاً من ذلك، تقترح الدراسة أن تحليل التوافقية من منطلق يأخذ بالاعتبار التغيرات التاريخية في تسلسل تشكيل الدولة واعتماد التوافقية، يساعد على شرح لماذا أثبتت هذه التسويات فعاليتها في بعض السياقات دون غيرها، ولماذا منعت بناء الدولة وإقامتها في بعض السياقات دون غيرها. قارنت هذه الدراسة التسلسل المختلف بين الحالات الأوروبية الأصلية وحالة لبنان في فترة ما بعد الاستعمار لاستكشاف تأثير التوافقية على نوع الدولة ما بعد الكولونيالية والسياسات التي ظهرت في وقت لاحق. هناك حاجة إلى المزيد من البحوث المقارنة لتقدير الآثار الكاملة لاختلاف هذا التسلسل على الأداء التوافقي وأشكال الدول في سياقات ما بعد الاستعمار الأخرى وفي الحالات التوافقية الحديثة خارج الجنوب العالمي. وإلّا فإن الانقسام الحالي بين مؤيد ومعارض للتقاسم التوافقي للسلطة سوف يستمر على حساب الاستكشافات المقارنة التاريخية التي تعزّز إنتاج المعرفة في هذا الموضوع المهم.
أخيراً، فإن نهج إدارة المنعطفات الحاسمة الذي يضفي طابعاً تاريخياً على الدولة في تشكّلها ينزع الطابع الاستثنائي عن مجموعة متنوّعة من أشكال الدولة ما بعد الكولونيالية التي ظهرت في الشرق الأوسط ويدفع بها في حوار مع تجارب أخرى في جنوب العالمي. تحرّرنا هذه الأجندة البحثية من الصورة السائدة عن الدولة والموروثة من النموذج الأوروبي لتشكيل الدولة المرتبطة ارتباطاً وثيقاً بالإمبريالية، وتصحّح مجالات غير منظورة في التنظير التوافقي. والأهم من ذلك أنها تفتح سبلاً جديدة للاستكشافات المقارنة لأصول وموروثات مختلف أشكال الدولة ما بعد الكولونيالية في جميع أنحاء الجنوب العالمي. ولا تقتصر أهمية هذه الأجندة البحثية المقارنة في البحث عن نمط جديد يفسّر طرق العيش والتنظيم السياسي التي غَفِل عنها نمط «الدولة الحديثة».121 الأهم من ذلك، يجب أن تسهم هذه الاجندة في البحث عن حلول نظرية وعملانية لمشاكلنا الاجتماعية والاقتصادية والسياسية العميقة والمشتركة.
- 1Brendan O’Leary, “The Elements of Right-Sizing and Right-Peopling the State,” in Right-Sizing the State: The Politics of Moving Borders, edited by Brendan O’Leary, Ian Lustick, and Tom Callaghy (Oxford: Oxford University Press, 2001), 15–73; Brendan O’Leary, “Power Sharing in Deeply Divided Places,” in Power Sharing in Deeply Divided Places, edited by Joanne McEvoy and Brendan O’Leary (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 1–64.
- 2Arend Lijphart, Democracy in Plural Societies: A Comparative Exploration (New Haven: Yale University Press, 1977); O’Leary, “Power Sharing in Deeply Divided Places”; Allison McCulloch and John McGarry, eds, Power-Sharing: Empirical and Normative Challenges (London: Routledge, 2017).
- 3John McGarry, “Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance,” Swiss Political Science Review 25, no. 4 (2019): 538–55, 548.
- 4يرى مكغاري في لبنان حالة «تنافس طائفي» أو «جماعات عرقية لا تطالب بتقرير مصيرها»: McGarry, “Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance” (549, fn 18).
- 5McGarry, “Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance.”
- 6Andreas Wimmer, “Who Owns the State? Understanding Ethnic Conflict in Post-Colonial Societies,” Nationalism and Nationalism 3, no. 4 (1997): 631–65, 648.
- 7Sebastián Mazzuca, Latecomer State Formation: Political Geography and Capacity Failure in Latin America (New Haven: Yale University Press, 2021); James Mahoney, “Agency and Nation-State Making in Latin American History,” Latin American Research Review 2022 (2022): 1–13. doi:10.1017/lar.2022.81.
- 8Ludger Helms, Marcelo Jenny and David M. Willumsen, “Alpine Troubles: Trajectories of De-Consociationalisation in Austria and Switzerland Compared,” Swiss Political Science Review 25, no. 4 (2019): 381–407; Sean Mueller, “The Politics of Compromise: Institutions and Actors of Power-Sharing in Switzerland,” in Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, edited by Soeren Keil and Allison McCulloch (London: Palgrave Macmillan, 2021), 67–87; Adrian Vatter, Rahel Freiburghaus, and Alexander Arens, “Coming a Long Way: Switzerland’s Transformation from a Majoritarian to a Consensus Democracy (1848–2018),” Democratization 27, no. 6 (2020): 970–89.
- 9Brendan O’Leary, “Consociation in the Present,” Swiss Political Science Review 25, no. 4 (2019): 556–74, 568.
- 10Rudy B. Andeweg, “Consociationalism in the Low Countries: Comparing the Dutch and Belgian Experience,” Swiss Political Science Review 25, no. 4 (2019): 408–425; Mueller, “The Politics of Compromise.”
- 11Andeweg, “Consociationalism in the Low Countries,” 411.
- 12Matthijs Bogaards, “Consociationalism in the Netherlands: Polder Politics and Pillar Talk,” in Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, edited by Soeren Keil and Allison McCulloch (London: Palgrave Macmillan, 2021), 19–42.
- 13Andeweg, “Consociationalism in the Low Countries.”
- 14Mueller, “The Politics of Compromise,” 68.
- 15المرجع نفسه.
- 16Pinar Bilgin and Adam David Morton, “Historicising Representations of ‘Failed States’: Beyond the Cold-War Annexation of the Social Sciences?” Third World Quarterly 23, no. 1 (2002): 55–80, 70.
- 17Mahmood Mamdani, Citizen and Subject: Contemporary Africa and the Legacy of Late Colonialism (Princeton: Princeton University Press, 1996), 12.
- 18Tuong Vu, “Studying the State through State Formation,” World Politics 62, no. 1 (2010): 148–75, 168.
- 19Mahoney, “Agency and Nation-State Making in Latin American History,” 13.
- 20Rogers Brubaker, “Ethnicity without Groups,” Archives européennes de sociologie XLIII, no. 2 (2002): 163–89, 164.
- 21Mahoney, “Agency and Nation-State Making in Latin American History.”
- 22Kathleen Thelen, “Historical Institutionalism in Comparative Politics,” Annual Review of Political Science 2 (1999): 369–404.
- 23Vu, “Studying the State through State Formation.”
- 24Mark Farha, Lebanon: The Rise and Fall of a Secular State under Siege (Cambridge: Cambridge University Press, 2019), 89.
- 25Andreas Wimmer, Nation Building: Why Some Countries Come Together While Others Fall Apart(Princeton: Princeton University Press, 2018), 8.
- 26Wimmer, Nation Building.
- 27Wimmer, “Who Owns the State?”
- 28Wimmer, Nation Building, 52.
- 29المرجع نفسه، ص. 52.
- 30Farha, Lebanon, 46–94.
- 31Michael C. Hudson, The Precarious Republic: Political Modernization in Lebanon. Westview Encore Edition (Boulder: Westview Press, 1985); Max Weiss, In the Shadow of Sectarianism: Law, Shi‘ism, and the Making of Modern Lebanon (Cambridge, MA: Harvard University Press, 2010).
- 32Farha, Lebanon, 92.
- 33Maya Mikdashi, Sextarianism: Sovereignty, Secularism, and the State in Lebanon (Stanford: Stanford University Press, 2022).
- 34عزمي بشارة، «في تواتر الديمقراطية التوافقية وملاءمتها للصراعات الطائفية: نموذجا إيرلندا ولبنان»، سياسات عربية، 30 (2018): 7-23؛ Toby Dodge, “Iraq’s Informal Consociationalism and its Problems,” Studies in Ethnicity and Nationalism 20, no. 2 (2020): 145–52; Caroline Hartzell and Matthew Hoddie, “Power Sharing and the Rule of Law in the Aftermath of Civil War,” International Studies Quarterly 63 (2019): 641–53; John Hulsey and Soeren Keil, “Power-Sharing and Party Politics in the Western Balkans,” in Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, edited by Soeren Keil and Allison McCulloch (London: Palgrave Macmillan, 2021), 115–39; Allison McCulloch, “Introduction: Power-Sharing in Europe: From Adoptability to End-Ability,” in Power-Sharing in Europe: Past Practice, Present Cases, and Future Directions, edited by Soeren Keil and Allison McCulloch (London: Palgrave Macmillan, 2021), 1–18; John Nagle, “Consociationalism Is Dead! Long Live Zombie Power‐Sharing!” Studies in Ethnicity and Nationalism 20, no. 2 (2020): 137–44; Bassel F. Salloukh, “Taif and the Lebanese State: The Political Economy of a Very Sectarian Public Sector,” Nationalism and Ethnic Politics 25, no. 1 (2019): 43–60; Timothy D. Sisk and Christoph Stefes, “Power Sharing as an Interim Step in Peace Building: Lessons from South Africa,” in Sustainable Peace: Power and Democracy After Civil Wars, edited by Philip Roeder and Donald Rothchild (Ithaca: Cornell University Press, 2005), 293–317.
- 35Philip Roeder and Donald Rothchild, “Power Sharing as an Impediment to Peace and Democracy,” in Sustainable Peace: Power and Democracy After Civil Wars, edited by Philip Roeder and Donald Rothchild (Ithaca: Cornell University Press, 2005), 29–50; Bishara, “Fi Tatawur al-Dimuqratiya al-Tawafuqiya wa Mula’amatiha Lihal al-Sira‘at al-Ta’ifiya.”
- 36Florian Bieber, “The Balkans: The Promotion of Power Sharing by Outsiders,” in Power Sharing in Deeply Divided Places, edited by Joanne McEvoy and Brendan O’Leary (Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 2013), 312–26.
- 37Allison McCulloch, “Consociational Settlements in Deeply Divided Societies: The Liberal-Corporate Distinction,” Democratization 21, no. 3 (2014): 501–18, 513.
- 38O’Leary “Power Sharing in Deeply Divided Places,” 6.
- 39المرجع نفسه، ص.6.
- 40O’Leary, “The Elements of Right-Sizing and Right-Peopling the State,” 22.
- 41Joel S. Migdal, Strong Societies and Weak States: State–Society Relations and State Capabilities in the Third World (Princeton: Princeton University Press, 1988); Philipp Lottholz and Nicolas Lemay-Hébert, “Re-Reading Weber, Re-Conceptualizing State-Building: From Neo-Weberian to Post-Weberian Approaches to State, Legitimacy and State-Building,” Cambridge Review of International Affairs 29, no. 4 (2016): 1467–85.
- 42McGarry, “Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance,” 551.
- 43المرجع نفسه.
- 44Toby Dodge, “The Failure of Peacebuilding in Iraq: The Role of Consociationalism and Political Settlements,” Journal of Intervention and Statebuilding 15, no. 4 (2020): 1–17, 13; Toby Dodge, “Iraq, Consociationalism and the Incoherence of the State,” Nationalism and Ethnic Politics (2023).
- 45Azmi Bishara, Sectarianism without Sects (London: C. Hurst & C, 2021); وجيه كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي: من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير (بيروت: منشورات بحصون الثقافية، 1986)؛ Ussama Makdisi, Age of Coexistence: The Ecumenical Frame and the Making of the Modern Arab World(Oakland: University of California Press, 2019); Elizabeth F. Thompson, How the West Stole Democracy from the Arabs: The Arab Congress of 1920, the Destruction of the Syrian State, and the Rise of Anti-Liberal Islamism (New York: Atlantic Monthly Press, 2020).
- 46Albert Hourani, “Lebanon: The Development of a Political Society,” in Politics in Lebanon,edited by Leonard Binder (New York: John Wiley & Sons, Inc., 1966), 13–29, 22.
- 47Iliya F. Harik, Politics and Change in a Traditional Society: Lebanon, 1711–1845 (Princeton: Princeton University Press, 1968), 272; Ussama Makdisi, The Culture of Sectarianism: Community, History, and Violence in Nineteenth-Century Ottoman Lebanon (Berkeley: University of California Press, 2000).
- 48Carol Hakim, The Origins of the Lebanese Idea: 1840–1920 (Berkeley: University of California Press, 2013), 52.
- 49Makdisi, Age of Coexistence.
- 50Hakim, The Origins of the Lebanese Idea; وجيه كوثراني، الاتجاهات الاجتماعية والسياسية في جبل لبنان والمشرق العربي: من المتصرفية العثمانية إلى دولة لبنان الكبير (بيروت: منشورات بحصون الثقافية، 1986)؛ Makdisi, Age of Coexistence.
- 51Hakim, The Origins of the Lebanese Idea, 260.
- 52Brubaker, “Ethnicity without Groups”; Bishara, Sectarianism without Sects.
- 53مهدي عامل، في الدولة الطائفية (بيروت: دار الفرابي، 1988).
- 54Meir Zamir, Lebanon’s Quest: The Road to Statehood 1926–1939 (London: I.B. Tauris, 1997), 245.
- 55المرجع نفسه.
- 56المرجع نفسه.
- 57Makdisi, Age of Coexistence, 131.
- 58Brubaker, “Ethnicity without Groups.”
- 59Zamir, Lebanon’s Quest, 244.
- 60Albert Hourani, The Emergence of the Modern Middle East (Berkeley: University of California Press, 1981), 175.
- 61Hourani, The Emergence of the Modern Middle East, 171.
- 62Michelle Hartman and Alessandro Olsaretti, “‘The First Boat and the First Oar’: Inventions of Lebanon in the Writings of Michel Chiha,” Radical History Review 86 (Spring, 2003): 37–65; Makdisi, Age of Coexistence; فواز طرابلسي، صلات بلا وصل: ميشال شيحا والأيديولوجيا اللبنانية (بيروت: رياض الريس للكتب والنشر، 1999).
- 63ميشال شيحا، لبنان اليوم (بيروت: دار النهار للنشر ومؤسسة شيحا، 1994) 68 و75.
- 64فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 203 و213.
- 65Hartman and Olsaretti, “The First Boat and the First Oar.”
- 66Carolyn L. Gates, The Merchant Republic of Lebanon: Rise of an Open Economy (London: Centre for Lebanese Studies & I.B. Tauris, 1998).
- 67فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 179.
- 68Hartman and Olsaretti, “The First Boat and the First Oar,” 56.
- 69ميشال شيحا، لبنان اليوم، 68.
- 70المرجع نفسه، ص. 73.
- 71فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 201-4.
- 72ميشال شيحا، لبنان اليوم، 20.
- 73فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 210-3.
- 74Farha, Lebanon, 148.
- 75المرجع نفسه، 150؛ فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 24.
- 76Makdisi, Age of Coexistence, 134–13; Meir Zamir, The Formation of Modern Lebanon (Ithaca: Cornell University Press, 1985), 207–9.
- 77فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 201.
- 78شفيق جحا، الدستور اللبناني: تاريخه، تعديلاته، نصه الحالي، 1926-1991 (بيروت: دار العلم للملايين، 1991)، 39.
- 79إدمون رباط، التقويم التاريخي للبنان السياسي والدستوري، المجلّد الثاني، (بيروت: منشورات الجامعة اللبنانية، 2002)، 162.
- 80شفيق جحا، الدستور اللبناني, 95؛ Makdisi, Age of Coexistence, 136–7.
- 81Makdisi, Age of Coexistence, 138; Zamir, The Formation of Modern Lebanon, 212.
- 82رباط، التقويم التاريخي للبنان السياسي والدستوري، 868.
- 83المرجع نفسه، 673.
- 84Weiss, In the Shadow of Sectarianism, 110.
- 85رباط، التقويم التاريخي للبنان السياسي والدستوري.
- 86المرجع نفسه، 181.
- 87المرجع نفسه، 194.
- 88المرجع نفسه، 215.
- 89Rudy B. Andeweg, “Consociational Democracy,” Annual Review of Political Science 3 (2000): 509–36.
- 90جان ملحة، الوزارات اللبنانية وبياناتها: 1943-1994، (بيروت: مكتبة لبنان، 1995)، 17.
- 91Hourani, The Emergence of the Modern Middle East, 171.
- 92Hartman and Olsaretti, “The First Boat and the First Oar.”
- 93فواز طرابلسي، صلات بلا وصل، 191.
- 94المرجع نفسه، 210-3.
- 95نقولا ناصيف، جمهورية فؤاد شهاب، (بيروت: دار النهار، 2008).
- 96Michael C. Hudson, “The Problem of Authoritative Power in Lebanese Politics: Why Consociationalism Failed,” in Lebanon: A History of Conflict and Consensus, edited by Nadim Shehadi and Dana Haffar Mills (London: Centre for Lebanese Studies & I.B. Tauris, 1988), 224–39, 237.
- 97المرجع نفسه، 237.
- 98كمال حمدان، الأزمة اللبنانية: الطوائف، الطبقات الاجتماعية والهوية الوطنية، (بيروت: دار الفرابي، 1998)، 250-2.
- 99Hudson, “The Problem of Authoritative Power in Lebanese Politics.”
- 100Matthijs Bogaards, “Formal and Informal Consociational Institutions: A Comparison of the National Pact and the Taif Agreement in Lebanon,” Nationalism and Ethnic Politics 25, no. 1 (2019): 27–42.
- 101جحا، الدستور اللبناني، 34.
- 102Reinoud Leenders, Spoils of Truce: Corruption and State-building in Postwar Lebanon (New York: Cornell University Press, 2012); Salloukh, “Taif and the Lebanese State”; World Bank, “Lebanon - Promoting Poverty Reduction and Shared Prosperity: Systematic Country Diagnostic,”.
- 103Leenders, Spoils of Truce, 232.
- 104McGarry, “Classical Consociational Theory and Recent Consociational Performance,” 552.
- 105Bassel F. Salloukh, Rabie Barakat, Jinan S. Al-Habbal, Lara W. Khattab, and Shoghig Mikaelian, The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon (London: Pluto Press, 2015).
- 106Ibrahim Halawi and Bassel F. Salloukh, “Pessimism of the Intellect, Optimism of the Will after the 17 October Protests in Lebanon,” Middle East Law and Governance 12, no. 3 (2020): 322–34.
- 107كمال هاني، اليسار اللبناني في زمن التحولات العاصفة: الحزب الشيوعي: تفاقم للأزمة أم انفتاح على التغيير. (بيروت: دار الفرابي، 2015).
- 108كمال حمدان، الأزمة اللبنانية، 136؛ Fawwaz Traboulsi, A History of Modern Lebanon (London: Pluto Press, 2007); فواز طرابلسي، الطبقات الاجتماعية في لبنان: إثبات وجود٫ (بيروت: هينريش بول، 2014).
- 109Hannes Baumann, “Social Protest and the Political Economy of Sectarianism in Lebanon,” Global Discourse 6, no. 4 (2016): 634–49; Salloukh, “Taif and the Lebanese State.”
- 110Adam Przeworski, Capitalism and Social Democracy (Cambridge: Cambridge University Press, 1985), 133–69.
- 111Salloukh, “Taif and the Lebanese State,” 46.
- 112106% من دخل الدولة للرواتب والأجور وخدمة الدين٫ المجلّة الشهرية30٫ كانون الأول/ديسمبر 2019.
- 113Baumann, “Social Protest and the Political Economy of Sectarianism in Lebanon”; Salloukh, The Politics of Sectarianism in Postwar Lebanon.
- 114Janine Clark and Bassel F. Salloukh, “Elite Strategies, Civil Society, and Sectarian Identities in Postwar Lebanon,” International Journal of Middle East Studies 45, no. 4 (November 2013): 731–49; Carmen Geha, “Co-optation, Counter-Narratives, and Repression: Protesting Lebanon’s Sectarian Power-Sharing Regime,” Middle East Journal 73, no. 1 (2019): 9–28.
- 115Melani Cammett, Compassionate Communalism: Welfare and Sectarianism in Lebanon(Ithaca: Cornell University Press, 2014); Roschanack Shaery-Eisenlohr, Shi’ite Lebanon: Transnational Religion and the Making of National Identities (New York: Columbia University Press, 2008).
- 116Simon Mabon, “Four Questions about De-sectarianization,” The Review of Faith & International Affairs 18, no. 1 (2020): 1–11, 3.
- 117John Nagle, “Social Theory: Michel Foucault,” SEPAD Interventions, 2022. https://www.sepad.org.uk/announcement/social-theory-michel-foucault.
- 118Ibrahim Halawi, “Consociational Power‐Sharing in the Arab World as Counter‐Revolution,” Studies in Ethnicity and Nationalism 20, no. 2 (2020): 128–36.
- 119Nagle, “Consociationalism is Dead!”
- 120Charbel Nahas, An Economy and a State for Lebanon (Beirut: Riad El-Rayyes Books, 2020).
- 121Lisa Anderson, “‘Creative Destruction’: States, Identities and Legitimacy in the Arab World,” Philosophy and Social Criticism 40, no. 4–5 (2014): 369–79.